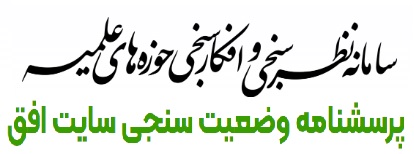مقتطف الجزء الأول
تفسير القران الكريم على ضوء السنن الاجتماعية
آیة الله جعفر السبحاني
إنّ النظرة الفاحصة في التفاسير التي ألّفت قبل القرن الرابع عشر يعرب عن أنّ الطابعَ العام لها هو تفسير الآيات القرآنية، وتبيين مفرداتها، وتوضيح جملها، وكشف مفاهيمها بمعزل عن المجتمع ومسائله ومشاكله، من دون أن يستنطقوا القرآن من أجل وضع الحلول المناسبة لمعاناتهم مع أنّ الواجب على المسلمين الرجوع إلى القرآن لمعالجة دائهم، كما يقول الإمام علي (ع): «ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أُخبركم عنه: ألا إنّ فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم».
فإذا كان هذا موقف القرآن الكريم، فالحقّ انّ القدامى لم يولوا العناية بهذا الجانب من التفسير إلاّ شيئاً يسيراً، وأوّل من فتح هذا الباب على مصراعيه هو السيد جمال الدين الأسد آبادي، فقد وجه أنظار المسلمين إلى الجانب الاجتماعي من التفسير، فقال في خطبته المعروفة: "عليكم بذكر اللّه الأعظم، وبرهانه الأقوم، فانّه نوره المشرق، الذي به يخرج من ظلمات الهواجس، ويتخلّص من عتمة الوسواس، وهو مصباح النجاة، من اهتدى بها نجا، ومن تخلّف عنه هلك، وهو صراط اللّه القويم، من سلكه هُدي، ومن أهمله غوى".
وتبعه تلميذه ومن تربى في أحضانه، الإمام الشيخ محمد عبده، فأبدع منهجاً خاصاً للتفسير له ميزاته التالية:
1. التحرر من قيود التقليد وإعمال العقل في الأقوال والآراء المروية في الآيات، وفهم كتاب اللّه من دون نظر إلى مذهب إمام دون إمام على وجه يكون القرآن هو المتبع دون مذهب الإمام.
2. الاهتمام ببيان نظم الاجتماع ومشاكل الأُمّة الإسلامية خاصة، ومشاكل الأُمم عامة، وبيان علاجها بما أرشد إليه القرآن من أُصول وتعاليم.
3. التوفيق بين القرآن والنظريات العلمية على وجه لا يكون القرآن مخالفاً للعلم.
فلنأت لكلّ ميزة بمثال.
أمّا الميزة الأُولى فيكفي الامهال فيما ذكره حول آية الوصية للوالدين.
الوصية للوالدين ليست منسوخة:
يقول سبحانه: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصيةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلى الْمُتَّقين).
قال الشيخ الطوسي: تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا وصية للوارث.
وقال صاحب المنار: الآية صريحة في جواز الوصية للوالدين ولا وارث أقرب للإنسان من والديه، وقد خصّهما بالذكر لأولويتهما بالوصية ثمّ عمّم الموضوع وقال: «والأقربين» ليعم كلّ قريب وارثاً كان أم لا، غير انّ جمهور الفقهاء من أهل السنّة رفضوا الآية وقالوا بأنّ الآية منسوخة بآية المواريث، ولكنّ الإمام عبده خالف رأي الجمهور وقال: لا دليل على أنّ آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هنا، فانّ السياق ينافي النسخ، فانّ اللّه تعالى إذا شرع للناس حكماً وعلم انّه مؤقت وانّه سينسخه بعد زمن قريب فانّه لا يؤكّده ولا يوثّقه بمثل ما أكّد به أمر الوصية هنا من كونه حقّاً على المتّقين ومن وعيد لمن بدله.
وهذا دليل على أنّ الإمام نظر إلى الآية بعقلية حرة من دون أن يتبع رأي الأئمّة الأربعة وبذلك وجه لوم المتحجرين إلى نفسه كما هو شأن كلّ مصلح.
وأمّا الميزة الثانية فالحقّ انّ تفسير الإمام مشحونة بهذه المباحث ولا يمكن لنا عرض معشار ما جاء في ذلك الكتاب من هذا النوع من المسائل، ولنقتصر بالمورد التالي:
الصبر وأثره البنّاء:
يقول الإمام في تفسير قوله سبحانه: (وَتَواصَوا بِالصَّبْر) والصبر ملكة في النفس يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله، والرضى بما يكره في سبيل الحقّ، وهو خلق يتعلّق به بل يتوقّف عليه كمال كلّ خُلق، و ما أُوتي الناس من شيء مثل ما أُتوا من فقد الصبر أو ضعفه، كلّ أُمّة ضعف الصبر في نفوس أفرادها، ضعف فيها كلّ شيء، وذهبت منها كلّ قوة، ولنضرب لذلك مثلاً: نقص العلم عند أُمّة من الأُمم كالمسلمين اليوم، إذا دقّقت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر، فإنّ من عرف باباً من أبواب العلم، لا يجد في نفسه صبراً على التوسع فيه، والتعب في تحقيق مسائله، وينام على فراش من التقليد هين لين، لا يكلفه مشقة، ولا يجشمه تعباً، ويسلّي نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه، ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه، لاتّخذهم أُسوة له في عمله، فحذا حذوهم، وسلك مسلكهم، وكلّف نفسه بعض ما حمّلوا أنفسهم عليه واعتقد كما كانوا يعتقدون انّهم ليسوا بمعصومين.
وكم للأُستاذ بيانات شافية حول المحرمات كالقمار والزنا، وحول الجهاد وتحريم الربا إلى غير ذلك من الأُسس الاجتماعية في الإسلام.
وأمّا الميزة الثالثة فنقتصر بالمورد التالي:
انشقاق السماء عند اختلال نظامها:
يذكر في تفسير قوله سبحانه: (إِذا السماء انشقت) انشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر تفسيره في سورة (اذا السماء انفطرت) وهو فساد تركيبها واختلال نظامها عندما يريد اللّه خراب هذا العالم الذي نحن فيه، وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم، كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره، ويحدث من ذلك غمام وأي غمام، يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع، فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره.
وهذه الأمثلة نقلناها من تفسيره المعروف لجزء عمّ، ذلك التفسير الذي ألفه بقلمه بمشورة من بعض أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية ليكون مرجعاً لأساتذة مدارس الجمعية في تفهيم التلاميذ معاني ما يحفظونه من سور هذا الجزء، وعاملاً للإصلاح في أعمالهم وأخلاقهم، وقد أتمّ الاستاذ تفسير هذا الجزء سنة 1321 هو ببلاد المغرب.
وأمّا الدروس التي ألقاها الإمام فقد ابتدأ بأوّل القرآن في غرة محرم سنة 1317 هـ، وانتهى عند تفسير قوله تعالى: (وللّهِ ما فِي السَّماواتِ وََما فِي الأَرضِ وَكانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْء مُحِيطاً) في منتصف محرم سنة 1321هـ، إذ توفّي ـ رحمه الله ـ لثمان خلون من جمادى الأُولى من السنة نفسها. وقد أملى الأُستاذ هذه الدروس على تلاميذه.
ومع الأسف انّ ما أملاه الإمام لم ينشر على وفق ما أملاه بلا تصرف بزيادة أو نقيصة، فانّ تلميذه السيد محمد رشيد رضا لمّا كتب تفسيره المسمّى بتفسير «المنار» أدخل فيه ما كتبه عن أُستاذه من آراء وأقوال ومزجها بآرائه وأفكاره، ولذلك لا يمكن أن ينسب كلّ ما فيه إلى الإمام إلاّ إذا صرح الكاتب به.
وعلى كلّ حال فقد ابتدأ التلميذ بأوّل القرآن وانتهى عند قوله تعالى من سورة يوسف ( رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِنْ تَأْويلِ الأَحاديثِ فاطِرَ السَّمواتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصّالِحينَ). ثمّ وافته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن.
تتبع
المصدر: المناهج التفسيرية في علوم القرآن، ج 1، ص 101-105
برچسب ها :
ارسال دیدگاه