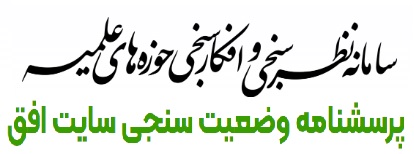مقالة
إعتزالية الشريف المرتضى بين الوهم والحقيقة
الدكتور رؤوف الشمري
الجزء الأول
ملخّص
نسب إلى الشريف المرتضى الاعتزال، والباحث بعد أن يلقي الضوء على شخصية الشريف، يبين أصول مذهبه، وأصول مذهب المعتزلة، ويناقش قضية التبست كثيرا على العلماء ترتبط بالصلة بين التشيع والاعتزال، ويناقش آراء القائلين باعتزالية الشريف المرتضى، ويرفضها بعد أن يورد آراء الشريف في شيوخ المعتزلة.
هذه الدراسة تتناول موضوعاً مهما أردنا من ورائه كشف الحقيقة التي طالما التبس فهمها على القدامى واقتفى أثرهم - نتيجة عدم التدقيق والتمحيص - المحدثون في هذا الفن من المعارف الإسلامية.
نعم، لقد نسب إلى الشريف المرتضى الاعتزال… وكان من وراء هذه النسبة بادئ أمرها ابن حزم، ثم اقتفى أثره آخرون.
وإذا كان المعروف لدى الجميع حديث الرسول(ص): "البينة على من ادعى" فإن هؤلاء لم يأتوا ببينة واحدة تؤيد مدعاهم، لقد استندوا في ذلك إلی دراسة الشريف المرتضى على يد بعض علماء المعتزلة، كالقاضي عبد الجبار، لكنه فاتهم أنه قد هاجم آراء استاذه هذا، من خلال كتابه "الشافي في الإمامة" رداً على كتاب "المغني في الإمامة" للقاضي عبد الجبار. كذلك فاتهم أن كثيراً من مفكري مذهب ما قد درسوا على يد كبار علماء مذهب آخر، ولا ضير في ذلك. فهذا الشيخ المفيد أستاذ الشريف المرتضى، درس على يد عليّ بن عيسى الرماني وأبي عبد اللّه الحسين بن علي البصري. أقول: بالرغم من دراسة الشيخ المفيد على يد هذين العلمين من أعلام المعتزلة، إلا أنه لم يوافقهما في كل ما يروه، ولكن لا أدري لِمَ أجد من يتهمه بالاعتزال؟!
وحيث اتضح الهدف من هذه الدراسة، فإني استندت في إيضاح الحقائق ودفع الشبهة إلی آراء هذا الرجل، حسبما هي ومن مؤلفاته مباشرة، ومن هو القائل: "الآراء يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها، أو ممن هو مأمون في الحكاية عنهم".
من هو الشريف المرتضى؟
هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر (ع). يكنى بأبي القاسم، ويلقب بالمرتضى، وعلم الهدى، وذي المجدين، والسيد، والشريف. ولد سنة ٣٥٥هـ.
من أساتذته: الشيخ المفيد، وأبو عبد اللّه المرزباني، وعبد العزيز بن نباته السعدي، وعلي بن عيسى الرماني.
له مؤلفات كثيرة، تناولت شتى فروع المعرفة الإسلامية، منها في الفقه كالانتصار والناصريات، ومنها في أصول الفقه، كالذريعة، ومنها في الكلام، كالشافي في الإمامة، وتنزيه الأنبياء، وإنقاذ البشر من الجير والقدر، ومنها في الأدب، كالأمالي، وطيف الخيال، وديوان الشريف المرتضى. والظاهر أن المستأثر بجهده في الغالب هو الفقه فالكلام فالأدب فالأصول فالتفسير. ويبدو أن السبب في تركيز جهده على الفقه والكلام بصورة خاصة هو الخلافات المذهبية - الفقهية والعقائدية - القائمة آنذاك بين المذاهب الفقهية المشهورة فيما بينها كالإمامية والحنفية، والفرق العقائدية: كالإمامية والأشعرية والمعتزلة وغيرها، مما يتطلب من الشريف المرتضى الإفصاح عن رأيه في حكم مسألة شرعية معينة - بعد التثبت والاحتياط - أو وجهة نظر في مسألة عقائدية ما بعد التأمل وسبر الآراء.
توفي الشريف المرتضى لخمس بقين من ربيع الأول سنة ٤٣٦هـ، بعد أن أسدى إلی الحركة العلمية في عصره خدمات جلى من خلال مؤلفاته التي تدل الباحث على خصب قريحة هذا المفكر المبدع وإلهامه لشتى فروع العلم والمعرفة.
أصول مذهبه
يتفق الشريف المرتضى مع بقية المسلمين - على اختلاف فرقهم العقائدية ومذاهبهم الفقهية - على أن هناك أصولاً ثلاثة يعد منكر كل واحد منها كافراً بإجماع المسلمين. وهذه الأصول هي التوحيد، النبوة، المعاد.
ومضافاً لهذه الأصول الثلاثة الآنفة الذكر، فإن هناك أصولا أخرى انفردت بها كل من الإمامية والمعتزلة، إذ جعل الإمامية أصلي "العدل والإمامة" من أصول مذهبهم، وأن منكرهما يعد فاسد المذهب، في حين جعل المعتزلة أصول "العدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد" من أصول مذهبهم، كما قال أبو الحسين الخياط: "وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولكي نتجنب الإطناب في هذا الموضوع، علينا بيان أصول مذهب الشريف المرتضى - والتي هي عين ما عليه الشيعة الإمامية كما سيتضح - وهي العدل والإمامة - باعتبار أن لا داعي لاستعراض رأيه في الأصول المتفق عليها بين المسلمين، ثم نتحدث عن الأصول التي انفردت بها المعتزلة لنرى بعد ذلك أين يكون الشريف المرتضى عن هؤلاء أم أولئك.
وحيث أن العدل قد انفرد به كلاهما - الإمامية والمعتزلة معاً - لذا فمن المستحسن ذكر آرائهما فيه معا، مع بيان نقاط الخلاف بينهما في مسائله.
أولاً: العدل عند المعتزلة والإمامية
أ - عند المعتزلة: اختلف المعتزلة فيما بينهم حول تحديد المعنى الاصطلاحي للعدل على قولين:
الأول: هو كل فعل حسن. وهو رأي أبي علي الجبائي.
الثاني: وهو أن العدل من أوصاف الفعل، والفعل والعدل هو كل ما يفعله الفاعل بغيره باقتضاء الحكمة من شأنه أن يتضرر به الغير أو ينتفع به، وهذا ما يراه القاضي عبد الجبار، الذي رفض رأي أبي علي الجبائي السابق.
ب - عند الإمامية: أما عند الإمامية، فقد عرفوه بقولهم: "الواجب تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب"، وهذا المعنى بعينه موجود في كلام الشريف المرتضى حيث أشار إلی الشق الأول بقوله: "ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولأنه غني… وهو تعالى لا يفعل شيئاً من القبائح، تعالى عن ذلك".
وعدم إشارته إلی الشق الثاني من التعريف المتقدم لا يقتضي اختلافه معه، لأن مفاد الشق الثاني مفهوم من الأول، فإن ترك الواجب على حد فعل القبيح في القبح. ومن هنا كان ذكر الشق الثاني مستدركاً في التعريف لضرورة أن يكون أسد وأخصر، وقد ذهب مشاهير متكلمي الإمامية إلى ما ذهب إليه الشريف المرتضى.
ثانياً - الإرادة الإنسانية: موضوع الإرادة الإنسانية مختلف فيه بين الطرفين: فالمعتزلة ترى أن العباد خالقون لأفعالهم مخترعون لها، وأن الله تعالى ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير ولا بإيجاب ولا نفي. في حين قالت الإمامية بفكرة "الأمر بين الأمرين" المروية عن الإمام الصادق (ع) (جعفر بن محمد). والملاحظ أن الشريف المرتضى اعتنق هذه الفكرة في جميع مؤلفاته من خلال استدلاله بأدلة نقلية منها: ما قاله الإمام علي (ع) للرجل الشامي حين سأله عن القضاء والقدر: "إن اللّه أمر عباده تحذيراً، ونهاهم تخييراً، وكلفهم يسيراً". وما قاله الإمام الصادق(ع): "لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين".
ثالثاً - الإمامة: يشير متكلمو الإمامية - ممن سبقوا الشريف المرتضى - إلى أن الإمامة منصب ديني، الهدف منه اتباع الإمام على سبيل الولاء والإقتداء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول(ص)، وهذا مايراه الشريف المرتضى أيضاً، فهو يعرف الإمامة بأنها: "الولاية العامة على جميع أمور المسلمين"، "هي أعلى منازل الدين بعد النبوة".
أما رأي المعتزلة - البصريين والبغداديين - فيشير إلى أن مهمة الإمام مهمة دنيوية فقط، باعتبار أن الإمام - كما يقول أبو هاشم - يُنصَّب لمصالح الدنيا لا الدين، فما يأتيه الإمام ويقوم به - كما يقول - من مصالح الدنيا، لأنه ليس فيها إلا اجتلاب نفع أو دفع ضرر عاجل، وهذا ما أكده القاضي عبد الجبار، في حين أن الشريف المرتضى يرفض كل ما أفاده المعتزلة جملة وتفصيلاً، إذ يرى أن الحاجة إلی الإمام تختص في اجتلاب المنافع ودفع المضار المتعلقة بأمور الدين واللطف في فعل الواجبات والإقلاع عن المقبحات.
وبذلك يتبين لنا أن وجوب الإمامة عند الإمامية ليس للمصالح الدنيوية، بل للمصالح الدينية التي هي الهدف الرئيسي من نصب الإمام. وبذلك فالإمامية - كما قال الشيخ الطوسي - يقولون أنها واجبة من هذا الوجه لا من الوجه الأول.
ولدى التأمل نجد أنه لا ضير في أن تكون مهمة الإمام دنيوية طالما فهمنا أن الهدف من الإمامة هو قيادة المجتمع الإسلامي وإدارته المستقاة من قيادة النبي الأكرم(ص) للأمة.
رابعا - الفرق بين الإمام والخليفة: يتفق متكلمو الإمامية - ممن سبقوا الشريف المرتضى، وكذلك المتأخرون عنه، على وجود فرق بين الإمام والخليفة. وهذا ما عليه الشريف المرتضى أيضا الذي استند فيه إلی عدة حجج عقلية منها:
١ - أن الإمامة هي: الولاية العامة على جميع أمور المسلمين فهي: الولاية المخصوصة على أمور المسلمين.
٢ - لفظ الخليفة في العرف: من قام مقام المستخلف في جميع ما كان إليه، وإنما يختص الاستخلاف في بعض الأصول بإضافات تدخل على الكلام.
أما المعتزلة فترى عدم وجود فرق بين الإمام والخليفة، وأن كليهما يشير إلی شخص واحد. وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: "لم يرووا عن الصحابة ذكر الإمام، وإنما كانوا يذكرون الأمير والخليفة"….
وبذلك يتبين عدم خروج الشريف المرتضى عما عليه متكلمو الإمامية بصدد هذا الموضوع، باعتبار أنهم (الإمامية) يرون أن كل خليفة ليس إماما ولكن كل إمام يصلح أن يكون خليفة.
خامساً - طريق وجوب الإمامة: يتفق الشيعة ومعتزلة بغداد وأبو الحسين البصري من معتزلة البصرة على وجوب الإمامة عقلا، إلاّ أنهم انقسموا في هذا الوجوب إلی طريقين:
الأول: يرى أن الإمامة واجبة عقلا على الله من حيث كان لطفا، وهذا ما عليه الإمامية، والإسماعيلية.
الثاني: يرى أن الإمامة واجبة على المكلفين من حيث كان في الرئاسة مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية.
وإذا ما أردنا معرفة رأي الشريف المرتضى في وجه الوجوب علينا التأمل في النص الآتي فهو ينبئك عن رأيه: "الإمامة واجبة على الله"، من باب اللطف، "الإمامة لطف في الدين، والدليل هو أننا وجدنا الناس متى خَلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في تدبيرهم وسياستهم اضطربت أحوالهم وتكدرت معيشتهم وفشا فيهم فعل القبيح، فقد ثبت أن وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذهب اليه".
ومن هذا النص يتضح لنا موقفه الذي لم يتخل فيه عن منهج الإمامية، فهو يصرح بالوجوب على الله تعالى من باب العقل استناداً للدليل الذي صرح به آنفا، فهو يشير إلى أن الإمام لطف في وجوده، ومحال إذا كان لطفاً يكون حال المكلفين في وجوده كحالهم مع فقده في القيام بما كلفوا به من العبادات والأمور الأخرى التي أشار اليها.
وحيث أننا بيّنا فيما تقدم موقفه من وجه وجوب الإمامة، فإن هناك مسائل تتعلق بمسألة وجوب الإمامة، أثارها رأس الاعتزال في زمانه القاضي عبد الجبار، والتي رد عليها الشريف المرتضى، رداً يشعر بعدم وجود شك في أنه إمامي المذهب في الأصول.
ويستطيع القارئ الكريم أن يتبين من ردود الشريف المرتضى على ما ادعاه القاضي عبد الجبار أن الشريف المرتضى قد أراد بيان رأي الإمامية القائل بأن قول القاضي عبدالجبار "أن من مصلحة الإمام إمام ثان" يدخل ضمن الدور أو التسلسل وهو باطل بالإجماع عند الامامية.
سادساً - طريق إثبات الإمامة: المعروف لدى الجميع أن فرق المسلمين لم تتفق على طريق واحد لإثبات الإمامة، وبقدر تعلق الأمر بالمعتزلة والإمامية نشير إلى رأيهم في ذلك. فالمعتزلة يرون أن طريق إثبات الإمامة هو الاختيار، في حين يرى الإمامية أن طريق إثباتها هو النص. بل ذهب الإمامية إلى أبعد من ذلك، فقالوا بتخصيص النص بالاسم.
والشريف المرتضى هنا إمامي في رأيه أيضاً، إذ يصرح بمبدأ النص، مستدلاً عليه بأدلة نقلية وعقلية، لايسع المجال لذكرها من جهة، كما أن غرضنا من البحث هو بيان اتجاه الشريف المرتضى نحو هؤلاء أم أولئك.
سابعاً - صفات الإمام:
١ - عند المعتزلة: شروط الإمام عندهم هي كما يذكرها القاضي عبد الجبار، وهي:
أ - التمكن بما فوض إليه.
ب - أن يكون عالماً، أو في حكم العالم.
جـ - أن يكون متصفاً بالإمامة.
د - أن يكون مقدما في الفضل.
هـ - أن يكون قرشي النسب.
٢ - عند الإمامية: إذا أردنا أن نطلع على رأي الإمامية في هذا الموضوع، فمن المستحسن أن نستقيه من أقرب الشخصيات زماناً ومكاناً وتأثراً بالشريف المرتضى، ألا وهو الشيخ الطوسي، فهو يقول: "الصفات على ضربين. أحدهما: يجب أن يكون الإمام عليها من حيث كان إماماً: مثل كونه معصوماً، أفضل الخلق. والثاني: يجب أن يكون عليها لشيء يرجع إلی ما يتولاه: مثل كونه عالماً بالسياسة وبجميع أحكام الشريعة، وكونه حجة فيها، وكونه أشجع الخلق، وجميع هذه الصفات توجب كونه منصوصاً عليه.
نستنتج مما تقدم أن هناك خلافا واضحاً في شروط الإمام عند الطرفين: فالإمامية انفردوا بالقول بضرورة توفر صفة العصمة خصوصاً، وكونه أفضل الخلق مطلقاً، وكونه أشجعهم وأعلمهم، بالإضافة إلی اشتراط قرشية النسب التي وافقهم بها بعض المعتزلة ومنهم الجبائيان.
والآن لنر رأي الشريف المرتضى، هل أنه اشترط ما تقدم ذكره من قبل الإمامة أم لا؟ نعم، لقد اشترط الشريف المرتضى كل ما أفاده الإمامية آنفاً، فهو يرى أن صفة العصمة لابد منها في الإمام حين أشار إلی أنه: "لابد من وجود مزية ثابتة بين الإمام ورعيته في باب الطاعة والأخذ على اليد… فالمعلوم أن المزية لو ارتفعت لكان فساداً مستحيلاً لا يخفى على عاقل بطلانه".
وفي معرض ذكره لصفة الأفضلية، يؤكد الشريف المرتضى ما عليه سابقوه من الإمامية في هذا الأمر، إذ يرى أنه "لابد أن يكون الإمام أفضل من رعيته لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه".
ويرى الشريف المرتضى ضرورة كون الإمام أعلم الناس بجميع الأحكام، باعتبار أن الإمام إمام في سائر الدين ومتول للحكم في جميعه: "جليلة ودقيقة".
أما بالنسبة لاشتراطه قرشية النسب في الإمام فقد أكد ما عليه سابقوه من الإمامية في أنها: "منحصرة في بني هاشم، في علي وولده(ع)" في حين أن بعض المعتزلة على الرغم من اشتراطهم النسب القرشي، إلا أنهم مع ذلك لا يخصصونها في بيت من البيوت.
تتابع
المصدر: رسالة التقریب، العدد 25
برچسب ها :
ارسال دیدگاه