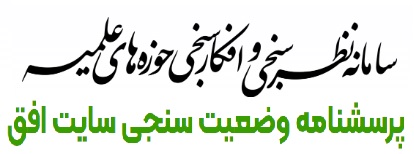ملاحظة
"الأميّة في القرآن بين الدلالة التاريخية والرسالية"
يُعدّ القرآن الكريم المصدر الأسمى للمعرفة الإلهية، إذ حمل في ثناياه مفاهيم دقيقة ترتبط برسالة النبي محمد(ص) وشخصيته، ومن أبرز هذه المفاهيم وصفه بـ «النبي الأمي»، وهذا اللقب لم يكن مجرد إشارة عابرة، بل انطوى على دلالات معرفية وتاريخية وعقائدية عميقة، أثارت جدلاً واسعًا بين المفسّرين والباحثين قديمًا وحديثًا، فالأمية هنا لا تعني الجهل، بل تكشف عن بُعد إعجازي في الرسالة، إذ إنّ من لم يتعلّم على أيدي البشر جاء بكتاب أعجز الإنس والجن، ومن هذا المنطلق ينفتح الموضوع على دراسة علمية دقيقة لهذا المفهوم.
ورد وصف النبي الأكرم محمد(ص) في القرآن الكريم بلقب «النبي الأمي» في أكثر من موضع، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ﴾ (الأعراف: 157)، وقوله سبحانه: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ﴾ (الأعراف: 158). وقد أثار هذا الوصف جدلاً واسعاً بين المفسرين والباحثين منذ صدر الإسلام وحتى اليوم، لأن الأمية تبدو لأول وهلة وصفاً يوحي بالحرمان من المعرفة، بينما شخصية النبي(ص) تمثل قمة المعرفة والوحي والعلم.
ومن هنا برز السؤال: ما المقصود من «الأمي»؟
وهل هو بمعنى الذي لا يعرف القراءة والكتابة، كما ذهب إليه جمهور المفسرين؟
أم أنه يحمل دلالات أخرى مرتبطة بالسياق التاريخي والحضاري والديني للأمة التي بُعث منها النبي؟
المعنى اللغوي للأمية يرتبط في أصله بكلمة «الأم»، أي الحالة الأولى التي يولد عليها الإنسان قبل أن يكتسب مهارة القراءة والكتابة، ومن هنا شاع أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. غير أنّ القرآن الكريم استخدم الكلمة في مواضع أخرى بمعنى مختلف، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ﴾ (آل عمران: 20)، حيث أُريد بالأميين العرب الذين لم يكونوا من أهل الكتاب. وهذا الاستعمال يفتح المجال لتوسيع الفهم بحيث يشمل المعنيين معاً: الأمية بمعنى عدم التعلم بالكتابة، والأمية بمعنى الانتماء إلى أمة لم يكن لها كتاب سماوي. وهنا تتضح طبيعة الغنى الدلالي للفظ القرآني.
وعند النظر إلى آراء العلماء المتأخرين من مدرسة أهل البيت(ع)، نجد أن السيد أبو القاسم الخوئي قد تناول هذه القضية في إطار تفسيره، فرأى أن أمية النبي(ص) بالمعنى الشائع، أي عدم معرفته بالقراءة والكتابة، هي بحد ذاتها معجزة واضحة، لأنها تنفي أي احتمال أن يكون القرآن نتاج تعلم بشري. فصدور كتاب بليغ معجز، يتحدى البلغاء ويضع أسس التشريع، من رجل لم يدخل مدرسة ولم يقرأ كتاباً، يعد برهاناً قاطعاً على أن هذا الكتاب وحي إلهي، ومع ذلك لا يغفل الخوئي المعنى القرآني الآخر، وهو أنّ «الأميين» هم غير أهل الكتاب، ما يعني أن النبي(ص) أُرسل من أمة لم تكن متوارثة لكتاب سماوي، ليؤكد أصالة الرسالة وعدم اتصالها بتراث كتابي سابق، فالجمع بين المعنيين يعطي الصورة الكاملة للمفهوم القرآني.
وأما السيد محمد باقر الصدر فقد نظر إلى القضية من زاوية حضارية وفكرية أوسع، فهو يرى أن وصف الأمية لا ينبغي أن يُفهم مجرد وصف تقني يقتصر على عدم تعلم النبي(ص) للكتابة، بل هو عنوان لمرحلة حضارية كاملة. فقد شاء الله تعالى أن يبعث نبيه من أمة وبيئة أمية بالمعنى الثقافي العام، أمة لم تترك أثراً كتابياً ولم تعرف تقاليد التدوين والعلوم، لتكون الرسالة الخاتمة نقلة نوعية كبرى تنقل المجتمع من حالة الفراغ إلى بناء حضارة علمية وفكرية عظيمة. ومن هنا فإن الأمية ليست نقصاً بل قوة، لأنها تبرز قدرة الرسالة على صناعة الحضارة من العدم، وتؤكد أن هذا الوحي مستقل عن أي تراكم فكري سابق. كما يشير الصدر إلى أن النبي لو كان متعلماً على يد مدارس أو مطلعاً على كتب، لكان من الممكن أن يُقال إن القرآن مستقى من تلك المعارف، لكن الله أراد أن تكون الأمية حجة قاطعة على أصالة الوحي واستقلاله، بحيث لا يُرد إلى أي مصدر بشري أو ثقافي.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤرخين ذكروا روايات تفيد بأن النبي(ص) ربما عرف شيئاً من الكتابة في أواخر حياته، خصوصاً في سياق تعامله مع الرسائل والعقود السياسية، ومن ذلك ما ورد عند محاولة كتابة كتاب يوم الخميس قبيل وفاته كما جاء في بعض النصوص الروائية. إلا أن هذه الروايات لا تنقض أصل الدلالة، لأن العبرة ليست بحدود تقنية ضيقة، بل بالمشهد العام الذي يظهر النبي غير متأثر بأي مصدر بشري مكتوب. وقد تعامل السيد الخوئي مع هذه الإشكالية باحتياط، فرأى أن معرفة جزئية لا تعني انتفاء الأمية بمفهومها الأصلي، بينما ركز السيد الصدر على أن القضية أكبر من ذلك، إذ أن جوهر المسألة هو الإعجاز الحضاري والتاريخي، لا التفاصيل الجزئية.
ومن هذا المنطلق، يمكن إعادة قراءة مفهوم النبي الأمي في ضوء حاجات الفكر المعاصر وفق مستويات متعددة. على المستوى الإعجازي، فإن الأمية تثبت أن القرآن معجزة إلهية، لأنه لا يمكن لعقل بشري غير متعلم أن يأتي بمثل هذا الكتاب، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (العنكبوت: 48).
وعلى المستوى الحضاري، فإن الأمية تعني الانطلاق من واقع ثقافي بسيط لبناء حضارة معرفية رائدة، وهو درس في أن التغيير الحضاري لا يتوقف على امتلاك تراكم سابق، بل على مشروع رسالي أصيل. وعلى المستوى الرسالي، فإن الأمية تمثل ضمانة لاستقلال الوحي عن أي مؤثر خارجي، فتؤكد أن ما جاء به النبي(ص) هو من عند الله خالصاً، أما على المستوى التربوي، فهي تحمل رسالة بأن المعرفة الحقيقية ليست رهينة القراءة والكتابة بقدر ما هي رهينة الارتباط بالله ونور الوحي.
وعند المقارنة بين الرؤيتين، يمكن القول إن السيد الخوئي ركز على البعد الإعجازي الفردي، أي أن النبي الأمي الذي لم يتعلم جاء بمعجزة كبرى هي القرآن، فيما ركز السيد الصدر على البعد الحضاري الرسالي، أي أن الأمة الأمية استطاعت أن تنهض بالوحي إلى مستوى قيادة البشرية. كلا الرؤيتين متكاملتان، لأنهما تبرزان أبعاداً متعددة للحقيقة نفسها: فالأمية دليل على صدق النبوة، وهي في الوقت نفسه قاعدة لانطلاقة حضارية كبرى.
وإنّ الوصف القرآني «النبي الأمي» ليس مجرد ملاحظة تاريخية عابرة، بل هو مفتاح لفهم طبيعة الرسالة الإسلامية الخاتمة. فهو من جهة برهان إعجازي على صدق النبوة، ومن جهة أخرى أساس لنظرية حضارية كبرى، تبرز كيف يمكن للوحي أن ينقل أمة من الجهل والفراغ الثقافي إلى الريادة العلمية والفكرية، وإذا كان العالم الحديث يربط الأمية بالجهل، فإن القرآن قلب هذا المفهوم ليجعله عنواناً للإعجاز، بحيث تصبح الأمية في حياة النبي(ص) ليست حرماناً من العلم، بل طريقاً لظهور أرقى أشكال العلم الرباني، وهنا يظهر عمق المفهوم القرآني الذي لا يقف عند حدود المعنى اللغوي، بل يتسع ليستوعب البعد التاريخي والرسالي والحضاري في آن واحد.
د.ش حسين التميمي
برچسب ها :
ارسال دیدگاه







2222.jpg)