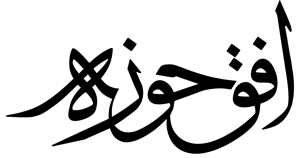

□ مقالة/ الجزء الثانی والأخیر
الحوار القرآني عند الإمام الحسين(ع) دراسة تحليلية
▪ المبحث الثاني: حواره(ع) القرآني في إثبات الخلافة الشرعيّة
كان تأكيد الإمام الحسين(ع) على العمل بمضمون محكم القرآن الكريم في اتّباع الخليفة الشرعي، وهو المستخلف بأمر الله تعالى وحكمته؛ لأجل إنفاذ مشيئته سبحانه في عالم التكوين الدنيوي وتحقيق إرادته في خلقه، وأنّ اختيار بيعة الناس لخلفاء الله (جلّ وعلا) والامتثال لأحكامهم هو سرُّ سعادتهم وصلاح حالهم في الدنيا والآخرة.
لقد استند الإمام الحسين(ع) في حواره مع الأُمّة الإسلامية إلى منطق القرآن الكريم مستشهداً بآياته المباركة كقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...]، وقوله تعالى: [وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً]، والمراد من تلكما الآيتين هو التأكيد على أهميّة مقام النبوّة والولاية في حياة المسلم، فهو سبب النجاة من مهبط الضلال ومصيدة الشيطان، وله رافدان أحدهما مُبلِّغ والآخر مجرٍ، فمَن ترك طاعة أولي الأمر سقط بحبائل الشيطان.
وأولو الأمر في رأي مفسري العامّة هم فئة خاصّة من أهل العلم والفضل والمنزلة الاجتماعية العليا، فمَن هم أعلى منزلة وأغزر علماً وأعظم شأناً من أهل بيت النبوّة المتمثِّل في الإمام علي(ع) وبنيه المعصومين(ع)؟!
«لقد قيل لمعاوية: إنّ الناس قد رموا أبصارهم إلى الحسين(ع)، فلو قد أمرته يصعد المنبر ويخطب فإنّ فيه حصراً أو في لسانه كلالة. فقال لهم معاوية: قد ظننا ذلك بالحسن، فلم يزل حتّى عظم في أعين الناس وفضحنا، فلم يزالوا به حتّى قال للحسين: يا أبا عبد الله، لو صعدت المنبر فخطبت. فصعد الحسين(ع) على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي(ص) فسمع رجلاً يقول: مَن هذا الذي يخطب؟ فقال الحسين(ع): نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله(ص) الأقربون وأهل بيته الطيبون، وأحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله(ص) ثاني كتاب الله تبارك وتعالى، الذي فيه تفصيل كلّ شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمعوّل علينا في تفسيره، لا يبطينا تأويله، بل نتّبع حقائقه. فأطيعونا فإنّ طاعتنا مفروضة، أن كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة، قال الله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ ...] وأُحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان بكم؛ فإنّه لكم عدو مبين... قال معاوية: حسبك يا أبا عبد الله قد بلغت».
لقد جعل الإمام(ع) خط طاعة الله تعالى ممتداً إليهم(ع) بواسطة الملازمة الحكميّة مع طاعة رسول الله بقوله(ع): «... فأطيعونا فإنّ طاعتنا مفروضة، أن كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة»، أيّ: إنّ البرزخ الفاصل بين اتّباع الحقّ وطاعة الرحمن عن اتّباع الباطل وطاعة الشيطان هو الاعتقاد العملي بولاية أهل بيت النبوّة، وبناءً عليه صدر تحذيره(ع) للناس: «وأحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان».
إنّ هذا الحوار القرآني البديع يُخاطب العقل ويذكّره بحقيقة قصور الإنسان المعرفي من دون التمسّك بمرجعيّة المعصوم المتجليّة في القرآن الكريم (الثقل الصامت) وأئمة أهل البيت (الثقل الناطق)، فإن جُعلا مرجعاً لمعرفته ومصدراً لسلوكه، استقامت حياته وانتظمت شؤونه وسَعُدَ في الدنيا وفاز في الآخرة، وإن اتّبع شهواته ووساوس الشيطان اضطربت حياته وزاد بلاؤه وكثرتْ محنه وشقي في آخرته، وهو ما قررته الآية المباركة: [وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ]، فالنتائج تتبع أخسّ مقدّماتها كما تتأثر الأحداث التاريخية بطبيعة العقل البشري ومستوى إدراكه للحقائق الإيمانية، وعليه كانت دعوة الإمام الحسين(ع) الصريحة للأُمّة إلى ضرورة إدراك الناس للحدِّ الفاصل بين الإيمان والكفر وما يترتّب على إثره من نتائج في الدارين، فقد أبرز في حواره فضل أهل البيت(ع) الذين أذهب الله عنهم الرجس، ومقامهم عند الله تعالى بكلامٍ مستوحى من آي الذكر الحكيم.
انطلاقاً ممّا ذُكِرَ يسترسل الإمام(ع) في إلقاء الحُجّة البالغة من حواره البليغ، ويبعث رسالة أُخرى فيها مصداق للإمامة يذكِّرهم فيها بضرورة الإقرار بولاية الإمام علي(ع) امتثالاً لتنصيب النبي(ص) له في غدير خم وبيعتهم له، وكان ذلك قبل موت معاوية بسنتين، فبعد أن حجّ الإمام الحسين(ع) جمع الناس، ثمّ قال في سؤالٍ تقريري: «أُنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله(ص) نصبه يوم غدير خم فنادى له بالولاية وقال: ليبلغ الشاهد الغائب؟ قالوا: اللهم نعم»، وهي خطوة متقدّمة في الاستدلال على قضيةٍ ـ قياسها معها ـ حكمها منتج لدليلِ أفضليّة الإمام علي(ع) أوّلاً، ولزوم امتثال أمر رسول الله(ص) في الاقتداء بولايته ثانياً، وقد أقرّوا وبايعوا الإمام علياً(ع) وقتها فلا ينبغي ـ عقلاً وشرعاً ـ أن ينكثوا بيعته ويستبدلوها ببيعة مَن لا حظّ له في علمٍ، ولا رصيد عنده من تقوى ـ مقابل أهل بيت النبوّة ـ وإن تقادمت السنون والأزمان.
وفي سياقٍ متّصلٍ يستفهم الإمام(ع) الناس بسؤال تقريري آخر ـ يتضمّن معنى التنبيه إلى سريان مبدأ الولاية لأئمّة أهل البيت(ع) وامتدادها الشرعي فيهم من بعد الإمام علي(ع)، وطلب الإذعان لولايتهم ـ بقوله: «أتعلمون أنّ رسول الله(ص) قال في آخر خطبة خطبها: إنّي قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي، فتمسّكوا بهما لن تضلوا؟ قالوا: اللّهم نعم»، فديمومة الإسلام الحقيقي مرتبطة بدوام التولّي لأئمّة أهل بيت الرحمة(ع) والامتثال لأوامرهم والتزام طاعتهم، ولكنّ القوم كانوا مصداقاً لقوله تعالى: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) ، لقد ألقى الإمام الحسين(ع) عليهم الحجّة البالغة وألزمهم الامتثال للأمر الإلهي، فبعد اليقين والقطع بصدور هذه الوصايا من النبيّ الأكرم(ص) في حقّ الأئمة المعصومين(ع) ومع إقرارهم بولايتهم كان أكثرهم جاحدين بها ومنكرين لفضلهم ظلماً وتكبّراً.
ممّا تقدّم من أنوار الإمام الحسين(ع) الفكريّة التي صاغها في حواريّة عقديّة مستوحاة من كتاب الله العزيز ـ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ـ في إثبات مقام الخلافة الشرعية لأهل بيت النبوّة(ع) يمكن أن نستخلص منها استنتاجاً نافعاً في بناء كيان المؤمن العقديّ يتضمّن ما يلي:
إنّ الإنسان مهما بلغ من علمٍ ومنزلةٍ اجتماعية لا يخرج عن حقيقة العبوديّة لله تعالى، ويبقى العبد محتاجاً لعون خالقه وتأييده في خوض عباب هذه الحياة المشحونة بالمشكلات الاجتماعيّة والسياسيّة وغيرها من الأمور الماديّة والمعنويّة، ولا يُمكن لأيّ إنسانٍ أن يتصدّى لحلّ جميع تلكم المشكلات ما دام غير متكاملٍ من جميع جهات الكمال المادي والمعنوي؛ لأنّ مهام القيادة خطيرة، ومسؤوليّة أمانة الخلافة الإلهيّة في الأرض لا يتحمّلها إلّا مَن توافر فيه شرط الكمال والخلو من كلِّ نقصٍ يُوجب الخطأ في تنفيذ أحكام الخالق الحكيم بين عباده، فلا يُمكن بحالٍ أن يُصلِحَ المرءُ غيرَهُ ويُكمِّله وهو غير كاملٍ، فضلاً عن كونه فاسداً؛ لأنّ فاقد الشيء بذاته لا يُعطيه لغيره، بل هو أحقّ بالتلّقي والاستمداد، فمَن تسنّم منصباً بغير استحقاق فقد أطاع نفسه الأمّارة بالسوء واستجاب لوساوس الشيطان وصار أداةً طيِّعةً لمكائده المسببة للفساد والهلاك.
إنّ الحوار الحسيني انطلق من وحي الفطرة السليمة مستدلاً على ضرورة اتّباع مَن أراد الله تعالى أن يكون خليفةً وحاكماً بين عباده باستحقاقٍ بعد توافر شروط الكمال والتنزّه عن كلِّ رجسٍ يمنعه من تحقيق العدل الإلهي، ولا يستحق هذا المنصب إلّا مَن شَهِدَ له القرآن الكريم بعصمته وكمال أخلاقه، وقد أمر الله تعالى عباده بلزوم طاعة نبيِّه الأكرم وأهل بيته من الأئمّة المعصومين؛ لتحقيق الغاية من إيجاد الخلق وتأمين سعادتهم في دار الدنيا وضمان فوزهم في دار الآخرة بالنعيم المقيم.
▪ المبحث الثالث: حواره(ع) القرآني في إثبات شرعيّة ثورته
واجهَ إعلانَ الثورةِ الحسينيةِ ـ من المدينة المنورة إلى مكّة الـمُكّرمة ـ موجةُ اعتراضِ بعض المحبِّين إشفاقاً، وأصوات انتقاد المغرضين من الأُمويين حقداً، وما كان من الإمام الحسين(ع) إلّا أن يكون جوابه متناسباً مع معطيات كلِّ معترضٍ بالمداراة للمتعاطفين، ومُفحِماً لكلِّ مناوئ بالحُجّة الدامغة.
لقد توجهّت بعض الاعتراضات على نهضة الإمام الحسين(ع) بتُهمةِ التمرّد وشقِّ عصا وحدة المسلمين، وأنّها مقدمةٌ لإحداث فتنةٍ عظمى. فكان جوابه(ع) في ردِّ هذه الشبهة ـ مستمّداً من دستور الأُمّة وثقلها الأوّل ـ بحوارٍ مستدلاً بقوله تعالى: [وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ]، فبيانه(ع) الثوري هو أحسن القول الداعي إلى طاعة الله تعالى ونبذ طاعة الحاكم الأُمويّ، وجهاده في رفض بيعة الطاغية يزيد المشهور بفسقه هو من أفضل الأعمال الصالحة التي ندب إليها الشارع المُقدّس في التقرّب إلى الله تعالى.
إنّ المتأمّل في جواب الإمام الحسين(ع) على رسالة الأشدق ـ الذي وصمه فيها بتُهمة الشقاق ودعاه إلى اللجوء إليه تحت وصايته ـ يجدُ فيها مدى صلابته(ع) وتنمّره في ذات الله تعالى، وهي سرّ شجاعته في تحدّي الإرهاب الأُمويّ، فقد كان ردّه(ع) بليغاً في نصّه القائل: (أمّا بعدُ، فإنّه لم يشاقق الله ورسوله مَن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال: إنّني من المسلمين، وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة، فخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة مَن لم يخفه في الدنيا، فنسأل الله مخافةً في الدنيا توجب لنا أمانة يوم القيامة).
فآية الدعوة تنطوي على مضامين كثيرة استعملها الإمام الحسين(ع) في الردِّ على قول المرجف والمتخاذل، فهذه المقولة القرآنيّة إنّما صدرت من الله (جلّ وعلا) لتكملة الثناء على المؤمنين [الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا]، ولتوجيه استحقاقهم تلك المعاملة الشريفة؛ وعليه فصدا هذه المقولة يقمع الظالمين في قصورهم، أي: كيف لا يكونون بتلك المثابة وقد قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل.
وذكر هذا الثناء عليهم بحسن قولهم عقب ذكر مذمّة المشركين ووعيدهم على سوء قولهم، مشعر ـ لا محالة ـ أنّ بين الفريقين بوناً بعيداً، طرفاه الحُسنْ المصرّح به، وما يُقابله مفهوم السيّئ، أيّ: فلا يستوي الذين دعوا للمعروف وعملوا صالح العمل مع الذين أنكروا الحقّ وعملوا أسوأ العمل، كما لا تستوي الحسنة ولا السيئة، والمعنى: أنّ كفّة الداعين للإصلاح راجحة ويلزم قبولها؛ إذ لا أحسن منهم قولاً وعملاً، و(مَن) هنا استفهام نفي، أي: لا أحد أحسن قولاً من دعوة الطاعة لله تعالى كقوله: [وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله]. ومَن دعا إلى الله، هو كلُّ أحدٍ نادى إلى عبادته بإخلاص، والدعاء إلى شيءٍ هو أمرُ الناسِ بالتقوى، وتسمية الواعظ ـ عند بعض العرب ـ بالداعي؛ لأنّه يدعو إلى التشيّع لآل علي بن أبي طالب، وهذا حال المؤمنين حين أعلنوا التوحيد، وهو ما وُصفوا به آنفاً في قوله: [إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا]، فقد كان المؤمنون يدعون المشركين إلى توحيد الله، وسيد الداعين إلى الله هو النبي الأكرم(ص).
ثمَّ بيّنَ الإمام الحسين(ع) الغاية من ثورته وهي الغاية نفسها من خلق الإنسان؛ ليختبره المولى تعالى في هذه الدنيا، فقال(ع): «[قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ]، فإذا أقمت في مكاني فبمَن يُمتحن هذا الخلق المتعوس وبماذا يُختبرون؟ ومَن ذا يكون ساكن حفرتي وقد اختارها الله تعالى لي يوم دحا الأرض...». لقد ابتلى اللهُ تعالى الأُمّةَ الإسلاميّة بموقف الإمام الحسين(ع) الثوريّ تجاه الطغيان الأُمويّ، واُبتلِيَ الإمام(ع) بتخاذل تلك الأُمّة وفشلها في الاختبار حتّى أذاقها الله تعالى لباس الخوف والجوع بعد تلك الفاجعة العظمى.
بعد أنّ دافع الإمام الحسين(ع) بحواره القرآني عن سلامة موقفه الثوريّ من كلِّ شائبةٍ، ونزّه دعوتَهُ عن كُلِّ معصيةٍ أو فتنةٍ مُردية، تقدّمَ(ع) لإثبات شرعيّة ثورته ببيانٍ صادحٍ بذكر الله تعالى: [كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله...]، وقوله تعالى: [لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ]، فقد أعلن(ع) أنّ الواعز الرئيس لثورته ودافعه الأساس هو حكم الله تعالى بإقامة دولة العدل والأمر بالمعروف الذي حكم به جدّه المصطفى، والنهيّ عن المنكر الذي حاربه جدّه خاتم الرسل، ؛ ونتيجة لذلك نسمع بيانه(ع) الأوّل لثورته المباركة في وصيته التي كتبها لأخيه ابن الحنفية بعد حوارٍ طويلٍ: (... وأنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي(ص)، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب(ع)).
لقد تردد مضمون حواره(ع) في أذهان الأُمّة الإسلاميّة مدويّاً بين سلبٍ لكلِّ شُبهةٍ ونفيٍّ لكلِّ تُهمةٍ، وبين إيجابٍ لكلِّ ذريعةٍ شرعيّةٍ وإثباتٍ بحُجّةٍ قويّةٍ؛ لأنّ مصدرَها قرآنيٌّ لا يقوى على ردِّها المرجفون، ولا يتمكّن أن يُفنّدها المبطلون. لقد أيقن المسلمون وقتها بضلالة الطاغيّة يزيد وفسقه وجوره، ونزاهة الإمام الحسين(ع) وعصمته بحبل الله المتين وشرعيّة ثورته، واتّضحت صورة مشهد طرفي الصراع لديهم بوضوحٍ تام، وهنا يكمن ثبوت حُجيّة الثورة البالغة لكلِّ مَن سَمِعَ واعية الإمام الحسين(ع) ونداءه، وكان ينقصهم قوّة الإرادة وعلوّ الهمّة وشدّها، ورصانة العزيمة ورزانتها لبلوغ مدرك الفتح الأعظم وتحقيق النصر الأكبر، كما أنّ حبّهم للدنيا هو الحاجز الأكبر لفلاحهم، ورأس كلّ خطاياهم؛ لذلك لمّا استشعر الإمام الحسين(ع) من الأُمّة تثاقلها إلى الأرض وحبّها لزينة الدنيا وإيثارها على نعيم الآخرة ذكرّهم(ع) ـ وقتها ـ بفناء الدنيا وخلود الآخرة، وحتميّة لقاء الله تعالى للحساب، فتلا قوله تعالى: [وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا]، وقوله تعالى: [وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ].
وتأكيداً لبيانه(ع) في وصيته حاورهم وهو في طريقه إلى العراق، فقام في الناس خطيباً وداعياً إلى سبيل الحقِّ وصراطه القويم فقد قال(ع): «إنّ هذه الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت وأدبر معروفها، فلم يبقَ منها إلّا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، أَلا ترون أنّ الحق لا يُعمل به وأن الباطل لا يُتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقِّاً، فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلّا برما».
لقد بيّن الإمام الحسين(ع) أنّ سعادة المرء في الدنيا رهنُ كرامة العيش وعزّة النفس وسيادة المُثل العُليا، ومن دونها فلا خيرَ في الدنيا؛ إذ تكون كالسجن عيشها نكداً ونهارها مُظلماً، وأنّ الإنسان بطبعه يكون مُحبّاً للدنيا، فإن فاق حبُّه لها حبَّه للدين فقد ابتعد عن الله تعالى وأسخط رسولَه(ص) والأئمةَ الطاهرين(ع)، كما أنّه(ع) يرى أنّ المرءَ المُحبّ للدنيا إذا تمحّص بالبلاء ينسى دينه ويبقى حريصاً على دنياه الفانية، مائلاً عن ثواب آخرته الباقية، كارهاً للموت وهو حتميّ عليه. ومَن أحبّ دينه وتعلّق قلبه بالله تعالى مشايعاً لرسوله وأوصيائه(ع) لن تضرّه القلاقل ولا تغريه الزبارج، وحين يرى أنّ الدين في المعمورة مهجوراً عندها يكره الدنيا ويتمنى الموت لملاقاة مَن أحبّه ويتنعم بجواره.
▪ احتجاجه(ع) لردعهم عن سفك دمه الطاهر
لقد صدرت من الإمام الحسين(ع) في حواره مع الأعداء مناشدات فيها أسئلة تقريرية وأُخرى إنكاريّة على غرار الأسلوب القرآني في جداله مع الظالمين، كما نقل أصحاب السير وأرباب التاريخ أنّ الإمام(ع) أراد أن يلقي عليهم الحجّة البالغة وينبِّه عدوه بالعواقب الوخيمة من مبارزته وقتاله مع أصحابه وأهل بيته، فقام فيهم خطيباً في أكثر من مرّة مذكراً، وجادلهم منكراً عسى أن يثيبوا إلى رشدهم ولا يتورطوا في سفك دمه الطاهر، ولكنّهم أصرّوا على قتاله عناداً للحقّ وطمعاً في عطاءٍ زائلٍ، وكانوا في ثواب الآخرة من الزاهدين.
ومن أهم حوارياته الجدليّة مع أعدائه في يوم العاشر من المحرّم للتعريف بنسبه وحسبه، وقبيل أن تشتدّ الحرب بوطيسها وبعد أن وثب الإمام الحسين(ع) متكئاً على سيفه، فنادى بأعلى صوته: «أنشدكم الله، هل تعرفوني؟ قالوا: نعم، أنت ابن رسول الله وسبطه. قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أنّ جدّي رسول الله(ص)؟... قالوا: قد علمنا ذلك كلّه، ونحن غير تاركيك حتّى تذوق الموت عطشاً».
لقد أقرَّ الطرف المعادي بنسب الإمام الحسين(ع) وفضله وحرمة قتاله على غرار إقرار الناس في القرآن الكريم من قوله تعالى: [وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ]، الذي جاء في تفسيره أنّ أتباع الأنبياء والمصلحين قد أقرّوا بالتزام تعاليمهم، وهو بمنزلة الاستحلاف، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لتبليغ الناس أحكام الكتاب وتعليمهم الحكمة، وأن يتعهدوهم الإيمان بخاتم الرسل وينصروه إن أدركوه، ودلَّ على هذا الحلف [وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي]، والإصر هو العهد، والإصر في اللغة الثقل. إنّها مناشدة تجعل القوم في مساءلةٍ كبيرة أمام الله تعالى، وتتبعها أسئلة تقريرية متتالية تُفيد طلب الإذعان وترك الغيّ والشقاق والعناد من خلال تذكيرهم بنسب الإمام الحسين(ع) وحسبه الرفيع، والذي يُلقي الحجّة البالغة عليهم وتدين إصرارهم مع اعترافهم. فقد كان مثله كمثل مؤمن آل فرعون الذي أنكر على قومه متعجباً من إصرارهم على الحنث الوارد في قوله تعالى: [وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ]، فهل يحقُّ للقوم قتال سبطِ نبيِّهم من غير ذنبٍ ولا جناية أو تقصير؟
ثمّ ينتقل(ع) إلى حوار القوم بحُجّةٍ أُخرى عامّة بعد حجّة النسب الخاصّة بشأنه، فيذكِّرهم بالشريعة التي يدينون بها إن كانوا مسلمين حقّاً، فيسألهم مرّةً أُخرى عن المبرر الشرعي لقتاله والاقتصاص منه، فقد قال(ع): «يا ويلكم، أتقتلوني على سنّة بدّلتها؟! أم على شريعة غيّرتها؟! أم على جرم فعلته؟! أم على حقّ تركته؟!».
وفي احتجاجٍ آخر للإمام مستعملاً السؤال الإنكاري المتضمّن للتعجب من موقفهم العدائي، واستغراباً من إصرارهم على قتاله، فناجزهم بحواره وألقى عليهم الحُجّة متوعداً إيّاهم عذاب الآخرة بنداء: (يا ويلكم)، ثمّ أردف الإمام سؤاله الإنكاري بتعجبٍ «عَلامَ تقاتلوني؟!» أيّ: ما هو سبب قتالهم إيّاه وما هو الوجه الشرعي أو العقلي لذلك، فلا يوجد أيّ مبررٍ يوجب قتال الإمام؛ إذ لم يُغيّر سُنّة باختلاق بدعةٍ، ولم يترك حقّاً في ذمته ولم يؤدّه.
لقد أوضح الإمام(ع) من خلال جداله أنّ الأُمّة وقتها أُصيبت بداء انعدام المعايير الصائبة، والانحياز لجهة الباطل بلا دليل شرعي أو عقلي غير اتّباعهم الهوى، فأقام(ع) عليهم الحُجّة البالغة والأدلّة المقنعة، ولكنّهم لم يرعوا ذلك، بل مضوا في غيِّهم، وسعوا في منهج الخلاف لصريح آيات القرآن المجيد، وما أمرهم به من ضرورة إعمال العقل في التمييز بين أهل الحقّ والباطل كما قال تعالى: [أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ٭ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٭ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ]، لقد أعماهم الجهل وأضلّهم حُبُّ الدنيا، فقست قلوبهم وصارت كالحجارة التي لم تفسّرها قوّة زلزلة الحوار الحسيني وروعته، وبلاغة منطقه، وصدق حديثه.
وخلاصة القول تتمحوّر حول أُسلوب الإمام الحسين(ع) البديع في حواره مع الآخرين، وما تمخّض عنه من طرق استدلالية باستعماله لآي الذكر الحكيم؛ لما يحمله من أساليب احتجاجية مقنعة، فقد طرق الإمام(ع) جميع السبل العقليّة والشرعيّة لردع أعدائه من التورّط في سفك دمه الطاهر، فذكّرهم بحسبه ونسبه ومقامه في الإسلام، ثمّ عرج إلى توبيخهم وإصرارهم على قتاله كرجلٍ مسلم ـ على الأقل ـ لعلّة فقدانهم المبرر الشرعي لمناجزته وعدائه؛ إذ لم يُغيّر سُنّةً ولم يأتِ ببدعةٍ، وقد ألقى عليهم الحُجّة البالغة ولم يترك لهم عذراً يقدِّمونه غداً في يوم حسابهم.
ورغم كلّ ذلك البيان البديع والحجج البالغة من حواره(ع) لم يستجب إلّا النزر القليل من المسلمين، ومع قلّةِ العدد وخذلان الناصر صمد(ع) مع تلك الثُلّة المؤمنة بوجه جيش أعتى الطغاة وأكثرهم فسقاً، وسجّل(ع) أكبر حدث شهده تاريخ الإسلام خاصّة والتاريخ الإنساني بصفة عامّة، وهو حدث واقعة الطف التي شهدت أكبر مأساة بقتل الإمام الحسين(ع) وأهل بيته وأصحابه في كربلاء، وسبي نساء أهل بيت النبي(ص) من كربلاء إلى الشام، وهذا الحدث يُمثِّل انعطافة خطيرة في تاريخ المسلمين، ونقطة تحوّل في وعي المجتمع الإسلامي وثقافته؛ لما أحدثه من صرخةٍ مدويّةٍ بوجه الظالمين على مرِّ الأزمان مهما كانت هويتهم أو منزلتهم الاجتماعيّة ومكانتهم السياسيّة.
فسلام على أبي الأحرار يوم وُلِدَ ويوم استُشهد دفاعاً عن بيضة الدين الإسلامي من كيدِ وزندقة بني أُميّة.
▪ نتائج البحث
بعد الاستعراض المقتضب لأُسلوب الإمام الحسين(ع) الحواري لا بدّ من الخروج بنتائج عدّة، وهي ما يلي:
1ـ إنّ المنطلق الأمثل لمعرفة العقائد الإسلاميّة وأُصول الدين هو القرآن الكريم؛ لقطعيّة صدوره بإجماع علماء الإسلام، إلّا أنّهم اختلفوا في فهم معناه وتحمّل وجوهه؛ بسبب الإعراض عن تأويل المتشابه منه وتفسير محكمات آياته، فقد قام بعض المسلمين بالكشف عن مضمونه بالرأي من دون الرجوع إلى أُصوله ومنابع تفسيره.
2ـ لقد استعمل الإمام الحسين(ع) آي القرآن الكريم في أغلب محاججاته مع المبطلين والمضلّين كما هو الحال مع المعترضين على خروجه من المغرضين بعد إعلان ثورته المباركة.
3ـ لقد مهّد الإمام الحسين(ع) لثورته الكبرى بإثبات أُصول الدين الإسلامي؛ لتقوية عقيدة المسلم وزيادة بصيرته، وكشف زيف بني أُميّة وضلالهم وبطلان إمامتهم للأُمّة الإسلامية.
4ـ عمل الإمام الحسين(ع) في توضيح الحقائق ونشرها كمقدمةٍ لبثّ روح الوعي العقدي في عقول المسلمين قبل استنهاضهم للثورة على أُصول الشجرة الخبيثة.
5ـ اتّسم حواره القرآني(ع) بقوّة البيان وتمام الحُجّة البالغة على مَن سمع واعيته المباركة؛ لتكون دافعاً لنهضة الأُمّة بوجه الطغاة، ولكنّ أغلب المسلمين وقتها أعرضوا عن صوت الحقِّ ميلاً لهوى النفس الذي أرداهم في الهاوية.
انتهت
المصدر: مجلة الاصلاح الحسیني، العدد الحادي والثلاثون