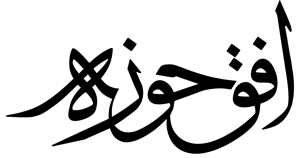

□ مقالة/ الجزء الثاني
الخاتمية والمرجعية العلمية لأهل البيت(ع)
□ آیةالله الشيخ جعفر سبحاني/ ترجمة: السيد حسن مطر
□ الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي «الآفاق» بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها
▪ تضمين حجية أقوال النبي في سنة النبي(ص)
إذا كان كتاب الله وسنة النبي حجة حقاً فإننا نجد في سنة النبي المتواترة أن العترة إلى جانب القرآن الكريم؛ إذ يقول النبي الأكرم(ص): «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله؛ وعترتي». وقد شبّه النبي الأكرم عترته بسفينة نوح؛ إذ يقول: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح، مَنْ ركبها نجا، ومَنْ تخلَّف عنها غرق».
وعليه نتساءل: إذا كان علم ومعرفة كل واحد من أهل بيت النبي لا يتجاوز مستوى علم ومعرفة أيّ صحابي آخر فلماذا أعطى النبي الأكرم كل هذه المزايا لهم، وفضَّلهم على غيرهم، فيسمِّيهم تارةً بعِدْل القرآن، وتارة أخرى بسفينة نوح؟! ألا يشكل هذا النوع من المزايا والخصائص دليلاً على أنهم كانوا يتمتَّعون بعلم مختلف عن العلوم التي عند غيرهم، وأنهم في ضوء هذه المعرفة يعمدون إلى توضيح أحكام قد نزلت على النبي مسبقاً، لا أنهم يأتون بأحكام جديدة ومبتدعة؟
▪ استخلاص النتائج
1ـ كان الأئمة المعصومون(ع) ينقلون الكثير من الأحكام، ويضعونها تحت تصرّف الناس، من صحيفة علي. وإنّ ما يقولونه إنما هو بيانٌ لأحكامٍ تمّ تشريعها مسبقاً، وليس تشريعاً لأحكام جديدة.
2ـ إذا كان الأئمة(ع) يُلهَمون من قبل الله ببعض الأحكام فالمراد من ذلك هو بيان الأحكام التي نزلت على قلب النبي، ولم تتوفَّر الظروف والشروط لبيانها في وقتها.
والذي نرجوه من الكاتب، ومَنْ تَرِدُ على ذهنه مثل هذه الشبهات، أن يفرّق بين إنشاء الأحكام والإخبار عن الأحكام التي نزلت على رسول الله؛ فإنّ إنشاء الأحكام الجديدة مناقض للخاتمية، إلا أنّ الإخبار عن الأحكام التي نزلت على قلب النبي إنما هو تأييد للخاتمية، ومن جملة علاماتها وأدلّتها. والغريب أن البعض يقبل بحصول الإلهام لأمّ موسى(ع)، أو تكليم الملائكة لمريم العذراء÷، أو زوج إبراهيم(ع)، الوارد خبره في القرآن الكريم، ويستكثرون في الوقت نفسه ذلك على الأئمة المعصومين(ع)، ويشكِّكون في إمكانية اطلاعهم على الأحكام التي تمّ تشريعها سابقاً! ومن الآيات الواردة في تكليم الملائكة لغير الأنبياء(ع): [وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ] (آل عمران: 42)؛ [وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ] (القصص: 7).
لقد كان حديثنا حتى الآن مع شخص يؤمن بالخاتمية واختتام عصر النبوّات، ولا يرى للإنسان من سبيل نجاة سوى الإسلام، ولكنْ بقراءة أخرى. ولذلك أوضحنا أن خاتمية النبوّة لا تناقض المرجعية العلمية لأهل البيت(ع) أدنى معارضة، وأنّ أئمة أهل البيت إنما يعملون على بيان الوحي والتشريع الذي سبق أن نزل على النبي الأكرم(ص).
▪ تناقض في الأقوال
أجل، إن لدينا هنا عتاباً خاصّاً لشخص الدكتور سروش، وهو أنّ هذا الإشكال لو كان صادراً عن الآخرين لكان لنا أن نعذره، إلا أنّ مَنْ كان على شاكلة الدكتور سروش فالمفروض أنه يؤمن بسلسلة من الأصول التي لا تنسجم مع ختم النبوّة وانقطاع الوحي. وتلك الأصول التي دعا إليها الدكتور سروش هي:
أ) استمرار الوحي النبوي.
ب) الإيمان بالتعددية الدينية والسبل المستقيمة.
فقد ذكر، في ما يتعلق بالعنوان الأول، «أنّ التجربة النبوية، أو ما يشابه تجربة الأنبياء، لا تنقطع بشكل كامل، بل يبقى لها حضور مستمر ومتواصل».
وذهب في ما يتعلق بالعنوان الثاني إلى العديد من السبل المستقيمة، بدلاً من الصراط المستقيم، فآمن بالتعددية الدينية في أوسع معانيها، وقال بأنّ جميع القراءات الإسلامية صحيحة، ومدعاة إلى النجاة.
وعليه كيف يسوّغ لنفسه تخطئة القراءة الشيعية في ما يتعلق بالأئمة، ويذهب إلى الاعتقاد المقابل والمناوئ؟! وكما يقول المثل: يرى القذى في عين الآخرين، ولا يرى الخشبة المعترضة في عينه. وقد قال في بعض تعبيراته:
1ـ «علينا أن نذعن لهذه الحقيقة بالمطلق. وعلينا أن نغيّر نظرتنا. وبدلاً من القول بوجود خط واحد مستقيم في العالم، والكثير من الخطوط المنحرفة والمائلة، علينا أن نرى تقويم جميع الخطوط، رغم تقاطعها وتوازيها وتطابقها، وهناك في الحقيقة امتزاج بين الحقائق».
فإذا كانت جميع الخطوط عنده مستقيمة وصحيحة فكيف يرى عقيدة الشيعة في باب المرجعية العلمية للأئمة خطاً مائلاً ومنحرفاً عن الصراط المستقيم، فإلى أيّ شيء يشير هذا التناقض بين النظرية والتطبيق؟!
2ـ «إنّ الإسلام السني فهم للإسلام. وكذلك الإسلام الشيعي، فهو فهم آخر للإسلام. وإن هذا وتوابعه ولوازمه أمر طبيعي وصحيح». فإذا كان الإسلام الشيعي ـ كما يقول ـ فهماً طبيعياً وصحيحاً عن الإسلام فكيف يذهب الآن إلى الاعتقاد بأن إيمان الشيعة بمرجعية أئمتهم العلمية أمرٌ غير طبيعي وغير صحيح؟!
▪ نظرية تكامل المعرفة الدينية (القبض والبسط) ولوازمها الخاطئة
إنه عندما استعرض نظرية القبض والبسط في مجلة «كيهان» قال بأنّ كلّ العلوم البشرية مترابطة ومتداخلة فيما بينها، كالسبحة في اليد، فعندما يحصل تغير أو تحرك في أيّ من هذه العلوم فإنّ ذلك يؤثِّر بصورة أو بأخرى على العلوم الأخرى، بما في ذلك العلوم الدينية.
وقد قلت في نقد هذه النظرية:
1ـ إنّ التعبير بالقبض والبسط في فهم الشريعة إنما هو تعبير محترم ومؤدب عن السفسطة والتشكيك الذي ظهر في اليونان، وتمّ القضاء عليه فيما بعد من قبل حكماء من أمثال: أرسطو وغيره. وعلى مَنْ أراد المزيد الرجوع إلى تلك المقالة.
2ـ إنّ فرضية (القبض والبسط في فهم الشريعة) قد حكمت على نفسها بالموت؛ لأنها تشمل نفسها أيضاً. فلربما تتحول هذه النظرية في ضوء سلسلة من الفرضيات في العلوم والمعارف إلى أكثر عمقاً، بل ومتناقضاً بينه وبين نفسه أحياناً.
3ـ إنّ هذه النظرية لا تتناسب والخاتمية، في حين أنّ الخاتمية من الأسس والأصول الثابتة والبديهية في الإسلام. فإننا لو فرضنا تحول الأفكار والعلوم والموضوعات فإن ذلك يشمل الخاتمية؛ بوصفها موضوعاً أيضاً، فلا بد أن يطالها التغيير والتبدّل نتيجة للتبدُّل والتغيّر في تلك العلوم.
لقد كان هذا النقد من الوضوح والقوّة بحيث اضطر أحد مناصريه، الذي ألَّف كتاباً تحت عنوان: «نقد بعض الاعتراضات الموجّهة لتلك النظرية»، إلى القول بأنه وجده وجيهاً للغاية. فما عدا مما بدا؛ إذ بادر حالياً، رغم مبانيه في التجربة النبوية، واستمرار الوحي، والاعتقاد بالسبل المستقيمة، والتعددية الدينية، والقول بمختلف القراءات عن الدين، يأتي ويهدم كل ما بناه من خلال انتقاده للفكر الشيعي؟! أما أنا ففي حيرة من أمره! وعليه أن يفتينا مأجوراً.
▪ المحور الثاني: خصائص الأنبياء(ع)
قال سروش: إنّ للأنبياء ثلاث خصائص أساسية، وهي:
أـ إنهم يحصلون على علومهم ومعارفهم من الله تعالى مباشرة بلا واسطة.
ب ـ إنهم معصومون عن الخطأ في القول والفعل.
ج ـ إنّ كلامهم حجّة على غيرهم.
وبذلك يصل إلى نتيجة مفادها أننا كلما ذهبنا إلى اعتبار علم أئمة الشيعة مباشرياً، وليس اكتسابياً، ومن جهة أخرى نعتبرهم معصومين عن الخطأ في القول والفعل، واعتبرنا حجيّة كلامهم على الآخرين، فعندها لن يكون هناك أيّ فرق بينهم وبين الأنبياء، وإنّ مسألة الخاتمية ستغدو مجرّد لفظ بلا مفهوم.
ونقول في تحليل كلامه ما يلي:
أولاً: صحيح أنّ الأنبياء يتمتعون بهذه الخصائص الثلاث، ولكن بالإضافة إلى هذه الخصائص الثلاث هناك خصيصة رابعة لا توجد في الأئمة، فإنّ للأنبياء مقام النبوّة والشريعة، وإنّ الوحي الإلهي إنما نزل عليهم لأنهم حملة شريعة، ومؤسِّسون لدين جديد. والأئمة يفتقرون إلى هذه الخصيصة الرابعة، أي إنهم لا يتمتعون بمرتبة النبوّة، وليسوا دعاة لشريعة جديدة، وإنما هم مشمولون لنعمة الله، فاستحقوا حمل شريعة النبي الأكرم(ص)، حيث استؤمنوا واستحفظوا عليها.
ثانياً: صحيح أنّ الأئمة يتمتعون بهذه الخصائص الثلاث، ولكن هذا لا يعني أنّ كل من توفَّرت فيه هذه الخصائص يجب أن يكون نبياً بالضرورة. وكما يقول المثل المعروف: «ليس كل ما يلمع ذهباً». وكما يقول المناطقة: إنّ بين هذه الخصائص الثلاث وبين النبوة عموماً وخصوصاً مطلقاً، فكلُّ نبي يجب أن تتوفر فيه هذه الخصائص الثلاث، ولكن ليس كلّ من توفرت فيه هذه الخصائص الثلاث يجب أن يكون نبياً بالضرورة.
ففي ما يتعلَّق بالخصيصة الأولى، وهي العلم اللدني، يمكن القول: كثيراً ما يحصل ذوو النفوس الطاهرة على علوم من العوالم العلوية إلهاماً، دون أن يكون ذلك العلم اكتسابياً، ومع ذلك لا يكونون أنبياء، وقد تقدم أن ذكرنا أمثلة لذلك.
وفي ما يتعلق بالخصيصة الثانية، وهي العصمة، فعلينا التذكير بأنّ العصمة ليست من الخصائص المنحصرة بالنبوّة، فإنّ السيدة مريم العذراء ـ مثلاً ـ معصومة عن كلّ خطأ؛ بحكم قوله تعالى: [يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ] (آل عمران: 42)، ومع ذلك لم تكن نبيّة.
وفي ما يتعلق بالخصيصة الثالثة يمكن القول بأنّ حجية الكلام لا تلازم النبوّة، فالعقل ـ مثلاً ـ حجّة على الجميع، مع أنه ليس نبياً. وهكذا هي فتوى الفقهاء، فإنها حجّة على المقلِّدين، وليس هناك مَنْ يذهب إلى القول بنبوّة الفقهاء.
وخلاصة القول: إنّ هذه الخصائص، سواء كانت مجتمعة أو متفرّقة، ليست من العلائم المنحصرة في الأنبياء، وإنْ كان جميع الأنبياء يتمتعون بهذه الخصائص. وإن ما يمتاز به الأنبياء عن غيرهم هو كونهم أصحاب شرائع، ومؤسِّسين لأديان. وهذه الخصيصة لا توجد عند سواهم، حتى لو كانوا أئمة. وليس هناك مَنْ يدعي ذلك سوى الأنبياء.
ونحن نسأل الكاتب: ما هو المحذور في أن يعلِّم الله تبارك وتعالى جماعة؛ ليبلغوا ما أنزله على صاحب الشريعة، ولم تساعده الظروف على بيانها، ويجعلهم معصومين من الخطأ؛ كي لا يحصل نقض للغرض في إبلاغ الرسالة، ويقول للناس بأنّ تقريرهم عن صاحب الشريعة حجّة عليكم؟ فهل تعدّ مثل هذه الموهبة والنعمة مستحيلة عليه وعليهم؟!
فيجدر بنا عدم إنكار التعاليم تحت ذريعة صيانة الخاتمية.
إنّ خاتم الأنبياء(ص)، الذي جاء بالدين الإسلامي، وعرَّفه على أنه الدين الخاتم، والجامع للأحكام الثابتة والباقية عبر العصور، أثبت بنفسه هذه الخصائص للأئمة من بعده في تعابير صريحة وواضحة:
1ـ فمن جهة يعبّر عنهم بأنهم عِدْل القرآن؛ إذ يقول: «كتاب الله؛ وعترتي». ولا يخفى أنّ عِدْل القرآن لابد أن يكون مثله في العصمة والحجية على الناس.
2ـ إنّ النبي الأكرم(ص) قال للناس: إنّ الهداية في اتباع العترة، والضلالة في التخلُّف عنهم، والتمرّد على أوامرهم؛ إذ يقول: «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا أبداً». وقال في شأن أمير المؤمنين علي(ع): «أنا مدينة العلم، وعلي بابها».
فهل كان علم الأئمة(ع) بالمسائل العقائدية والعلمية علماً اعتيادياً، كالعلم الذي يحصل عليه الطالب من خلال حضوره في الدرس على يد بعض الأساتذة، أو أنهم تعلَّموا ذلك بطرق غير عادية، كما هو الحال بالنسبة إلى صاحب موسى(ع)؛ إذ يقول عنه تعالى: [وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً]؟
لو كان الأئمة المعصومون(ع) كسائر الناس العاديين فما هو معنى كلّ هذا التأكيد على وجوب اتباعهم؟! وعليه لا ينبغي إنكار سائر التعاليم بحجة الحفاظ على الخاتمية، فتكون كلمة حقّ يراد بها باطل.
مضافاً إلى استحالة أن تكون هذه المعارف والتعاليم التي وصلت إلينا من الأئمة(ع) نتيجة لدراسة عادية؛ فإنّ كثرتها وعمقها وعظمتها لدليل على أنها ثمار جنة أخرى.
انتهی ویلیه الجزء الثالث
المصدر: نصوص معاصرة، العـدد الواحد والعشرون
السـنة السادسة، شتاء 2011م، 1432هـ