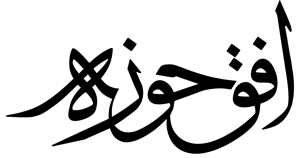

مقالة
الأسس والمصادر الاجتهادية المشتركة - الجزء الأول
الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي «الآفاق» بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمّد نبي الرحمة الذي لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه المهديين الّذين آمنوا به وآزروه ونصروه والتزموا منهجه ودعوته، وبعد:
نحن ـ المسلمين ـ اليوم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء، والعمل المشترك، من أجل قوة الأمة الإسلاميّة، والحفاظ على وجودها وعزتها من أي وقت مضى فكان لزاماً مؤكداً ضرورة تسوية الخلافات التاريخية والمشكلات المعاصرة، والتعريف بالجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلاف بين المذاهب السنية والشيعية سهل يسير، ونقاطه قليلة محصورة، بسبب وحدة المصادر الاستنباطية، والاعتماد أصالة على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كلّ نزاع أو خلاف إليهما، كما في قول الله تعالى. فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إنّ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.
وغني عن البيان أن مبدأ الوحدة الإسلاميّة مقرر مفروض على امتنا في دستورهم المجيد، في مثل الآيتين الكريمتين، الأولى وهي قوله سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأتقون.
وأول من يخاطب بضرورة العمل على توحيد أفكار الأمة المسلمة وطرح كلّ العراقيل والمعوقات أمامها هم العلماء الإثبات الّذين نضجت أفكارهم واختمرت معارفهم وعلومهم وترفعوا عن رعشات التعصب المذهبي، وأدركوا خطر الاستعمار الحريص على تجسيد التفرقة بين السنة والشيعة. وليس المقصود من الوحدة الإسلاميّة بداهة أن يتحول السني إلى شيعي أو بالعكس، لأن نقض الموروث ليس بالأمر الهين، بل لا جدوى من محاولات التغيير.
لذا بادرت إلى بحث موضوع «الأسس والمصادر الاجتهادية المشتركة» لا سهم بواجبي في هذا السبيل العلمي الخصب، لأن جميع المذاهب السنية والشيعية متفقة على ضرورة الاجتهاد وفرضيته في كلّ عصر، عملاً بأصول الأدلة الشرعية، وبعداً عما سمي بإغلاق باب الاجتهاد عند أكثر المتأخرين من علماء السنة بعد نهاية القرن الرابع الهجري تأثراً بظروف سياسية مؤقتة، وتعرضها لتيارات فكرية هدامة، ومحاولة إضعافها من زاوية الاجتهاد، علماء بأن من وراء تلك التيارات لم يكونوا مؤهلين للاجتهاد، وكان لهم غايات خبيثة ومحاولات مسمومة مشبوهة ويتميز الشيعة بأنهم لا يجيزون تقليد المجتهد الميت، بل لابد من كونه حياً حتّى يصح تقليده أو بأذن بتقليد حكم معين.
ومنهجي في البحث: هو إيراد مختلف المصادر الاجتهاد، وكان لهم غايات خبيثة ومحاولات مسمومة مشبوهة. ويتميز الشيعة بأنهم لا يجيزون تقليد المجتهد الميت، بل لابد من كونه حياً حتّى يصح تقليده أو يأذن بتقليد حكم معين.
ومنهجي في البحث: هو إيراد مختلف المصادر الاجتهادية، وتحديد أسسها، وتعريفها، وإيراد أهم دليل لأصحابها إثباتاً أو نفياً، ثم التقريب بين العلماء ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب في كلّ واحد منها.
ولابد أولا أن احدد مصدر التشريع الأصلي المتفق عليه، ثم تبيان المصادر المعتبرة في الاستنباط في ساحة المذاهب الإسلاميّة.
وحدة المصدر التشريعي:
اتفق المسلمون في بحث الحاكم على أن مصدر جميع الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية هو الله سبحانه وتعالى بعد البعثة النبوية وبلوغ الدعوة الإسلاميّة للناس، سواء أكان ذلك بطريق النص من قرآن أو سنة بواسطة الفقهاء والمجتهدين؛ لأن المجتهد مظهر للحكم، وكاشف له، ومبين مراد الله بإصدار الحكم في غالب الظن، أم قطعا ويقينا، وليس المجتهد منشئاً أو واضعاً للحكم من عند نفسه، وبمحض عقله وفكره، لهذا قالوا: الحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع والاقتضاء معناه الطلب، ويشمل طلب الفعل بالإيجاب أو الندب، وطلب الترك بالتحريم أو الكراهة. والتخيير الإباحة وهو استواء الفعل والترك والوضع: خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة.
وقال الأصوليون والفقهاء أيضاً: لا حكم إلاّ لله أخذاً من قوله تعالى: (إنّ الحكم إلاّ لله...)
وأنكر الأستاذ محمّد تقي الحكيم التعريف ـ الذي جاء في القوانين المحكمة ـ للعقل كأحد المصادر بأنه «حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي» قائلاً: والذي يؤخذ على هذا التعريف من وجهة شكلية تعبيره بالحكم العقلي، مع أنّه ليس للعقل أكثر من وظيفة الإدراك، وهو مقصود حتماً، وأظن أن التعبير بالحكم وانتشاره هو الذي أوجب أن يلتبس على بعض الباحثين في أن القائلين باعتبار العقل من الأصول يرونه هو الحاكم في مقابل الله عزّوجل. وقرر بصراحة أن العقل مدرك وليس بحاكم.
مصادر الاستنباط في المذاهب الفقهية:
مصادر الأحكام الشرعية: هي الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام الشرعية.
ومصادر الاستنباط عند أهل السنة قسمان: مصادر أساسية مستقلة ومصادر فرعية اجتهادية غير مستقلة. أما المصادر الأساسية المستقلة: فهي القرآن الكريم والسنة النبوية للأوامر الإلهية الآمرة بإطاعة الله والرسول، مثل قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله(ص) في حجة الوداع: «تركت فيكم أمرين ما إنّ اعتصمتم بهما، فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه». وفي رواية صحيحة أخرى: «كتاب الله وعترتي».
والمصادر الفرعية: هي الإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح (أو المصالح المرسلة) والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والذرائع والاستصحاب.
ومصادر التشريع عند الزيدية: هي قضايا العقل المبتوتة، والإجماع الثابت بيقين، ونصوص الكتاب والسنة المعلومة، ومفهومات الكتاب والسنة المعلومة، ومفهومات أخبار الآحاد، وأفعال النبي وتقريراته، والقياس والاجتهاد (ومنه الاستحسان وسد الذريعة والمصالح المرسلة) والاستصحاب وهو ما يعرف بالبراءة الأصلية.
ومصادر الاستنباط عند الإمامية أو الجعفرية أربعة: وهي الكتاب العزيز، والسنة، والعقل والإجماع وما عداها فهو راجع إليها في أغلبية صوره.
وبما أن موضوع البحث مقصور على المصادر الاجتهادية المشتركة، فإني أخص بحثي بغير الكتاب والسنة المتفق على كونهما مصدري التشريع الأصليين، ومن العجب وجود الشبه الواضح في ميدان الفقه التفريعي بين الفقه السني والفقه الجعفري والزيدي في كثير من المسائل كما أن مصدر «العقل» عند الشيعة الإمامية وهو التفكر في المصدرين الأصليين المتفق عليهما يمكن أن يدخل تحته كثير من أنواع المصادر الاجتهادية عند أهل السنة، وهذان دليلان واضحان على أنّه في مجال التطبيق والاستنباط يكاد ألا يكون هناك خلاف جوهري في المصادر، وإنّما الخلاف في التسمية والاصطلاح، أو في الكثرة والقلة، أو في الشهرة في استعمال مصدر لدى أئمة مذهب، وانعدام تلك الشهرة في اتجاه إمام آخر، أو أن محل الخلاف أو النزاع غير متفق عليه، كما هو الشأن في الاستحسان على الاستحسان بالهوى والشهوة و محض الرأي من غير دليل شرعي، وهذا ما لا يقول به قطعاً كلا الإمامين: أبي حنيفة ومالك، كما سيأتي بيانه.
ولقد أصاب الشيخ محمّد تقي الحكيم حينما قسم الاجتهاد إلى قسمين: الاجتهاد العقلي، والاجتهاد الشرعي. وهذه القسمة واضحة بالإشارة إلى أن مختلف أئمة الاجتهاد بالرأي المتفق مع مقاصد الشريعة يعتمدون في الاستنباط على كلا القسمين على حد سواء.
أما الاجتهاد العقلي: فهو ما كانت الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي، وينتظم في هذا القسم كلّ ما أفاد العلم الوجداني بمدلوله، كالمستقلات العقلية وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغاً يقينياً، وقبح العقاب بلا بيان وغيرها.
وأما الاجتهاد الشرعي: فهو كلّ ما احتاج لدليل شرعي إلى جعل حجيته من الحجج الشرعية، ويدخل ضمن هذا القسم: الإجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف والاستصحاب وغيرها من مباحث الحجج والأصول العملية التي تكشف عن الحكم الشرعي.
وهذه آراء العلماء في مصادر التشريع الاجتهادية.
1 ـ الإجماع:
الإجماع مصدر من مصادر التشريع، اتفقت المذاهب الإسلاميّة الستة من السنة والشيعة على حجيته، وتعريفه بتعاريف متقاربة.
فتعريفه المعتمد عند جمهور أهل السنة هو: «اتفاق المجتهدين من أمة محمّد(ص) بعدوفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي» وهذا التعريف يتطلب اتفاق جميع مجتهدي الأمة من سنة وشيعة في عصر من العصور على حكم شرعي. واستدلوا على حجيته بأدلة من القرآن والسنة، وأقوى الأدلة: ما ثبت في السنة المتواترة تواتراً معنوياً وهو ورود أحاديث ثابتة بألفاظ مختلفة تثبت عصمة الأمة من الخطأ، منها: « لا تجتمع أمتي على الخطأ» ومنها: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ولابد للإجماع من مستند عند الجمهور، والمستند: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه. ويصلح المستند أن يكون نصاً أو قياساً؛ لأن الإفتاء بدون مستند خطأ، لأنه يعتبر قولاً في الدين بغير علم، وهو منهي عنه بقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم...).
وفائدة الإجماع مع وجود المستند: إنّ كان المستند قطعياً فهو التأكيد، وإن كان ظنياً فهو رفع مرتبة الحكم من الظن إلى القطع واليقين.
وقد وقعت إجماعات كثيرة من الصحابة وغيرهم إذا كان المستند نصاً شرعياً، مثل الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث، وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه، وعلى بطلان زواج المسلمة بالكافر، وعلى حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج، وعلى وجوب العدة بموت الزوج ونحو ذلك، وكذلك إذا كان المستند قياساً مثل تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه.
أما الإجماع الاجتهادي المحض: فلا نكاد نجد له مثالاً سوى شركة المضاربة، فقد أجمع العلماء على جوازها، وليس هناك نص صريح عليها، كلّ ما في الأمر أن الناس تعاملوا بها في عهد النبي(ص)، فأقرهم عليها، ولم ينكرها عليهم، وربما كان هذا سنة تقريرية عند المتمسكين بالنص. وهي مشروعة عند الإمامية بنص من الإمام الصادق(ع).
وعرف الشيعة الإمامية الإجماع بأنه: «اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي» أي فلا يشترط اتفاق جميع العلماء، وهم يقولون: إنّ الإجماع حجة، لا لكونه إجماعاً، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده عندهم حجة، لأنه رأس الأمة ورئيسها، لا لكونه إجماعاً، وغير المعصومين لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم على المخالفة، فالحجية عندهم منوطة بإجماع الأمة. وإذا كانوا يرون أن الإمام المعصوم غير موجود الآن، فلا يحدث إجماع أصلا بدونه. والأئمة المعصومون أثنا عشر إماماً، وأنهم لا يخطئون في اجتهادهم. ولا يصلح القياس عندهم مستندا للإجماع.
ويرى الشيعة الإمامية والزيدية: أن إجماع العترة حجة، وأرادوا بالعترة أصحاب الكساء وهم السادة علي وزوجه فاطمة، وابناهما الحسن والحسين(ع)، وهم معصومون منزهون عن الخطأ في الاجتهاد، ولا تعترف الزيدية بالعصمة لغير هؤلاء من أئمة آل بيت رسول الله(ص)، خلافاً للشيعة الإمامية الّذين يقولون ـ كما تقدم ـ بعصمة الأئمة الأثني عشر جميعهم.
ويلاحظ أن أهل السنة: يعتبرون الإجماع حجة قائمة بذاتها، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة مباشرة في ترتيب الأدلة الشرعية.
ويرى الشيعة الإمامية أن حجية الإجماع بسبب حكايته عن الكتاب والسنة، بحيث يكشف عنهما أو عن أحدهما، وإلا فلا حجة له.
أما الزيدية: فيرون أن الإجماع المتواتر له قوة الأحاديث المتواترة، وهو الإجماع الثابت بيقين، ومقدم على نصوص الكتاب والسنة وظواهرها ومفهوماتها المعلومة.
ويقول الشيعة الإمامية: إنّ الإجماع لم يقع، وهو غير ممكن، والمراد بحديث «لا تجتمع أمتي على الخطأ أو على الضلالة» نفي الخطأ والضلال عن الأمر تقرره الأمة باتفاقها واجتماع آرائها في أمر دنيوي وغيره، فضلاً عن أنّه ليس بمتواتر تواتراً معنويا، ولا تقصر الأمة على المجتهدين وأهل الحل والعقد فيها، وإنّما تشمل جميع الأفراد.
وبه يتبين أن جميع المذاهب الستة متفقة على اعتبار الإجماع حجة، ولكن حجيته تتفاوت قوة وضعفا لدى هذه المذاهب نتيجة اجتهادهم في الفهم والاستنباط.
2 ـ العقل:
العقل المحض لا يعتبر مصدراً من مصادر التشريع أو الاستنباط عند فقهاء الشريعة الإسلاميّة بالاتفاق؛ لأنه لا يحقق العدالة المجردة، ولا المصلحة العامة الثابتة، ولا الاستقرار المنشود، بسب تفاوت العقول البشرية في إدراك الأمور، واختلافها في مقاييس الخير والشر، وقصور إدراكها لحقائق الأشياء، واكتشاف آفاق المستقبل، وتأثرها بالمصالح الذاتية واندفاعها وراء الأهواء والشهوات، وحماية الثروات الخاصة والفئات المعينة.
حتّى إنّ المعتزلة الّذين يقولون: يصلح العقل لإدراك حسن الأشياء كالصدق والمروءة فتكون مأموراً بها، وادراك قبحها كالكذب والقتل، فتكون منهيا عنها، يقولون: إنّ هذا قبل البعثة النبوية، وإن العقل لا ينشئ هذه الأحكام ولا يضعها، وإنّما المنشئ لها هو الله رب العالمين، وحكم العقل مقصور على معرفة حكم الله تعالى في هذه الأشياء بواسطة إدراك صفات الحسن والقبح الذاتية فإذا أدرك ما فيها من حسن، أدرك حكم الله فيها، فيتعين عليه تركها ولا يتعدى عمل العقل معرفة الحكم وإدراكه، أما واضع الحكم ذاته ومشئه فهو الله رب العالمين.
ويقتصر دور المجتهدين باتفاق المذاهب الإسلاميّة على مجرد كشف الأحكام وإظهارها، بتفهم النصوص وتطبيقها والقياس عليها عند القائلين به، والاجتهاد في استخراج الأحكام منها، وليس فيه وضع للأحكام من عند أنفسهم، أو إنشاء لها بواسطة عقولهم وأفكارهم؛ لأنهم يستندون إلى الكتاب والسنة في كشف هذه الأحكام وبيانها، ولا يعتمدون على غيرها بتاتاً، سواء أكان الاجتهاد جماعياً أم فردياً.
فسلطة التشريع في الإسلام هي لله رب العالمين، وللرسول(ص)، باعتبار أنّه رسول ومبلغ وحي الله إلى سائر الناس.
والغزالي في مبحث دليل العقل والاستصحاب وهو الأصل الرابع لديه يعتبره دليلا على إدراك بعض الأحكام قبل البعثة، لا دليلاً على الحكم الشرعي ذاته، فيقول:
«دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل(ع)، وتأييدهم بالمعجزات، وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع». أي أن العقل يرشد إلى البراءة ويدل عليها، لا أنّه يقررها ويحكم بها.
والشيعة الإمامية والمعتزلة كالغزالي يعتبرون العقل مدركا وليس بحاكم، فهم كغيرهم من المسلمين ـ كما تقدم ـ يرون أن لا حكم إلاّ من الله تعالى، وهذا مقرر بإجماع الأمة، إلاّ أنهم يذكرون أن العقل إذا أدرك قبل البعثة حسن شيء أو قبحه، فينبغي على المرء أن يفعل الحسن ويترك القبيح، كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة، والعدل والإنصاف، وحسن الدق النافع، وقبح الظلم وحرمته، وقبح الكذب مع عدم الضرورة، وحسن الإحسان واستحبابه، فالعق ليستقل بإدراك الحسن والقبح. والمراد بالحسن هنا: هو ما يترتب على فعله المدح في الدنيا، والثواب في الآخرة، والمراد بالقبيح: ما يترتب على فعله الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. ولا يتوقف إدراك ذلك على الشرع، والشرع فقط مؤكد لحكم العقل فيما يعلمه من حكم الله تعالى وإذا أدرك الإنسان الحسن والقبح بهذا المعنى فيكلف به فعلاً أو تركا، ويترتب على ذلك الثواب أو العقاب في مخالفة ما أدركه العقل. فالحاكم حقيقة هو الشرع إجمالا، ولكن العقل في رأيهم كاف في معرفة حكم الشرع.
والأشاعرة يخالفونهم في هذا الكلام بشقيه ك الإدراك والتكليف، لا،ه لو لم يكن الحسن والقبح في الأفعال بحكم الشارع نفسه، وكان بحكم العقل، لا ستحق تارك الحسن وفاعل القبح قبل بعثة الرسل العقاب، وهذا مخالف لصريح الكتاب في قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتّى نبعث رسولا) وقوله سبحانه: (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى.
وأجاب الشيعة عن هذا الدليل بأن العقل ـ وأن كانت له وظيفة الإدراك ـ إلاّ أن إدراكه محدد بحدود خاصة لا تتجاوز الكليات، فالإدراك منحصر في الكليات ولا يتناول الأمور الجزئية، كما لا يتناول مجالات التطبيق إلاّ نادراً، والكليات لا تستوعب شريعة ولا تفي بحاجات البشر. بل إنّ ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شعري لا ستحال ثبوتها. وقال الشوكاني: «وبالجملة، فالكلام في هذا البحث طويل، وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو قبيحاً مكابرة ومباهتة. وأما إدراكه لكون ذلك الفعل متعلقا للعقاب فغير مسلم، وغاية ما تدركه العقل: أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله، وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب».
والخلاصة: يرى الشيعة ـ كما قرر الشيخ محمّد تقي الحكيم وغيره ممن سبقه كالشيخ المظفر في أصول الفقه ـ أن العقل مصدر الحجج واليه تنتهي، فهو المرجع الوحيد في أصول الدين وفي بعض الفروع التي لا يمكن للشارع المقدس إلاّ أن يصدر حكمه فيها كأوامر الطاعة... وما ورد من الأوامر الشرعية بالإطاعة فإنما هو إرشاد وتأكيد لحكم العقل لا أنها أوامر تأسيسية. والإدراك العقلي لا يؤدي إلى إنكار الشرائع، بل الاحتياج قائم على أتم صوره، لتدارك ما يعجز العل عن الولوج إليه، وهو أكثر الأحكام، بل كلها مع استثناء القليل.
وفي تقديري أن الاعتماد على العقل ضروري في فهم أحكام التشريع، ولولا الإدراك العقلي لما امكن الاستنباط، والخلاف بين السنة والشيعة محصور في فترة ما قبل البعثة، وأما بعدها فهم متفقون مع غيرهم على أن مصدر جميع التكاليف الشرعية إنّما هو الشرع، وما لم ينص عليه الشرع فهو على الإباحة في رأي الشيعة وغيرهم، ولا تلازم بين الإدراك العقلي وبين الثواب والعقاب، فهذان يحتاجان إلى تكليف من الشارع، ليتحقق في الفعل أو الترك معنى الطاعة أو العصيان.
المصدر: الموقع الإلکتروني لمجمع التقریب بین المذاهب الإسلامیة
تقديم: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمّد نبي الرحمة الذي لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه المهديين الّذين آمنوا به وآزروه ونصروه والتزموا منهجه ودعوته، وبعد:
نحن ـ المسلمين ـ اليوم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء، والعمل المشترك، من أجل قوة الأمة الإسلاميّة، والحفاظ على وجودها وعزتها من أي وقت مضى فكان لزاماً مؤكداً ضرورة تسوية الخلافات التاريخية والمشكلات المعاصرة، والتعريف بالجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلاف بين المذاهب السنية والشيعية سهل يسير، ونقاطه قليلة محصورة، بسبب وحدة المصادر الاستنباطية، والاعتماد أصالة على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كلّ نزاع أو خلاف إليهما، كما في قول الله تعالى. فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إنّ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.
وغني عن البيان أن مبدأ الوحدة الإسلاميّة مقرر مفروض على امتنا في دستورهم المجيد، في مثل الآيتين الكريمتين، الأولى وهي قوله سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأتقون.
وأول من يخاطب بضرورة العمل على توحيد أفكار الأمة المسلمة وطرح كلّ العراقيل والمعوقات أمامها هم العلماء الإثبات الّذين نضجت أفكارهم واختمرت معارفهم وعلومهم وترفعوا عن رعشات التعصب المذهبي، وأدركوا خطر الاستعمار الحريص على تجسيد التفرقة بين السنة والشيعة. وليس المقصود من الوحدة الإسلاميّة بداهة أن يتحول السني إلى شيعي أو بالعكس، لأن نقض الموروث ليس بالأمر الهين، بل لا جدوى من محاولات التغيير.
لذا بادرت إلى بحث موضوع «الأسس والمصادر الاجتهادية المشتركة» لا سهم بواجبي في هذا السبيل العلمي الخصب، لأن جميع المذاهب السنية والشيعية متفقة على ضرورة الاجتهاد وفرضيته في كلّ عصر، عملاً بأصول الأدلة الشرعية، وبعداً عما سمي بإغلاق باب الاجتهاد عند أكثر المتأخرين من علماء السنة بعد نهاية القرن الرابع الهجري تأثراً بظروف سياسية مؤقتة، وتعرضها لتيارات فكرية هدامة، ومحاولة إضعافها من زاوية الاجتهاد، علماء بأن من وراء تلك التيارات لم يكونوا مؤهلين للاجتهاد، وكان لهم غايات خبيثة ومحاولات مسمومة مشبوهة ويتميز الشيعة بأنهم لا يجيزون تقليد المجتهد الميت، بل لابد من كونه حياً حتّى يصح تقليده أو بأذن بتقليد حكم معين.
ومنهجي في البحث: هو إيراد مختلف المصادر الاجتهاد، وكان لهم غايات خبيثة ومحاولات مسمومة مشبوهة. ويتميز الشيعة بأنهم لا يجيزون تقليد المجتهد الميت، بل لابد من كونه حياً حتّى يصح تقليده أو يأذن بتقليد حكم معين.
ومنهجي في البحث: هو إيراد مختلف المصادر الاجتهادية، وتحديد أسسها، وتعريفها، وإيراد أهم دليل لأصحابها إثباتاً أو نفياً، ثم التقريب بين العلماء ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب في كلّ واحد منها.
ولابد أولا أن احدد مصدر التشريع الأصلي المتفق عليه، ثم تبيان المصادر المعتبرة في الاستنباط في ساحة المذاهب الإسلاميّة.
وحدة المصدر التشريعي:
اتفق المسلمون في بحث الحاكم على أن مصدر جميع الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية هو الله سبحانه وتعالى بعد البعثة النبوية وبلوغ الدعوة الإسلاميّة للناس، سواء أكان ذلك بطريق النص من قرآن أو سنة بواسطة الفقهاء والمجتهدين؛ لأن المجتهد مظهر للحكم، وكاشف له، ومبين مراد الله بإصدار الحكم في غالب الظن، أم قطعا ويقينا، وليس المجتهد منشئاً أو واضعاً للحكم من عند نفسه، وبمحض عقله وفكره، لهذا قالوا: الحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع والاقتضاء معناه الطلب، ويشمل طلب الفعل بالإيجاب أو الندب، وطلب الترك بالتحريم أو الكراهة. والتخيير الإباحة وهو استواء الفعل والترك والوضع: خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة.
وقال الأصوليون والفقهاء أيضاً: لا حكم إلاّ لله أخذاً من قوله تعالى: (إنّ الحكم إلاّ لله...)
وأنكر الأستاذ محمّد تقي الحكيم التعريف ـ الذي جاء في القوانين المحكمة ـ للعقل كأحد المصادر بأنه «حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي» قائلاً: والذي يؤخذ على هذا التعريف من وجهة شكلية تعبيره بالحكم العقلي، مع أنّه ليس للعقل أكثر من وظيفة الإدراك، وهو مقصود حتماً، وأظن أن التعبير بالحكم وانتشاره هو الذي أوجب أن يلتبس على بعض الباحثين في أن القائلين باعتبار العقل من الأصول يرونه هو الحاكم في مقابل الله عزّوجل. وقرر بصراحة أن العقل مدرك وليس بحاكم.
مصادر الاستنباط في المذاهب الفقهية:
مصادر الأحكام الشرعية: هي الأدلة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام الشرعية.
ومصادر الاستنباط عند أهل السنة قسمان: مصادر أساسية مستقلة ومصادر فرعية اجتهادية غير مستقلة. أما المصادر الأساسية المستقلة: فهي القرآن الكريم والسنة النبوية للأوامر الإلهية الآمرة بإطاعة الله والرسول، مثل قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله(ص) في حجة الوداع: «تركت فيكم أمرين ما إنّ اعتصمتم بهما، فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه». وفي رواية صحيحة أخرى: «كتاب الله وعترتي».
والمصادر الفرعية: هي الإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح (أو المصالح المرسلة) والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والذرائع والاستصحاب.
ومصادر التشريع عند الزيدية: هي قضايا العقل المبتوتة، والإجماع الثابت بيقين، ونصوص الكتاب والسنة المعلومة، ومفهومات الكتاب والسنة المعلومة، ومفهومات أخبار الآحاد، وأفعال النبي وتقريراته، والقياس والاجتهاد (ومنه الاستحسان وسد الذريعة والمصالح المرسلة) والاستصحاب وهو ما يعرف بالبراءة الأصلية.
ومصادر الاستنباط عند الإمامية أو الجعفرية أربعة: وهي الكتاب العزيز، والسنة، والعقل والإجماع وما عداها فهو راجع إليها في أغلبية صوره.
وبما أن موضوع البحث مقصور على المصادر الاجتهادية المشتركة، فإني أخص بحثي بغير الكتاب والسنة المتفق على كونهما مصدري التشريع الأصليين، ومن العجب وجود الشبه الواضح في ميدان الفقه التفريعي بين الفقه السني والفقه الجعفري والزيدي في كثير من المسائل كما أن مصدر «العقل» عند الشيعة الإمامية وهو التفكر في المصدرين الأصليين المتفق عليهما يمكن أن يدخل تحته كثير من أنواع المصادر الاجتهادية عند أهل السنة، وهذان دليلان واضحان على أنّه في مجال التطبيق والاستنباط يكاد ألا يكون هناك خلاف جوهري في المصادر، وإنّما الخلاف في التسمية والاصطلاح، أو في الكثرة والقلة، أو في الشهرة في استعمال مصدر لدى أئمة مذهب، وانعدام تلك الشهرة في اتجاه إمام آخر، أو أن محل الخلاف أو النزاع غير متفق عليه، كما هو الشأن في الاستحسان على الاستحسان بالهوى والشهوة و محض الرأي من غير دليل شرعي، وهذا ما لا يقول به قطعاً كلا الإمامين: أبي حنيفة ومالك، كما سيأتي بيانه.
ولقد أصاب الشيخ محمّد تقي الحكيم حينما قسم الاجتهاد إلى قسمين: الاجتهاد العقلي، والاجتهاد الشرعي. وهذه القسمة واضحة بالإشارة إلى أن مختلف أئمة الاجتهاد بالرأي المتفق مع مقاصد الشريعة يعتمدون في الاستنباط على كلا القسمين على حد سواء.
أما الاجتهاد العقلي: فهو ما كانت الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي، وينتظم في هذا القسم كلّ ما أفاد العلم الوجداني بمدلوله، كالمستقلات العقلية وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغاً يقينياً، وقبح العقاب بلا بيان وغيرها.
وأما الاجتهاد الشرعي: فهو كلّ ما احتاج لدليل شرعي إلى جعل حجيته من الحجج الشرعية، ويدخل ضمن هذا القسم: الإجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف والاستصحاب وغيرها من مباحث الحجج والأصول العملية التي تكشف عن الحكم الشرعي.
وهذه آراء العلماء في مصادر التشريع الاجتهادية.
1 ـ الإجماع:
الإجماع مصدر من مصادر التشريع، اتفقت المذاهب الإسلاميّة الستة من السنة والشيعة على حجيته، وتعريفه بتعاريف متقاربة.
فتعريفه المعتمد عند جمهور أهل السنة هو: «اتفاق المجتهدين من أمة محمّد(ص) بعدوفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي» وهذا التعريف يتطلب اتفاق جميع مجتهدي الأمة من سنة وشيعة في عصر من العصور على حكم شرعي. واستدلوا على حجيته بأدلة من القرآن والسنة، وأقوى الأدلة: ما ثبت في السنة المتواترة تواتراً معنوياً وهو ورود أحاديث ثابتة بألفاظ مختلفة تثبت عصمة الأمة من الخطأ، منها: « لا تجتمع أمتي على الخطأ» ومنها: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ولابد للإجماع من مستند عند الجمهور، والمستند: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه. ويصلح المستند أن يكون نصاً أو قياساً؛ لأن الإفتاء بدون مستند خطأ، لأنه يعتبر قولاً في الدين بغير علم، وهو منهي عنه بقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم...).
وفائدة الإجماع مع وجود المستند: إنّ كان المستند قطعياً فهو التأكيد، وإن كان ظنياً فهو رفع مرتبة الحكم من الظن إلى القطع واليقين.
وقد وقعت إجماعات كثيرة من الصحابة وغيرهم إذا كان المستند نصاً شرعياً، مثل الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث، وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه، وعلى بطلان زواج المسلمة بالكافر، وعلى حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج، وعلى وجوب العدة بموت الزوج ونحو ذلك، وكذلك إذا كان المستند قياساً مثل تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه.
أما الإجماع الاجتهادي المحض: فلا نكاد نجد له مثالاً سوى شركة المضاربة، فقد أجمع العلماء على جوازها، وليس هناك نص صريح عليها، كلّ ما في الأمر أن الناس تعاملوا بها في عهد النبي(ص)، فأقرهم عليها، ولم ينكرها عليهم، وربما كان هذا سنة تقريرية عند المتمسكين بالنص. وهي مشروعة عند الإمامية بنص من الإمام الصادق(ع).
وعرف الشيعة الإمامية الإجماع بأنه: «اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي» أي فلا يشترط اتفاق جميع العلماء، وهم يقولون: إنّ الإجماع حجة، لا لكونه إجماعاً، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده عندهم حجة، لأنه رأس الأمة ورئيسها، لا لكونه إجماعاً، وغير المعصومين لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم على المخالفة، فالحجية عندهم منوطة بإجماع الأمة. وإذا كانوا يرون أن الإمام المعصوم غير موجود الآن، فلا يحدث إجماع أصلا بدونه. والأئمة المعصومون أثنا عشر إماماً، وأنهم لا يخطئون في اجتهادهم. ولا يصلح القياس عندهم مستندا للإجماع.
ويرى الشيعة الإمامية والزيدية: أن إجماع العترة حجة، وأرادوا بالعترة أصحاب الكساء وهم السادة علي وزوجه فاطمة، وابناهما الحسن والحسين(ع)، وهم معصومون منزهون عن الخطأ في الاجتهاد، ولا تعترف الزيدية بالعصمة لغير هؤلاء من أئمة آل بيت رسول الله(ص)، خلافاً للشيعة الإمامية الّذين يقولون ـ كما تقدم ـ بعصمة الأئمة الأثني عشر جميعهم.
ويلاحظ أن أهل السنة: يعتبرون الإجماع حجة قائمة بذاتها، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة مباشرة في ترتيب الأدلة الشرعية.
ويرى الشيعة الإمامية أن حجية الإجماع بسبب حكايته عن الكتاب والسنة، بحيث يكشف عنهما أو عن أحدهما، وإلا فلا حجة له.
أما الزيدية: فيرون أن الإجماع المتواتر له قوة الأحاديث المتواترة، وهو الإجماع الثابت بيقين، ومقدم على نصوص الكتاب والسنة وظواهرها ومفهوماتها المعلومة.
ويقول الشيعة الإمامية: إنّ الإجماع لم يقع، وهو غير ممكن، والمراد بحديث «لا تجتمع أمتي على الخطأ أو على الضلالة» نفي الخطأ والضلال عن الأمر تقرره الأمة باتفاقها واجتماع آرائها في أمر دنيوي وغيره، فضلاً عن أنّه ليس بمتواتر تواتراً معنويا، ولا تقصر الأمة على المجتهدين وأهل الحل والعقد فيها، وإنّما تشمل جميع الأفراد.
وبه يتبين أن جميع المذاهب الستة متفقة على اعتبار الإجماع حجة، ولكن حجيته تتفاوت قوة وضعفا لدى هذه المذاهب نتيجة اجتهادهم في الفهم والاستنباط.
2 ـ العقل:
العقل المحض لا يعتبر مصدراً من مصادر التشريع أو الاستنباط عند فقهاء الشريعة الإسلاميّة بالاتفاق؛ لأنه لا يحقق العدالة المجردة، ولا المصلحة العامة الثابتة، ولا الاستقرار المنشود، بسب تفاوت العقول البشرية في إدراك الأمور، واختلافها في مقاييس الخير والشر، وقصور إدراكها لحقائق الأشياء، واكتشاف آفاق المستقبل، وتأثرها بالمصالح الذاتية واندفاعها وراء الأهواء والشهوات، وحماية الثروات الخاصة والفئات المعينة.
حتّى إنّ المعتزلة الّذين يقولون: يصلح العقل لإدراك حسن الأشياء كالصدق والمروءة فتكون مأموراً بها، وادراك قبحها كالكذب والقتل، فتكون منهيا عنها، يقولون: إنّ هذا قبل البعثة النبوية، وإن العقل لا ينشئ هذه الأحكام ولا يضعها، وإنّما المنشئ لها هو الله رب العالمين، وحكم العقل مقصور على معرفة حكم الله تعالى في هذه الأشياء بواسطة إدراك صفات الحسن والقبح الذاتية فإذا أدرك ما فيها من حسن، أدرك حكم الله فيها، فيتعين عليه تركها ولا يتعدى عمل العقل معرفة الحكم وإدراكه، أما واضع الحكم ذاته ومشئه فهو الله رب العالمين.
ويقتصر دور المجتهدين باتفاق المذاهب الإسلاميّة على مجرد كشف الأحكام وإظهارها، بتفهم النصوص وتطبيقها والقياس عليها عند القائلين به، والاجتهاد في استخراج الأحكام منها، وليس فيه وضع للأحكام من عند أنفسهم، أو إنشاء لها بواسطة عقولهم وأفكارهم؛ لأنهم يستندون إلى الكتاب والسنة في كشف هذه الأحكام وبيانها، ولا يعتمدون على غيرها بتاتاً، سواء أكان الاجتهاد جماعياً أم فردياً.
فسلطة التشريع في الإسلام هي لله رب العالمين، وللرسول(ص)، باعتبار أنّه رسول ومبلغ وحي الله إلى سائر الناس.
والغزالي في مبحث دليل العقل والاستصحاب وهو الأصل الرابع لديه يعتبره دليلا على إدراك بعض الأحكام قبل البعثة، لا دليلاً على الحكم الشرعي ذاته، فيقول:
«دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل(ع)، وتأييدهم بالمعجزات، وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع». أي أن العقل يرشد إلى البراءة ويدل عليها، لا أنّه يقررها ويحكم بها.
والشيعة الإمامية والمعتزلة كالغزالي يعتبرون العقل مدركا وليس بحاكم، فهم كغيرهم من المسلمين ـ كما تقدم ـ يرون أن لا حكم إلاّ من الله تعالى، وهذا مقرر بإجماع الأمة، إلاّ أنهم يذكرون أن العقل إذا أدرك قبل البعثة حسن شيء أو قبحه، فينبغي على المرء أن يفعل الحسن ويترك القبيح، كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة، والعدل والإنصاف، وحسن الدق النافع، وقبح الظلم وحرمته، وقبح الكذب مع عدم الضرورة، وحسن الإحسان واستحبابه، فالعق ليستقل بإدراك الحسن والقبح. والمراد بالحسن هنا: هو ما يترتب على فعله المدح في الدنيا، والثواب في الآخرة، والمراد بالقبيح: ما يترتب على فعله الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. ولا يتوقف إدراك ذلك على الشرع، والشرع فقط مؤكد لحكم العقل فيما يعلمه من حكم الله تعالى وإذا أدرك الإنسان الحسن والقبح بهذا المعنى فيكلف به فعلاً أو تركا، ويترتب على ذلك الثواب أو العقاب في مخالفة ما أدركه العقل. فالحاكم حقيقة هو الشرع إجمالا، ولكن العقل في رأيهم كاف في معرفة حكم الشرع.
والأشاعرة يخالفونهم في هذا الكلام بشقيه ك الإدراك والتكليف، لا،ه لو لم يكن الحسن والقبح في الأفعال بحكم الشارع نفسه، وكان بحكم العقل، لا ستحق تارك الحسن وفاعل القبح قبل بعثة الرسل العقاب، وهذا مخالف لصريح الكتاب في قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتّى نبعث رسولا) وقوله سبحانه: (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى.
وأجاب الشيعة عن هذا الدليل بأن العقل ـ وأن كانت له وظيفة الإدراك ـ إلاّ أن إدراكه محدد بحدود خاصة لا تتجاوز الكليات، فالإدراك منحصر في الكليات ولا يتناول الأمور الجزئية، كما لا يتناول مجالات التطبيق إلاّ نادراً، والكليات لا تستوعب شريعة ولا تفي بحاجات البشر. بل إنّ ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شعري لا ستحال ثبوتها. وقال الشوكاني: «وبالجملة، فالكلام في هذا البحث طويل، وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو قبيحاً مكابرة ومباهتة. وأما إدراكه لكون ذلك الفعل متعلقا للعقاب فغير مسلم، وغاية ما تدركه العقل: أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله، وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب».
والخلاصة: يرى الشيعة ـ كما قرر الشيخ محمّد تقي الحكيم وغيره ممن سبقه كالشيخ المظفر في أصول الفقه ـ أن العقل مصدر الحجج واليه تنتهي، فهو المرجع الوحيد في أصول الدين وفي بعض الفروع التي لا يمكن للشارع المقدس إلاّ أن يصدر حكمه فيها كأوامر الطاعة... وما ورد من الأوامر الشرعية بالإطاعة فإنما هو إرشاد وتأكيد لحكم العقل لا أنها أوامر تأسيسية. والإدراك العقلي لا يؤدي إلى إنكار الشرائع، بل الاحتياج قائم على أتم صوره، لتدارك ما يعجز العل عن الولوج إليه، وهو أكثر الأحكام، بل كلها مع استثناء القليل.
وفي تقديري أن الاعتماد على العقل ضروري في فهم أحكام التشريع، ولولا الإدراك العقلي لما امكن الاستنباط، والخلاف بين السنة والشيعة محصور في فترة ما قبل البعثة، وأما بعدها فهم متفقون مع غيرهم على أن مصدر جميع التكاليف الشرعية إنّما هو الشرع، وما لم ينص عليه الشرع فهو على الإباحة في رأي الشيعة وغيرهم، ولا تلازم بين الإدراك العقلي وبين الثواب والعقاب، فهذان يحتاجان إلى تكليف من الشارع، ليتحقق في الفعل أو الترك معنى الطاعة أو العصيان.
المصدر: الموقع الإلکتروني لمجمع التقریب بین المذاهب الإسلامیة