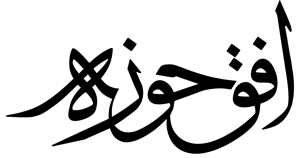

□ مقالة/ الجزء الأول
الخطابُ الديني والوظيفة الاجتماعية
▪ تقويم الخطاب الديني
الخطابُ الديني جزءٌ لا يتجزأ من حياة مجتمعاتنا الإسلامية، وهو ركن في بعضِ العبادات الدينية، كما هو الحال في صلاة الجمعة وصلاة العيدين الواجبتين، فالخطبة واجبة وجزءٌ من الصلاة فيهما. كما أن الحث على دعوة الناس إلى الخير، وإرشادهم إلى الحق، وهدايتهم إلى الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء أمر أهل البيت، كلُّها مفاهيم توجِب وجودَ خطابٍ ديني في المجتمع الإسلامي.
وللخطاب الديني مساحةٌ لا تُنكر من التأثير، فهو جزءٌ من الشأن العام، لذا ينبغي أن يهتم به كلُّ أفراد المجتمع، تماماً كما يهتمون بسائر الشؤون المرتبطة بحياتهم، وينبغي أن يكون لهم رأيٌ وموقفٌ فيه وتجاهه سلباً أو إيجاباً، فليس صحيحاً أن يقال: أن الاهتمام بالخطاب الديني ينحصر في دائرة منتجيه، وبقية الناس لا شأن لهم به، وليس من حقّهم أن يبدوا رأياً تجاهه، بل على العكسِ من ذلك، ما دامَ الخطاب من قضايا الشأن العام، ويؤثر في حياة الناس، فمن واجب الناس ومن حقهم أن يهتموا بهذا الخطاب.
ولو رجعنا إلى واقع الحياة الاجتماعية سابقًا، نجد أن عامة الناس تهمهم حياتهم الخاصة، ولا يرون أنفسهم معنيين بالشأن العام، عدا فئة خاصة من كبار المجتمع وزعامته، فإنهم يرون أنفسهم المعنيين بذلك، أمّا الآن فقد تغيّر الواقع الاجتماعي، وأصبحنا نرى أنّ الاهتمام بالشأن العام اتسعت رقعته في المجتمعات، بسبب ارتفاع مستوى التعليم، وانتشار المعرفة، وزيادة ثقة الناس بأنفسهم، وقدرتهم على التعبير عن آرائهم، عبر وسائل الأعلام والتواصل الحديثة، التي أتاحت لكلّ إنسان أن يعبّر عن رأيه وينشره في أوسع نطاق، وهذا يعني أنّه من الطبيعي حصول حالة النقد والتقويم للخطابِ الديني.
إضافةً لذلك: هناك قِوىً وتياراتٌ مخالفة للاتجاه الديني، تترصد ما تراهُ أخطاءً وثغراتٍ في الخطاب الديني، وتبثها في المجتمع، من أجل إضعاف تأثيره وإضعاف ثقة الناس به، وهذا أمرٌ طبيعي في ساحات الصراع والمنافسة بين التوجهات والتيارات.
وأساسًا فإن الخطاب الديني أداءٌ بشري في مضمونه وأسلوبه، وما دام كذلك فهو غير معصوم عن الخطأ والضعف، لأن العصمة محصورةٌ في القرآن الكريم، والنص الثابت عن المعصوم، أمّا مَن ينتج الخطاب الديني فهو يجتهد، وحسب اجتهاده ورأيه يتحدث ويخطُب ويكتُب، وكل أداءه بشري مُعرّض للنقص والخطأ، لذلك يُخطّئ العلماء بعضهم بعضاً في مختلف المسائل العَقدية والفقهية. ومن الأمثلة على ذلك نجد ان الشيخ المفيد رأى عدم صحة رأي الشيخ الصدوق في ثلاث وأربعين مسألة عقدية، ذكرها في كتابه «الاعتقاد»، فكتب المفيد كتابًا بعنوان «تصحيح الاعتقاد»، ونجد ذلك أيضاً في تعليقات الفقهاء على كتب الفتاوى الفقهية، ككتاب «العروة الوثقى» وهي فتاوى السيد محمد كاظم اليزدي، حيث يسجل كل فقيه في حاشيته على الكتاب موارد مخالفته لآراء السيد اليزدي، بمعنى عدم تصويبه لتلك الآراء، وان كان كل فقيه معذورًا فيما يذهب إليه، انطلاقًا من مشروعية الاجتهاد. بل قد يكتشف الفقيه أنه كان مخطئًا في رأيه العقدي أو الفقهي فيعدل عنه الى رأي جديد.
من جهةٍ أخرى، وبعيداً عن مسألة الخطأ والصواب، فإن الخطاب الديني بحاجةٍ الى التطوير ومواكبة التغيرات الثقافية والاجتماعية، خصوصاً مع تطوّر الحياة وتقدُّم العلم، وبالنقد والتقويم يحصل التطوير والتغيير، فقد يكون خطاب ديني صحيحًا ومناسبًا في وقتٍ من الأوقات وزمنٍ من الأزمنة، إلا أنه قد لا يكونُ كذلك في زمنٍ آخر، نظرًا لحصول تطوّر وتغيير في الواقع الاجتماعي.
ويشير الشيخ مرتضى مطهري إلى ملاحظة مهمة إذ يقول في أحدِ كتُبِه: (قد يكون شيء ما وسيلة للهداية، ثم قد يصبح الشيء نفسه في مكان آخر وسيلة للضلالة والضياع. إن المنطق الذي جعل امرأة مؤمنة، قد يُضلّ المثقف، وربّ كتاب متناسق مع ذوق عصر من العصور، ومنسجم مع مستواه الفكري، كان وسيلة في حينه لهداية الناس، ثم كان في وقت آخر سبباً لضلالهم، لدينا كتب سبق لها أن أدَّت وظيفتها في الماضي، وأرشدت إلى سبيل الهداية آلاف الناس. إلا أن هذه الكتب نفسها فضلاً عن كونها لم تعد تهدي أحداً، فإنها أصبحت سبباً لضلال عدد من الناس وشكهم وحيرتهم).
لذا ينبغي أن يكون هناك تقويم ومراجعة للخطاب الديني، وهذا ما ينسجم مع تعاليم وتوجيهات الدين، التي تحثنا على النقد الذاتي والمحاسبة في مختلف المجالات، من أجل الارتقاء إلى الأفضل، ففي الرواية الواردة عن الإمام جعفر الصادق: «مَنِ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ خَيْرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَمَنْ لَمْ يَرَ اَلزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى اَلنُّقْصَانِ، وَمَنْ كَانَ إِلَى اَلنُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ اَلْحَيَاةِ».
▪ لماذا يرفضون النقد والتقويم؟
نرى في بعض أوساط المتدينين مَن يزعجهم النقد والتقويم لكل ما يرتبط بالخطاب الديني، أو أي شأن من الشؤون الدينية، وكأن كل شيء فيها من الثوابت والمقدسات.
فنجد على سبيل المثال: أنَّ أحد العلماء يحذّر من نقد أي شيء يتعلق بالمجالس الحسينية، ويؤيد قوله بنقل قصةٍ عن الأثر الخطير لذلك في الآخرة، مفادها: أنّ إنسانًا مؤمنًا حضر مجلسًا حسينيًا، ولما خرج من المجلس انتقد شيئًا مما دار في المجلس، وفي الليل رأى كأنّ القيامة قد قامت، وكان هو من المؤهلين لدخول الجنة، وحين نظر الملائكة في صحيفته تركوه آخر الناس، ولم يسمحوا له بالدخول إلى الجنة إلا بعد انتظار طويل. وقالوا له: هذا بسبب نقدك لشيءٍ في المجلس الحسيني!!، إن هذا التحذير فيه مبالغة شديدة، كما أن الاستدلال بأطيافٍ وأحلامٍ منقولةٍ ليس منهجية علمية موضوعية.
وقد يكون التخوّف من نقد الخطاب الديني راجعًا إلى احتمال أنه يتم بتحريضٍ من الأعداء، الذين يتّخذون النقد وسيلةً لإضعاف الدين، ولا ننكر وجود أعداءٍ يسعون بمختلف الطرق لإضعاف الدين، وإضعاف ثقة الناس بالمؤسسة الدينية، ولكن مع ذلك لا يمكن منع النقد والتقويم، وانما ينبغي أن نتعامل معه تعاملاً إيجابياً مهما كانت جهتهُ ومصدرُه، وذلك بسدِ الثغراتِ والأخطاء في الخطاب والممارسات الدينية، وكشف المغالطات الموجودة في مقولات الناقدين.
كما أنه لا يصح اتهام كل ناقد بأنه ينطلق من خلفية عدائية، فهناك ناقدون من داخل الوسط الديني، ينطلقون من دافع الحرص على سمعة الدين، والإخلاص للحقيقة والمعرفة.
وجديرٌ بالذكر استحضار ما جاء في خطبةٍ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يحثُ فيها من حوله على النقد والتقويم تجاه سياساته ومواقفه، يقول: «فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، وَلَا تَظُنُّوا بِيَ اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، وَلَا الِتمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَو الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فلا تكفوا عن مقولةٍ بحق».
ونستنتج من ذلك: أنَّ على المتدينين ليس فقط أنْ لا يرفضوا النقد، وإنما أنْ يبادروا إلى النقد الذاتي، وتقويم الخطاب الديني، في كل مناسبة وكل موسم، وأن يشجعوا من حولهم على ممارسته والترحيب به، كما جاء في كلام الإمام علي.
ونستحضر هنا بعض المبادرات النقدية الجريئة التي قام بها علماء أجلاء لهم مكانتهم في الساحة الشيعية، ومنهم:
المحدث الشيخ حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل، والذي ألّف كتابًا بعنوان (اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر) سلط فيه الأضواء على الممارسات الخطابية الرائجة المخالفة للضوابط الشرعية، وفنّد كل مبرراتها الزائفة.
السيد محسن الأمين في كتابه (المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية)، وهو من عدة أجزاء، ويسجل السيد الأمين في مقدمة هذا الكتاب نقدًا شديداً لخطابة كثير من الذاكرين في مناسبات أهل البيت ويصفها أنها مخالفة لنهج أهل البيت وتعاليمهم.
الشيخ محمد جواد مغنية الذي قدّم نقداً لكثيرٍ من مجالات الحالة الدينية، والخطاب الديني، في عددٍ من مؤلفاته وكتاباته.
الشيخ مرتضى مُطهّري نجد في عددٍ من كتبه نقدًا مفصّلًا للمؤسسة الدينية، وقد طبعت محاضراته النقدية حول ما يطرحه الخطباء من السيرة الحسينية في ثلاثة مجلدات بعنوان (الملحمة الحسينية)، وله كتابات في نقد بعض أوضاع الحوزات العلمية، وممارسات المنتمين إلى سلكها، مثل: (إحياء الفكر الديني في الإسلام، نقد الفكر الديني، محاضرات في الدين والاجتماع).
الشهيد السيد محمد باقر الصدر الذي نقد الرسائل العملية للفقهاء، ورأى أنَّ الأسلوب المتداول فيها لم يعد يناسب لغة العصر، وثقافة الناس المكلّفين، فعرض رأيه صريحًا في مقدمة رسالته (الفتاوى الواضحة)، وله أيضاً نقد عميق تجاه مناهج الحوزة العلمية ودروسها، كتبه في مقدمات حلقاته في علم الأصول، كما انتقد أسلوب تعامل الحوزة العلمية مع المجتمع في محاضرات سجلها في آخر أيام حياته، وصدرت في كتاب بعنوان (المحنة).
وهكذا سائر العلماء الذين بادروا إلى نقد الخطاب الديني كلٌّ في مجاله، وضمن الزاوية التي نظر اليها.
ولا يعني ذلك أنّ كلَّ رأيٍ من الآراء الناقدة صحيح بالمطلق، فآراء هؤلاء العلماء تقبل النقاش، والمجال مفتوح للبحث، والمبادرات قائمة. وخلاصة القول إن النقد والتقويم للخطاب الديني مشروعٌ ومفيدٌ للحالة الدينية.
ونُشيد هنا ببيان المرجعية الدينية العُليا لسماحة السيد علي السيستاني "حفظه الله" الذي صدر بمناسبة قرب حلول شهر المحرم 1441ه كوصايا للخطباء والمبلّغين، تضمنت اثني عشر حكمة، فيها توجيهات مهمة وملاحظات دقيقة، تعالج بعض ثغرات الخطاب الديني المعاصر، ومن اهم نقاط الضعف التي عالجها هذا البيان المهم، وسلط عليها الأضواء، ما ننقله من النص الصادر من مكتب سماحته فقد جاء في الحكمة السادسة:
(تجنّب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام بالحفاظ على وحدتهم وتآزرهم والتوادّ بينهم. ومن وجوه ذلك تجنّب التركيز على جهات التمايز بينهم مثل اختلافهم في التقليد، وفيما يختلف المجتهدون فيه من تفاصيل بعض المعتقدات، بل كلّ خلاف بينهم لا يخرِج بعضهم عن التمسّك بالكتاب والعترة، حتّى لو نشأ عن الاختلاف في درجات إيمانهم أو بصيرتهم، أو التزامهم أو رشدهم، بل حتّى لو كان عن زلّة صادرة من بعضهم.
ولا ينبغي إشهار الزلّة والتشهير بصاحبها فإنّ في ذلك ما يؤدّي إلى مزيد اشتهارها، وإلى إصرار صاحبها ومن قد يتأثّر به عليها، ويوجب وهن الحقيقة التي يُراد الحفاظ عليها فضلاً عن عدم جواز التشهير بالمؤمن وتسقيطه بزلّة صدرت منه لا سيّما فيما أوحى ذلك بعدم تقدير سائر خصائصه ومزاياه، ورُبّ زلّة خمدت بالسكوت عنها وترك ذكرها، واتّقدت ببيانها والحديث عنها، ورُبّ صمت عن شيء خير من كلام.
بل ينبغي تجنّب ما يثير الفرقة بين المسلمين ويوجب الضغينة وسوء الظنّ فيما بينهم، فإنّ ذلك خلاف تعاليمهم وسيرتهم حيث كانوا(ص) يحرصون فيها على حسن التعامل مع الآخر وعدم إبراز الاختلاف على وجه يوجب وهن الإسلام أو تشويه الحقّ، حتّى وردت التوصية بالصلاة معهم والكفّ عنهم وحضور مجالسهم وتشييع جنائزهم، وذلك أمر مؤكّد وواضح في التاريخ بالنظر إلى أحاديثهم وسيرتهم، ومن ثَمّ كانوا(ع) موضع احترام الآخرين وثنائهم بل اهتمّوا بالتعلّم منهم والتفقّه لديهم).
ومما جاء في الحكمة السابعة: (تجنّب القول بغير علم وبصيرة، فإنّ ذلك محرّم في الدين أيّاً كان مضمون القول، كما قال تعالى: [وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا] [سورة الإسراء، الآية: 36]، وليس في حسن قصد المرء وسلامة غايته ما يبيح ذلك، كما لا يقيه من محاذير ذلك ومضاعفاته.
وليحذر المرء من الابتداع والبدع، وهي إضافة شيء إلى الدين ليس منه ولا حجّةً موثوقةً عليه فيه، فإنّ الابتداع في الدين من أضرّ وجوه الضلالة فيه، وهي تؤدّي إلى تشعّب الدين إلى عقائد متعدّدة وانقسام أهله إلى فرق وأحزاب مختلفة ومتقاطعة كما نشهده في كثير من الأديان والمذاهب، وقد جاء عن النبيّ(ص) التحذير من البدعة وأنّ شرّ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار.
ومن القول بغير علم وبصيرة المبالغة في الشيء والتجاوز به عن حدّه، كأن يجعل الأمر النظريّ المتوقّف على الاجتهاد واضحاً وبديهيّاً، أو يجعل الأمر المختلف فيه بين وجوه أهل العلم متّفقاً عليه بينهم تصريحاً أو تلويحاً وينزّله منزلته، أو يجعل المظنون مقطوعاً، أو يجعل المحتمل مظنوناً، أو يجعل بعض الوظائف الشرعيّة فوق درجاتها فيبلغ بالمستحبّ درجة الواجب من غير عنوان ثانويّ واجب ينطبق عليه وبالواجب من غير الدعائم درجة دعائم الدين أو يعكس ذلك، فإنّ ذلك كلّه أمر غير مقبول شرعاً.
وجاء في الحكمة الثامنة: (ليحذر المبلّغون والشعراء والرواديد أشدّ الحذر عن بيان الحقّ بما يوهم الغلوّ في شأن النبيّ وعترته(ص)، والغلوّ على نوعين: إسباغ الصفات الألوهيّة على غير الله سبحانه، وإثبات أمور ومعانٍ لم تقم حجّة موثوقة عليها، ومذهب أهل البيت(ع) خالٍ عن الغلوّ بنوعيه، بل هو أبعد ما يكون عنه، وإنّما يشتمل على الإذعان للنبيّ وعترته (صلوات الله عليهم) بمواضعهم التي وضعهم الله تعالى فيها من دون زيادة ولا إفراط، بل مع تحذّر في مواضع الاشتباه، وورعٍ عن إثبات ما لم تقم به الحجّة الموثوقة).
▪ معاييرُ النقد والتقويم
لا بُدّ للنقد والتقويم من معايير موضوعية صحيحة، فهناك من يستخدم التهريج والتجريح والألفاظ المسيئة في نقده لآراء الآخرين، أو يعمّم الأخطاء، وهذا أسلوب خطأ، يضر ولا ينفع، ويُفقد صاحبه المصداقية، وقد يُظن بصاحب هذا الأسلوب أنَّه يريد إلفات الناس إلى ذاته، أو تصفية حسابات مع هذه الجهة أو تلك، ويُشغل الناس بقضايا جانبية هامشية، ويُشوّه عملية الإصلاح والتطوير، فالنقد بهذه الكيفية ليس في محلّه ولا يُعدُّ أسلوباً سليماً.
من الجانب الآخر هناك تقويم ونقد على أساس علمي، ينطلق من حالة فكرية علمية، فكل إنسان لديه فكر ومعرفة فيما يحدث حوله، من حقه أن ينتقد ويُقوّم.
ومهم جداً في مسألة التقويم أن نلتفت إلى مسألة الاتفاق على المرجعية الفكرية، إذ حين تختلف المرجعية، من الطبيعي أن تختلف الآراء والمواقف، فكل اتجاه له مرجعيته الفكرية، فإذا جاء شخص من خارج الفضاء الديني يريد أن يحاكم الخطاب الديني وفق مرجعيته العلمانية مثلاً، فهذا خطأ، لأنّ محاكمة الخطاب لا بُدّ أن تنطلق من المرجعية التي يقبلها، أو من خلال المبادئ العقلية والإنسانية العامة المتفق عليها، دون فرض مرجعية وقناعة أُخرى على الخطاب الديني.
انعكاسات الخطاب الديني ومخرجاته الاجتماعية
إن من أهم مناهج النقدِ والتقويم لأي خطاب، قراءة المخرجات والنتائج، وملاحظة انعكاس الخطاب على المجتمع سلباً وإيجاباً. فمثلاً: حين نجد أنّ الخطاب الديني ساهم في انتاج مجتمعٍ متقدمٍ متحضّرٍ، فهذا يدل على سلامة ورقي هذا الخطاب، بينما حين نجد أنَّ النتيجة كانت تكريس واقعٍ متخلّفٍ ووضعٍ سيء، هنا لا يُمكن أن نحكم بصوابية ذلك النهج من الخطاب. فعلى أساس النتائج والانعكاسات التي صنعها الخطاب في المجتمع يكون النقد والتقويم.
وحين ننظر إلى الواقع الاجتماعي في عالمنا الإسلامي، نجد واقعاً ليس إيجابيًا، فيه ظواهر سلبية خطيرة، ومن أبرزها:
أولاً: عدم رسوخ القيم الأساس للدين في نفوس أبناء المجتمع، وغياب الالتزام بها في سلوكهم، كقيمة الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وضعف الالتزام بالأخلاق الفاضلة كالصدق والأمانة، ومراعاة النظام، فهذه القيم غير راسخة في النفوس، وغير منعكسة على السلوك في مساحة واسعة من هذه المجتمعات.
ثانياً: ضعف الاهتمام العلمي والثقافي، وغياب الإبداع في علوم الطبيعة والحياة، فالعالَم يتقدَّم كل يوم في مختلف مجالات العلوم، ومساهمة مجتمعاتنا الإسلامية في هذا التقدم العلمي لا تكاد تذكر، وحين نُسلّط الضوء على بعض المبادرات العالمية للإشادة بالمبدعين والمتميزين في إنتاجهم العلمي، مثل جائزة الملك فيصل العالمية، نجد أنه قد فاز بالجائزة في مجال العلوم المختلفة حتى 2019م، 59 عالماً من 14 جنسيّة، وليس فيهم من يحمل جنسية بلد إسلامي، عدا الفائزين في مجال الأدب وخدمة الإسلام.
نعم نجد في المسلمين من حصل على جائزة نوبل لكنهم يعدّون على الأصابع، ولا يُقاسون عددًا بمن فازوا بالجائزة من اليهود والمسيحيين والديانات الأخرى، فلماذا نجد ضعف الاهتمام العلمي، والإبداع المعرفي في مجتمعاتنا الإسلامية؟
ثالثاً: انخفاض مستوى الفاعلية والإنتاج ومستوى جودة الحياة، كالإنتاج الصناعي والزراعي والتكنولوجي، وفي مختلف المجالات. وقد أصبح لجودة الحياة معايير ومقاييس عالمية فيما يرتبط بالخدمات الصحية، وفرص التعليم، والعمل، والأمن الاجتماعي، والتخطيط العمراني، والحوكمة والشفافية، ومجالات الترفيه.. وتتنافس الدول والمجتمعات الأخرى على تحقيق أعلى الدرجات فيها، بينما لا تزال معظم مجتمعاتنا الإسلامية تحتل أدنى المراتب في المؤشرات والتقارير الدولية لجودة الحياة.
رابعاً: ضعف المشاركة والاقبال على العمل التطوعي الإنساني، في مقابل الإقبال الأكثر على الأعمال الدينية، كبناء المساجد والحسينيات، وأداء الحج والعمرة، وزيارة العتبات المقدسة، وحضور المآتم وإقامة الشعائر، وهي أعمالٌ حسنة مرضيّة عند الله تعالى، إلا أننا نتطلع لمثل هذا الإقبال والتفاعل مع الجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية، ولجان الاهتمام بالبيئة، وبذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز البحث العلمي والإبداع الفني، فالإقبال على هذه المجالات ضعيفٌ جداً مقارنةً بالمجتمعات الأخرى، حيث تشير مثلاً الإحصائية التي صدرت قبل سنوات قليلة في المملكة العربية السعودية عن العمل التطوعي، إلى أن عدد المسجلين رسميًا كمتطوعين في المملكة لا يتجاوز 23 ألفًا فقط في وطن تعداد سكانه يقارب الثلاثين مليوناً!!، وهناك الآن تطلع لرفع عدد المتطوعين على مستوى المملكة إلى مليون متطوع بحلول سنة 2030م في سياق الرؤية المعتمدة.
خامساً: كثرة الخلافات والنزاعات في المجتمعات الإسلامية وخاصةً في الأوساط الدينية، حتى أن البعض يستخدم الخطاب الديني والأمور العبادية في إذكاء حالة الصراع والخلاف، ومما يُنقل في التاريخ الماضي: أنه حصل نزاعٌ بين قريتين، فأوقف أحدهم مزرعة نخيل من أجل استخدام (جريد النخل) في النزاع قربة الى الله تعالى؛ وكأنّ النزاع والصراع في بعض الأوساط جزء من الحالة الدينية والأعمال العبادية التي يتقرب بها إلى الله تعالى.
هذه بعضُ الظواهر الموجودة في معظم مجتمعاتنا الإسلامية، على سبيل المثال لا الحصر، وقد تجد من يُقوّم الخطاب الديني من خلال هذا الواقع الاجتماعي.
المصدر: مجلة الاجتهاد والتجدید، العددان التاسع والخمسون والستون
السنة الخامسة عشر، صيف 2021م، 1442ه، وخريف 2021م، 1443ه.
الخطابُ الديني جزءٌ لا يتجزأ من حياة مجتمعاتنا الإسلامية، وهو ركن في بعضِ العبادات الدينية، كما هو الحال في صلاة الجمعة وصلاة العيدين الواجبتين، فالخطبة واجبة وجزءٌ من الصلاة فيهما. كما أن الحث على دعوة الناس إلى الخير، وإرشادهم إلى الحق، وهدايتهم إلى الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء أمر أهل البيت، كلُّها مفاهيم توجِب وجودَ خطابٍ ديني في المجتمع الإسلامي.
وللخطاب الديني مساحةٌ لا تُنكر من التأثير، فهو جزءٌ من الشأن العام، لذا ينبغي أن يهتم به كلُّ أفراد المجتمع، تماماً كما يهتمون بسائر الشؤون المرتبطة بحياتهم، وينبغي أن يكون لهم رأيٌ وموقفٌ فيه وتجاهه سلباً أو إيجاباً، فليس صحيحاً أن يقال: أن الاهتمام بالخطاب الديني ينحصر في دائرة منتجيه، وبقية الناس لا شأن لهم به، وليس من حقّهم أن يبدوا رأياً تجاهه، بل على العكسِ من ذلك، ما دامَ الخطاب من قضايا الشأن العام، ويؤثر في حياة الناس، فمن واجب الناس ومن حقهم أن يهتموا بهذا الخطاب.
ولو رجعنا إلى واقع الحياة الاجتماعية سابقًا، نجد أن عامة الناس تهمهم حياتهم الخاصة، ولا يرون أنفسهم معنيين بالشأن العام، عدا فئة خاصة من كبار المجتمع وزعامته، فإنهم يرون أنفسهم المعنيين بذلك، أمّا الآن فقد تغيّر الواقع الاجتماعي، وأصبحنا نرى أنّ الاهتمام بالشأن العام اتسعت رقعته في المجتمعات، بسبب ارتفاع مستوى التعليم، وانتشار المعرفة، وزيادة ثقة الناس بأنفسهم، وقدرتهم على التعبير عن آرائهم، عبر وسائل الأعلام والتواصل الحديثة، التي أتاحت لكلّ إنسان أن يعبّر عن رأيه وينشره في أوسع نطاق، وهذا يعني أنّه من الطبيعي حصول حالة النقد والتقويم للخطابِ الديني.
إضافةً لذلك: هناك قِوىً وتياراتٌ مخالفة للاتجاه الديني، تترصد ما تراهُ أخطاءً وثغراتٍ في الخطاب الديني، وتبثها في المجتمع، من أجل إضعاف تأثيره وإضعاف ثقة الناس به، وهذا أمرٌ طبيعي في ساحات الصراع والمنافسة بين التوجهات والتيارات.
وأساسًا فإن الخطاب الديني أداءٌ بشري في مضمونه وأسلوبه، وما دام كذلك فهو غير معصوم عن الخطأ والضعف، لأن العصمة محصورةٌ في القرآن الكريم، والنص الثابت عن المعصوم، أمّا مَن ينتج الخطاب الديني فهو يجتهد، وحسب اجتهاده ورأيه يتحدث ويخطُب ويكتُب، وكل أداءه بشري مُعرّض للنقص والخطأ، لذلك يُخطّئ العلماء بعضهم بعضاً في مختلف المسائل العَقدية والفقهية. ومن الأمثلة على ذلك نجد ان الشيخ المفيد رأى عدم صحة رأي الشيخ الصدوق في ثلاث وأربعين مسألة عقدية، ذكرها في كتابه «الاعتقاد»، فكتب المفيد كتابًا بعنوان «تصحيح الاعتقاد»، ونجد ذلك أيضاً في تعليقات الفقهاء على كتب الفتاوى الفقهية، ككتاب «العروة الوثقى» وهي فتاوى السيد محمد كاظم اليزدي، حيث يسجل كل فقيه في حاشيته على الكتاب موارد مخالفته لآراء السيد اليزدي، بمعنى عدم تصويبه لتلك الآراء، وان كان كل فقيه معذورًا فيما يذهب إليه، انطلاقًا من مشروعية الاجتهاد. بل قد يكتشف الفقيه أنه كان مخطئًا في رأيه العقدي أو الفقهي فيعدل عنه الى رأي جديد.
من جهةٍ أخرى، وبعيداً عن مسألة الخطأ والصواب، فإن الخطاب الديني بحاجةٍ الى التطوير ومواكبة التغيرات الثقافية والاجتماعية، خصوصاً مع تطوّر الحياة وتقدُّم العلم، وبالنقد والتقويم يحصل التطوير والتغيير، فقد يكون خطاب ديني صحيحًا ومناسبًا في وقتٍ من الأوقات وزمنٍ من الأزمنة، إلا أنه قد لا يكونُ كذلك في زمنٍ آخر، نظرًا لحصول تطوّر وتغيير في الواقع الاجتماعي.
ويشير الشيخ مرتضى مطهري إلى ملاحظة مهمة إذ يقول في أحدِ كتُبِه: (قد يكون شيء ما وسيلة للهداية، ثم قد يصبح الشيء نفسه في مكان آخر وسيلة للضلالة والضياع. إن المنطق الذي جعل امرأة مؤمنة، قد يُضلّ المثقف، وربّ كتاب متناسق مع ذوق عصر من العصور، ومنسجم مع مستواه الفكري، كان وسيلة في حينه لهداية الناس، ثم كان في وقت آخر سبباً لضلالهم، لدينا كتب سبق لها أن أدَّت وظيفتها في الماضي، وأرشدت إلى سبيل الهداية آلاف الناس. إلا أن هذه الكتب نفسها فضلاً عن كونها لم تعد تهدي أحداً، فإنها أصبحت سبباً لضلال عدد من الناس وشكهم وحيرتهم).
لذا ينبغي أن يكون هناك تقويم ومراجعة للخطاب الديني، وهذا ما ينسجم مع تعاليم وتوجيهات الدين، التي تحثنا على النقد الذاتي والمحاسبة في مختلف المجالات، من أجل الارتقاء إلى الأفضل، ففي الرواية الواردة عن الإمام جعفر الصادق: «مَنِ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ خَيْرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَمَنْ لَمْ يَرَ اَلزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى اَلنُّقْصَانِ، وَمَنْ كَانَ إِلَى اَلنُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ اَلْحَيَاةِ».
▪ لماذا يرفضون النقد والتقويم؟
نرى في بعض أوساط المتدينين مَن يزعجهم النقد والتقويم لكل ما يرتبط بالخطاب الديني، أو أي شأن من الشؤون الدينية، وكأن كل شيء فيها من الثوابت والمقدسات.
فنجد على سبيل المثال: أنَّ أحد العلماء يحذّر من نقد أي شيء يتعلق بالمجالس الحسينية، ويؤيد قوله بنقل قصةٍ عن الأثر الخطير لذلك في الآخرة، مفادها: أنّ إنسانًا مؤمنًا حضر مجلسًا حسينيًا، ولما خرج من المجلس انتقد شيئًا مما دار في المجلس، وفي الليل رأى كأنّ القيامة قد قامت، وكان هو من المؤهلين لدخول الجنة، وحين نظر الملائكة في صحيفته تركوه آخر الناس، ولم يسمحوا له بالدخول إلى الجنة إلا بعد انتظار طويل. وقالوا له: هذا بسبب نقدك لشيءٍ في المجلس الحسيني!!، إن هذا التحذير فيه مبالغة شديدة، كما أن الاستدلال بأطيافٍ وأحلامٍ منقولةٍ ليس منهجية علمية موضوعية.
وقد يكون التخوّف من نقد الخطاب الديني راجعًا إلى احتمال أنه يتم بتحريضٍ من الأعداء، الذين يتّخذون النقد وسيلةً لإضعاف الدين، ولا ننكر وجود أعداءٍ يسعون بمختلف الطرق لإضعاف الدين، وإضعاف ثقة الناس بالمؤسسة الدينية، ولكن مع ذلك لا يمكن منع النقد والتقويم، وانما ينبغي أن نتعامل معه تعاملاً إيجابياً مهما كانت جهتهُ ومصدرُه، وذلك بسدِ الثغراتِ والأخطاء في الخطاب والممارسات الدينية، وكشف المغالطات الموجودة في مقولات الناقدين.
كما أنه لا يصح اتهام كل ناقد بأنه ينطلق من خلفية عدائية، فهناك ناقدون من داخل الوسط الديني، ينطلقون من دافع الحرص على سمعة الدين، والإخلاص للحقيقة والمعرفة.
وجديرٌ بالذكر استحضار ما جاء في خطبةٍ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يحثُ فيها من حوله على النقد والتقويم تجاه سياساته ومواقفه، يقول: «فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ، وَلَا تَظُنُّوا بِيَ اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، وَلَا الِتمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَو الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فلا تكفوا عن مقولةٍ بحق».
ونستنتج من ذلك: أنَّ على المتدينين ليس فقط أنْ لا يرفضوا النقد، وإنما أنْ يبادروا إلى النقد الذاتي، وتقويم الخطاب الديني، في كل مناسبة وكل موسم، وأن يشجعوا من حولهم على ممارسته والترحيب به، كما جاء في كلام الإمام علي.
ونستحضر هنا بعض المبادرات النقدية الجريئة التي قام بها علماء أجلاء لهم مكانتهم في الساحة الشيعية، ومنهم:
المحدث الشيخ حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل، والذي ألّف كتابًا بعنوان (اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر) سلط فيه الأضواء على الممارسات الخطابية الرائجة المخالفة للضوابط الشرعية، وفنّد كل مبرراتها الزائفة.
السيد محسن الأمين في كتابه (المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية)، وهو من عدة أجزاء، ويسجل السيد الأمين في مقدمة هذا الكتاب نقدًا شديداً لخطابة كثير من الذاكرين في مناسبات أهل البيت ويصفها أنها مخالفة لنهج أهل البيت وتعاليمهم.
الشيخ محمد جواد مغنية الذي قدّم نقداً لكثيرٍ من مجالات الحالة الدينية، والخطاب الديني، في عددٍ من مؤلفاته وكتاباته.
الشيخ مرتضى مُطهّري نجد في عددٍ من كتبه نقدًا مفصّلًا للمؤسسة الدينية، وقد طبعت محاضراته النقدية حول ما يطرحه الخطباء من السيرة الحسينية في ثلاثة مجلدات بعنوان (الملحمة الحسينية)، وله كتابات في نقد بعض أوضاع الحوزات العلمية، وممارسات المنتمين إلى سلكها، مثل: (إحياء الفكر الديني في الإسلام، نقد الفكر الديني، محاضرات في الدين والاجتماع).
الشهيد السيد محمد باقر الصدر الذي نقد الرسائل العملية للفقهاء، ورأى أنَّ الأسلوب المتداول فيها لم يعد يناسب لغة العصر، وثقافة الناس المكلّفين، فعرض رأيه صريحًا في مقدمة رسالته (الفتاوى الواضحة)، وله أيضاً نقد عميق تجاه مناهج الحوزة العلمية ودروسها، كتبه في مقدمات حلقاته في علم الأصول، كما انتقد أسلوب تعامل الحوزة العلمية مع المجتمع في محاضرات سجلها في آخر أيام حياته، وصدرت في كتاب بعنوان (المحنة).
وهكذا سائر العلماء الذين بادروا إلى نقد الخطاب الديني كلٌّ في مجاله، وضمن الزاوية التي نظر اليها.
ولا يعني ذلك أنّ كلَّ رأيٍ من الآراء الناقدة صحيح بالمطلق، فآراء هؤلاء العلماء تقبل النقاش، والمجال مفتوح للبحث، والمبادرات قائمة. وخلاصة القول إن النقد والتقويم للخطاب الديني مشروعٌ ومفيدٌ للحالة الدينية.
ونُشيد هنا ببيان المرجعية الدينية العُليا لسماحة السيد علي السيستاني "حفظه الله" الذي صدر بمناسبة قرب حلول شهر المحرم 1441ه كوصايا للخطباء والمبلّغين، تضمنت اثني عشر حكمة، فيها توجيهات مهمة وملاحظات دقيقة، تعالج بعض ثغرات الخطاب الديني المعاصر، ومن اهم نقاط الضعف التي عالجها هذا البيان المهم، وسلط عليها الأضواء، ما ننقله من النص الصادر من مكتب سماحته فقد جاء في الحكمة السادسة:
(تجنّب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام بالحفاظ على وحدتهم وتآزرهم والتوادّ بينهم. ومن وجوه ذلك تجنّب التركيز على جهات التمايز بينهم مثل اختلافهم في التقليد، وفيما يختلف المجتهدون فيه من تفاصيل بعض المعتقدات، بل كلّ خلاف بينهم لا يخرِج بعضهم عن التمسّك بالكتاب والعترة، حتّى لو نشأ عن الاختلاف في درجات إيمانهم أو بصيرتهم، أو التزامهم أو رشدهم، بل حتّى لو كان عن زلّة صادرة من بعضهم.
ولا ينبغي إشهار الزلّة والتشهير بصاحبها فإنّ في ذلك ما يؤدّي إلى مزيد اشتهارها، وإلى إصرار صاحبها ومن قد يتأثّر به عليها، ويوجب وهن الحقيقة التي يُراد الحفاظ عليها فضلاً عن عدم جواز التشهير بالمؤمن وتسقيطه بزلّة صدرت منه لا سيّما فيما أوحى ذلك بعدم تقدير سائر خصائصه ومزاياه، ورُبّ زلّة خمدت بالسكوت عنها وترك ذكرها، واتّقدت ببيانها والحديث عنها، ورُبّ صمت عن شيء خير من كلام.
بل ينبغي تجنّب ما يثير الفرقة بين المسلمين ويوجب الضغينة وسوء الظنّ فيما بينهم، فإنّ ذلك خلاف تعاليمهم وسيرتهم حيث كانوا(ص) يحرصون فيها على حسن التعامل مع الآخر وعدم إبراز الاختلاف على وجه يوجب وهن الإسلام أو تشويه الحقّ، حتّى وردت التوصية بالصلاة معهم والكفّ عنهم وحضور مجالسهم وتشييع جنائزهم، وذلك أمر مؤكّد وواضح في التاريخ بالنظر إلى أحاديثهم وسيرتهم، ومن ثَمّ كانوا(ع) موضع احترام الآخرين وثنائهم بل اهتمّوا بالتعلّم منهم والتفقّه لديهم).
ومما جاء في الحكمة السابعة: (تجنّب القول بغير علم وبصيرة، فإنّ ذلك محرّم في الدين أيّاً كان مضمون القول، كما قال تعالى: [وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا] [سورة الإسراء، الآية: 36]، وليس في حسن قصد المرء وسلامة غايته ما يبيح ذلك، كما لا يقيه من محاذير ذلك ومضاعفاته.
وليحذر المرء من الابتداع والبدع، وهي إضافة شيء إلى الدين ليس منه ولا حجّةً موثوقةً عليه فيه، فإنّ الابتداع في الدين من أضرّ وجوه الضلالة فيه، وهي تؤدّي إلى تشعّب الدين إلى عقائد متعدّدة وانقسام أهله إلى فرق وأحزاب مختلفة ومتقاطعة كما نشهده في كثير من الأديان والمذاهب، وقد جاء عن النبيّ(ص) التحذير من البدعة وأنّ شرّ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار.
ومن القول بغير علم وبصيرة المبالغة في الشيء والتجاوز به عن حدّه، كأن يجعل الأمر النظريّ المتوقّف على الاجتهاد واضحاً وبديهيّاً، أو يجعل الأمر المختلف فيه بين وجوه أهل العلم متّفقاً عليه بينهم تصريحاً أو تلويحاً وينزّله منزلته، أو يجعل المظنون مقطوعاً، أو يجعل المحتمل مظنوناً، أو يجعل بعض الوظائف الشرعيّة فوق درجاتها فيبلغ بالمستحبّ درجة الواجب من غير عنوان ثانويّ واجب ينطبق عليه وبالواجب من غير الدعائم درجة دعائم الدين أو يعكس ذلك، فإنّ ذلك كلّه أمر غير مقبول شرعاً.
وجاء في الحكمة الثامنة: (ليحذر المبلّغون والشعراء والرواديد أشدّ الحذر عن بيان الحقّ بما يوهم الغلوّ في شأن النبيّ وعترته(ص)، والغلوّ على نوعين: إسباغ الصفات الألوهيّة على غير الله سبحانه، وإثبات أمور ومعانٍ لم تقم حجّة موثوقة عليها، ومذهب أهل البيت(ع) خالٍ عن الغلوّ بنوعيه، بل هو أبعد ما يكون عنه، وإنّما يشتمل على الإذعان للنبيّ وعترته (صلوات الله عليهم) بمواضعهم التي وضعهم الله تعالى فيها من دون زيادة ولا إفراط، بل مع تحذّر في مواضع الاشتباه، وورعٍ عن إثبات ما لم تقم به الحجّة الموثوقة).
▪ معاييرُ النقد والتقويم
لا بُدّ للنقد والتقويم من معايير موضوعية صحيحة، فهناك من يستخدم التهريج والتجريح والألفاظ المسيئة في نقده لآراء الآخرين، أو يعمّم الأخطاء، وهذا أسلوب خطأ، يضر ولا ينفع، ويُفقد صاحبه المصداقية، وقد يُظن بصاحب هذا الأسلوب أنَّه يريد إلفات الناس إلى ذاته، أو تصفية حسابات مع هذه الجهة أو تلك، ويُشغل الناس بقضايا جانبية هامشية، ويُشوّه عملية الإصلاح والتطوير، فالنقد بهذه الكيفية ليس في محلّه ولا يُعدُّ أسلوباً سليماً.
من الجانب الآخر هناك تقويم ونقد على أساس علمي، ينطلق من حالة فكرية علمية، فكل إنسان لديه فكر ومعرفة فيما يحدث حوله، من حقه أن ينتقد ويُقوّم.
ومهم جداً في مسألة التقويم أن نلتفت إلى مسألة الاتفاق على المرجعية الفكرية، إذ حين تختلف المرجعية، من الطبيعي أن تختلف الآراء والمواقف، فكل اتجاه له مرجعيته الفكرية، فإذا جاء شخص من خارج الفضاء الديني يريد أن يحاكم الخطاب الديني وفق مرجعيته العلمانية مثلاً، فهذا خطأ، لأنّ محاكمة الخطاب لا بُدّ أن تنطلق من المرجعية التي يقبلها، أو من خلال المبادئ العقلية والإنسانية العامة المتفق عليها، دون فرض مرجعية وقناعة أُخرى على الخطاب الديني.
انعكاسات الخطاب الديني ومخرجاته الاجتماعية
إن من أهم مناهج النقدِ والتقويم لأي خطاب، قراءة المخرجات والنتائج، وملاحظة انعكاس الخطاب على المجتمع سلباً وإيجاباً. فمثلاً: حين نجد أنّ الخطاب الديني ساهم في انتاج مجتمعٍ متقدمٍ متحضّرٍ، فهذا يدل على سلامة ورقي هذا الخطاب، بينما حين نجد أنَّ النتيجة كانت تكريس واقعٍ متخلّفٍ ووضعٍ سيء، هنا لا يُمكن أن نحكم بصوابية ذلك النهج من الخطاب. فعلى أساس النتائج والانعكاسات التي صنعها الخطاب في المجتمع يكون النقد والتقويم.
وحين ننظر إلى الواقع الاجتماعي في عالمنا الإسلامي، نجد واقعاً ليس إيجابيًا، فيه ظواهر سلبية خطيرة، ومن أبرزها:
أولاً: عدم رسوخ القيم الأساس للدين في نفوس أبناء المجتمع، وغياب الالتزام بها في سلوكهم، كقيمة الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وضعف الالتزام بالأخلاق الفاضلة كالصدق والأمانة، ومراعاة النظام، فهذه القيم غير راسخة في النفوس، وغير منعكسة على السلوك في مساحة واسعة من هذه المجتمعات.
ثانياً: ضعف الاهتمام العلمي والثقافي، وغياب الإبداع في علوم الطبيعة والحياة، فالعالَم يتقدَّم كل يوم في مختلف مجالات العلوم، ومساهمة مجتمعاتنا الإسلامية في هذا التقدم العلمي لا تكاد تذكر، وحين نُسلّط الضوء على بعض المبادرات العالمية للإشادة بالمبدعين والمتميزين في إنتاجهم العلمي، مثل جائزة الملك فيصل العالمية، نجد أنه قد فاز بالجائزة في مجال العلوم المختلفة حتى 2019م، 59 عالماً من 14 جنسيّة، وليس فيهم من يحمل جنسية بلد إسلامي، عدا الفائزين في مجال الأدب وخدمة الإسلام.
نعم نجد في المسلمين من حصل على جائزة نوبل لكنهم يعدّون على الأصابع، ولا يُقاسون عددًا بمن فازوا بالجائزة من اليهود والمسيحيين والديانات الأخرى، فلماذا نجد ضعف الاهتمام العلمي، والإبداع المعرفي في مجتمعاتنا الإسلامية؟
ثالثاً: انخفاض مستوى الفاعلية والإنتاج ومستوى جودة الحياة، كالإنتاج الصناعي والزراعي والتكنولوجي، وفي مختلف المجالات. وقد أصبح لجودة الحياة معايير ومقاييس عالمية فيما يرتبط بالخدمات الصحية، وفرص التعليم، والعمل، والأمن الاجتماعي، والتخطيط العمراني، والحوكمة والشفافية، ومجالات الترفيه.. وتتنافس الدول والمجتمعات الأخرى على تحقيق أعلى الدرجات فيها، بينما لا تزال معظم مجتمعاتنا الإسلامية تحتل أدنى المراتب في المؤشرات والتقارير الدولية لجودة الحياة.
رابعاً: ضعف المشاركة والاقبال على العمل التطوعي الإنساني، في مقابل الإقبال الأكثر على الأعمال الدينية، كبناء المساجد والحسينيات، وأداء الحج والعمرة، وزيارة العتبات المقدسة، وحضور المآتم وإقامة الشعائر، وهي أعمالٌ حسنة مرضيّة عند الله تعالى، إلا أننا نتطلع لمثل هذا الإقبال والتفاعل مع الجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية، ولجان الاهتمام بالبيئة، وبذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز البحث العلمي والإبداع الفني، فالإقبال على هذه المجالات ضعيفٌ جداً مقارنةً بالمجتمعات الأخرى، حيث تشير مثلاً الإحصائية التي صدرت قبل سنوات قليلة في المملكة العربية السعودية عن العمل التطوعي، إلى أن عدد المسجلين رسميًا كمتطوعين في المملكة لا يتجاوز 23 ألفًا فقط في وطن تعداد سكانه يقارب الثلاثين مليوناً!!، وهناك الآن تطلع لرفع عدد المتطوعين على مستوى المملكة إلى مليون متطوع بحلول سنة 2030م في سياق الرؤية المعتمدة.
خامساً: كثرة الخلافات والنزاعات في المجتمعات الإسلامية وخاصةً في الأوساط الدينية، حتى أن البعض يستخدم الخطاب الديني والأمور العبادية في إذكاء حالة الصراع والخلاف، ومما يُنقل في التاريخ الماضي: أنه حصل نزاعٌ بين قريتين، فأوقف أحدهم مزرعة نخيل من أجل استخدام (جريد النخل) في النزاع قربة الى الله تعالى؛ وكأنّ النزاع والصراع في بعض الأوساط جزء من الحالة الدينية والأعمال العبادية التي يتقرب بها إلى الله تعالى.
هذه بعضُ الظواهر الموجودة في معظم مجتمعاتنا الإسلامية، على سبيل المثال لا الحصر، وقد تجد من يُقوّم الخطاب الديني من خلال هذا الواقع الاجتماعي.
المصدر: مجلة الاجتهاد والتجدید، العددان التاسع والخمسون والستون
السنة الخامسة عشر، صيف 2021م، 1442ه، وخريف 2021م، 1443ه.