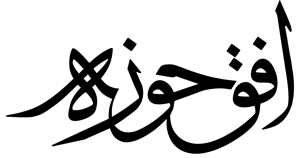

□ مقالة/ الجزء الجزء الأول
منهج السَّيِّد محمَّد باقر الصَّدر في إثبات أصول الدِّين
▪ تمهيد
الغرض، من هذا البحث، تسليط الضَّوء على المنهج العلمي والفلسفي الذي اعتمده السَّيِّد الشَّهيد، الإمام محمَّد باقر الصَّدر، في التَّصدِّي لواحدة من المشكلات التي واجهت الإيمان والتَّصديق باللَّه والنُّبوَّة ورسالة الإسلام، والنَّاجمة عن تسرُّب فكر فلسفي، إلحادي، وسم نفسه ب ـ «العلميَّة» تارةً، وف«الوضعيَّة»، بوصفها إحدى خصائص العلم، تارةً ثانيةً، وف«المنطقيَّة» ميزة الذِّهن البشري المعصوم عن الخطأ، طوراً، وف«التجريبيَّة» باعتبارها محكَّ امتحان الحقائق، كرَّةً رابعةً، في عصر كادت فيه الثَّقافة الدِّينية الإسلامية تخسر لحساب تيَّارات فكريَّة وافدة، أرادت كسب العقول، بعيداً عن الدِّين، الذي رمته بالتَّقليد والابتعاد عن روح العصر، ووصمته بالتَّخلُّف ومعاداة ـ التقدُّم العلمي والحضاري.
منهج الصَّدر، في ردّ الشبهة هذه، هو ما نطمح لعرض مقدّماته، وتحليل نتائجه، من زاوية معرفيَّة موضوعيَّة، تطمح أيضاً للإضاءة على منحى فكري، متجدِّد، في عقل كبير من عقول إحياء الإسلام، وإثبات جدارته في ساحة ـ المعرفة، الملأى بتيَّارات مختلفة، وباتجاهات جديدة في الفلسفة من المادِّية الجدليَّة إلى الوضعيَّة المنطقيَّة.
أمَّا منهجنا في هذه المقاربة فيقوم على الحيدة والعرض الموضوعي، ما أمكن، والعودة إلى المقدِّمات الصَّدرية في منابعها الأصلية، لئلاَّ تتأذَّى الفكرة ـ الواقعة، فضلاً عن الفضائل المعروفة للعودة المباشرة إلى النُّصوص.
▪ أ ـ منهج الإمام الصَّدر
يحتلُّ المنهج، عند الإمام محمَّد باقر الصَّدر، على ما نظنّ، في النَّظر إلى الكون والإنسان من منطلق المصادر الإلهيَّة والبشريَّة للإسلام التاريخي، حجر الزَّاوية في مجمل البناء الفكري ومنظوماته المختلفة. ومفهومه للمنهج يقترب من مفهوم المنهج المعاصر، كما تدلُّ عليه استخدامات الفلاسفة والمناطقة والعلماء؛ فهو طريق الأدلَّة والبراهين على النَّظريات والأفكار.
ويتنبَّه الإمام السَّيد محمد باقر الصَّدر إلى أهمِّية المنهج ودوره في المعرفة الحقَّة. ذلك لأنَّ «صحَّة الإستدلال ترتبط ارتباطاً أساسياً بصحَّة المنهج الذي يعتمد عليه».
لذا، أولى الصَّدر المنهج عناية خاصَّة، انتهت به إلى توليد منهج في الإستدلال على آرائه وأطروحاته، تناول أبرز قواعده في كتابه «الأسس المنطقية للإستقراء» .
وعلى نحو خاصّ، نعني بمنهج الصدر في إثبات أصول الدِّين «المقدِّمة المطلوبة» للإقتناع بأصول الدِّين ودرجات الإستدلال على الصَّانع الحكيم والنبي المُرْسَل محمد(ص) والإسلام باعتباره الرِّسالة.
فمنهج السَّيِّد الشَّهيد هو عودة على بدء للإجابة عن التَّساؤلات الكبرى: هل الماورائيات (اللَّه، النبوة، المعاد) تخضع لأحكام العقل، أو أنها في طور خارج أطواره؟ وكيف يهتدي الإنسان إليها بإيمانه أم بعقله؟ هل علم الإنسان طريق الإستدلال سابقٌ على علم اللَّه أو أنَّ علم اللَّه سابق؟ وهو الأصل الذي يُبْتنى عليه مقتضى العلم الإنساني؟
قبل الصَّدر بعشرة قرون، على الأقلّ، احتدم الجدل في الإسلام حول هذه المسائل: العقل أم النقل، وما يتفرَّع عنهما، ومسألة العلم الإلهي. وقلَّب المعتزلة والأشاعرة أفانين النَّظر حولها. فقالت المعتزلة بكمال العقل وبالمعارف الضَّرورية التي تحصل للإنسان طفلاً كان أم ناضجاً. «فمن عرف توحيد ربِّه وصفاته وعدله وحكمته بالضَّرورة فحكمه حكم المسلمين، وهو معذور في جهله بالنبوَّة وأحكام الشَّريعة». وهذا يفيد أنَّ الإنسان قادر على معرفة اللَّه بالفطرة والضَّرورة.
وذهبت الأشعريَّة، على خلاف هذا، إلى تثبيت الإيمان بالقلب من دون نفي حصول معرفة اللَّه بالعقل. قال أبو الحسن الأشعري (260هـ ـ 873مر 324هـ ـ 935م): «... والواجبات كلُّها سمعيَّة، والعقل لا يوجب شيئاً، ولا يقتضي تحسيناً ولا تقبيحاً. فمعرفة اللَّه تعالى بالعقل تحصل، وبالسمع تجب».
فالثَّابت، من كلام الأشعري، أنَّ الإيمان طريق معرفة اللَّه، وإن كان العقل قادراً على اكتسابه.
وعلى مشارف نهاية القرن العشرين، يأتي الصَّدر ليثير المسألة عن طريق العقل، لا ليثبت لنفسه بأدلَّة العلم والعقل حقيقة الألوهيَّة والنبوَّة، بل ليرفع الإسلام والمنهج الإسلامي إلى مصاف النقاشات العالية مع اكتساح العقل البشري، على المستوى الكوني، نزعتان في التَّفكير هما: المادِّية الجدليَّة والوضعيَّة المنطقيَّة. وكلتاهما لا تقرّ، بحال، حقيقة الإلهيَّات والماورائيَّات بأشكالها كافة.
ولئن كان السيِّد الشهيد يسوِّغ منهجه، باعتباره المقدِّمة المطلوبة للاستدلال على وجود اللَّه الخالق المدبّر للكون، فإنَّنا نرى أنَّ ثمَّة مشابهة بين مهمَّة هذا الإمام -الفيلسوف وبين ما لجأ إليه ابن رشد (520هـ ـ 1126مر 595هـ ـ 1198م) باعتبار المنطق والفلسفة لا يضادَّان الشَّريعة؛ ذلك لأنَّ الفلسفة ليست «شيئاً أكثر من النَّظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع».
أراد الإمام الصَّدر أن يخاطب العقول النيِّرة خطاباً عقليَّاً مقنعاً. فوضع منهجاً في الاستدلال على اللَّه (المُرسِل) وعلى النَّبيّ (الرَّسول) وعلى الدِّين (الرِّسالة)، مميِّزاً بين الدَّليل ومنهج الدَّليل، عارضاً مراحل الإستدلال على اللَّه مبدع الكون والوجود: من الإيمان بالفطرة أو البداهة إلى إدراك الخالق بالدَّليل الفلسفي، ثمَّ إدراكه بالعلم. ويظهر الصَّدر طول باع في تتبُّع مراحل المعرفة من الحسِّي والتَّجريبي إلى العقلي، فالوضعيَّة المنطقيَّة والمثاليَّة الإلؤهية والمادِّيَّة الجدليَّة.
وبعد أن يتوقَّف عند رفض المادِّيَّة الجدليَّة والوضعيَّة المنطقيَّة، ينتهي إلى تركيب منهج يعتمد على الحسِّ والتَّجربة بوصفهما بدايات للإستدلال، وهذا هو الاستقراء، وعلى العقل والاستنتاج لتنظيم الرَّوابط والعلاقات الذهنيَّة، وهذه طريق الفلسفة.
إذاً، يلجأ الصَّدر إلى العلم والفلسفة لإثبات وجود الصَّانع. إلى العلم من خلال الدَّليل العلمي، ومنهجه: «الدليل الإستقرائي القائم على حساب الإحتمالات». وإلى الفلسفة والعقل من خلال الدَّليل الفلسفي.
▪ ب ـ في الدَّليل العلمي الإستقرائي
يمهِّد الصَّدر لدليله، بلغتنا، لثلاثة أمور على طريقة ديكارت (1596 ـ 1650م) والغزالي (450هـ/1059م/ 501هـ/1111م): فالوضوح أوَّلاً، في عرض الدَّليل وتتبُّع نتائجه. وتحديد خطواته، ثانياً ببساطة وإيجاز. والتحقُّق ثالثاً من صحَّة المنهج أو الوثوق بالنتائج التي تؤدِّي إليها على نحو ما نحا أبو حامد الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» عندما حدَّد اليقين بأنَّه «هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم».
فاليقين، أو الوثوق بالنتائج عند الغزالي، يتوقَّف على الإيمان أو الإلهام والنُّور الذي يُستضاء به. أمَّا عند الصَّدر فاليقين ينجم عن اختبار الأحكام بالتَّجربة اليوميَّة. فما دمنا نثق بنتائج منهج الدَّليل الاستقرائي في إثبات حقائق الحياة وحقائق العلوم صار بالإمكان الوثوق به في الاستدلال على اللَّه. فف«منهج الاستدلال على وجود الصَّانع الحكيم هو المنهج الذي نستخدمه عادةً لإثبات حقائق الحياة اليوميَّة والحقائق العلميَّة. فما دمنا نثق به لإثبات هذه الحقائق فمن الضروري أن نثق به بصورة مماثلة لإثبات الصَّانع الحكيم الذي هو أساس تلك الحقائق جميعاً».
والمماثلة، أو المحاكاة، بين استدلالنا على ما هو أرضي، تصحُّ بالضَّرورة على استدلالنا على ما هو إلهي. هذا ما يخلص إليه الصَّدر، محدِّداً خطوات منهج الدَّليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات بخمس هي:
1 ـ ملاحظة الظَّواهر بالعيان أي «بالحسِّ والتَّجربة».
2 ـ بعد ملاحظة هذه الظَّواهر وتجميعها ننتقل إلى مرحلة تفسيرها، «والمطلوب في هذه المرحلة أن نجد فرضيَّة صالحة لتفسير تلك الظَّواهر وتسويغها جميعاً، ونقصد بكونها صالحة لتفسير تلك الظواهر أنَّها إذا كانت ثابتة في الواقع فهي تستبطن أو تتناسب مع وجود جميع تلك الظواهر التي هي موجودة فعلاً».
وإذا أمعنَّا النَّظر في هذه الخطوة نجد الضَّوابط الآتية: 1 ـ صلاح الفرضيَّة، 2 ـ أن تكون الفرضيَّة صالحة يعني أن تثبت في الواقع 3 ـ والثَّبات يعني الإستبطان (الدخول في باطن الشيء أو ماهيَّته)، والتَّناسب (التَّشاكل والتماثل). فماهيَّة الفرضيَّة يتعيَّن أن تتعلَّق بالممارسة مع ظاهر الظَّواهر وباطنه.
3 ـ الخطوة الثَّالثة امتحان وجود الظَّواهر في ضوء الفرضيَّة. فهذه «الفرضيَّة إذا لم تكن صحيحة وثابتة في الواقع ففرصة تواجد تلك الظَّواهر كلها مجتمعة ضئيلة جداً». بمعنى آخر، إنَّ امتحان صدق الفرضيَّة المفسِّرة للظواهر لجهة ثباتها في الواقع ترتبط باحتمال توفر الظَّواهر. فعلى افتراض عدم صحَّة الفرضيَّة فإنَّ نسبة احتمال وجود الظَّواهر جميعها تكون أقرب إلى احتمال عدمها، أو عدم وجود واحدة منها على الأقل ضئيلة جدَّ.
4 ـ والخطوة الرَّابعة ترتبط بسابقاتها. فكأنَّها مقدِّمات صادقة لنتيجة طبيعيَّة صادقة حتماً. فمن الخطوة الثَّالثة «نستخلص أنَّ الفرضيَّة صادقة. يكون دليلنا على صدقها وجود تلك الظَّواهر التي أحسسنا بوجودها في الخطوة الأولى».
5 ـ والخطوة الخامسة تهدف إلى التأكُّد من يقين الفرضيَّة بعد افتراض صدقها. والقاعدة تُصاغ هكذا: «إنَّ درجة إثبات تلك الظَّواهر للفرضية تتناسب عكسياً مع نسبة احتمال وجود تلك الظَّواهر جميعاً إلى احتمال عدمها على افتراض كذب القضية. فكلَّما كانت هذه النِّسبة أقلَّ كانت درجة الإثبات أكبر حتى تبلغ في حالات اعتيادية كثيرة إلى درجة اليقين الكامل بصحَّة الفرضيَّة».
وباختصار، فالخطوة الخامسة هي ربط بين ترجيح الخطوة الرَّابعة وضآلة الاحتمال في الخطوة الثَّالثة. هذه خطوات الاستدلال الاستقرائي الذي يقوم على حساب الاحتمالات والذي يعتمده الصَّدر لإثبات وجود اللَّه، وهي صادقة بذاتها. ولكن المنهج يحتاج إلى اختبار وامتحان وتقييم: على مستوى الخبرة في الحياة، وعلى مستوى العلوم الطَّبيعية. فما يصحُّ في هذين الحقلين يصحُّ بالضرورة في حقل إثبات الصَّانع؛ فمفكِّرنا انتقل من التَّجربة الأرضيَّة العيانية إلى العالم الإلهي. فالفيزيقا طريق الاستدلال على المتافيزيقا بالاستقراء.
وما دام همُّنا أن نبحث في المنهج نفسه لا في نتائجه؛ فإنَّنا نستعرض لماماً فحوى طريقة الصَّدر الاستقرائيَّة في إثبات وجود الصَّانع.
فالنَّظر الصَّدري ينطلق دوماً من الظَّواهر العيانية. - في الوجود نلاحظ «توافقاً مطَّرداً بين عدد كبير وهائل من الظَّواهر المنتظمة، وبين حاجة الإنسان ككائن حيّ وتيسير الحياة له على نحو نجد أنَّ أيَّ بديل لظاهرة من تلك الظَّواهر يعني انطفاء حياة الإنسان على الأرض أو شلَّها».
وبعد أن يستعرض الصَّدر تلك الظَّواهر المستمرَّة في الزَّمان ينتقل إلى استكشاف الرَّابط بين الظَّواهر الطبيعيَّة وحياة الإنسان، خالصاً إلى «فرضيَّة» الصَّانع الحكيم لهذا الكون».
ثم يمتحن الصَّدر ثبات هذه الفرضيَّة في الواقع؛ لينتهي إلى «ترجيح أن تكون الفرضيَّة التي طرحناها في الخطوة الثَّانية صحيحة، أي أن هناك صانعاً حكيماً».
من صدق الإفتراض إلى اليقينية القاطعة يصل الصَّدر إلى نتيجة لا يشوبها شك، وهي أن يكون «للكون صانع حكيم بدلالة كل ما في هذا الكون من آيات الاتساق».
ويشفع الصَّدر دلالته الاستقرائية بتثبيت آية تدعم خلاصة استدلاله الوضعي [سَنُرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفاقِ وَفي أنْفسِهِمْ حتَّى يَتَبيَّنَ لَهُمْ أنَّهُ الحَقُّ أَوَلَمْ يَكْف بِرَبِّكَ أنَّهُ على كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ] [فصلت/53].
فالآية تحثُّ على الإيمان باللَّه وكتابه، بدلالة ما في السماوات والأرض من النيِّرات والنَّبات من لطيف الصّنعة وبديع الحكمة، لتصديق أن القرآن منزل من اللَّه الذي لا يغيب عنه شيء.
وعليه، فالاستقراء العلمي لا يتنافى قطُّ مع الحقائق القرآنية. وتدلُّ التجربة على أنَّهما يفضيان إلى نتيجة واحدة هي وجود اللَّه الصَّانع المدبِّر للكون وما فيه.
إنتهی ویلیه الجزء الثاني والأخیر في العدد المستقبل
المصدر: مجلة المنهاج، العدد : 17، السنة الخامسة ربيع 1421 هجـ 2000