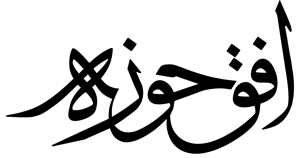

□ مقالة/ الجزء الرابع والأخیر
شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه عند الشيعة الإمامية
▪ الخلط بين المماثل والمشابه
والذي ألفت نظر الأستاذ إليه هو أن القياس ليس من باب المماثلة، بل من باب المشابهة، وكم هو الفرق بين التماثل والتشابه، فما ذكره من أن "ما ثبت لشيء ثبت لمثله" راجع إلى المتماثلين، والفرق بينهما واضح، وذلك لأن التماثل عبارة عن دخول شيئين تحت نوع واحد وطبيعة واحدة، فالتجربة في عدة من مصاديق طبيعية واحدة تفيد العلم بأن النتيجة لطبيعة الشيء لا لأفراد خاصة، ولذلك يقولون: إن التجربة تفيد العلم، وذلك بالبيان التالي:
إذا أجرينا مثلا تجربة على جزئيات من طبيعة واحدة كالحديد، تحت ظروف معينة من الضغط الجوي، والجاذبية، والارتفاع عن سطح البحر، وغيرها مع اتحادها جميعا في التركيب فوجدنا أنها تتمدد مقدارا معينا، ولنسمه (س)، عند درجة خاصة من الحرارة، ولنسمها (ح). ثم كررنا هذه التجربة على هذه الجزئيات في مراحل مختلفة في أمكنة متعددة، وتحت ظروف متغايرة ووجدنا النتيجة صادقة تماما: يتمدد الحديد بمقدار (س) عند درجة (ح)، فهنا نستكشف أن التمدد بهذا المقدار المعين معلول لتلك الدرجة الخاصة من الحرارة فقط، دون غيرها من العوامل، فعندئذ يقال: "ما ثبت لشيء ثبت لمثله"، أو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.
وأما التشابه فهو عبارة عن وقوع فردين مختلفي الطبيعة تحت صفة واحدة توجب التشابه بينهما، وهذا كالخمر والفقاع فإنهما نوعان وبينهما تشابه في الإسكار، فلو أثبتت التجربة أن للخمر أثرا خاصا لا يمكن القول بثبوته للفقاع والنبذي، بل لا بد من التماس الدليل على المشاركة وراء المشابهة.
وأوضح من ذلك مسألة الاستقراء، فإن ما نشاهده من الحيوانات البرية والبحرية، أنواع مختلفة، فلو رأينا هذا الحيوان البري وذلك الحيوان البحري كل يحرك فكه الأسفل عند المضغ ربما نحكم بلا جزم بذلك على سائر الحيوانات من دون أن تكون بينهما وحدة نوعية أو تماثل في الحقيقة، والدافع إلى ذلك التعدي في الحكم وهو التشابه والاشتراك الموجود بين أنواع الجنس الواحد، رغم اختلافها في الفصول والأشكال، ولكن لا يمكن الجزم بالحكم والنتيجة على وجهها الكلي، لإمكان اختلاف أفراد نوعين مختلفين في الحكم.
وبذلك يعلم أن القياس عبارة عن تعميم حكم مشابه إلى مشابه لا حكم مماثل إلى مماثل، ومن المعلوم أن تعميم الحكم من طبيعة إلى طبيعة أمر مشكل لا يصار إليه إلا إذا كان هنالك مساعدة من جانب العرف لإلغاء الخصوصية، وإلا يكون التعميم عملا بلا دليل.
مثلا، دل الكتاب العزيز على أن السارق والسارقة تقطع أيديهما، والحكم على عنوان السارق فهل يلحق به النباش الذي ينبش القبر لأخذ الأكفان؟ فإن التسوية بين العنوانين أمر مشكل، يقول السرخسي: «لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النباش بالسارق في حكم القطع، لأن القطع بالنص واجب على السارق».
والحاصل أن هناك فرقا واضحا بين فردين من طبيعة واحدة، فيصح تعميم حكم الفرد إلى الفرد الآخر لغاية اشتراكهما في النوعية، وأن حكم الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد، لكن بشرط أن يثبت أن الحكم من لوازم الطبيعة لا الخصوصيات الفردية.
وأما المتشابهان فهما فردان من طبيعيتين كالإنسان والفرس يجمعهما التشابه والتضاهي في شيء من الأشياء، فهل يصح تعميم حكم نوع إلى نوع آخر؟ كلا، إلا إذا دل الدليل على أن الوحدة الجنسية سبب الحكم ومناطه وملاكه التام، كما دل الدليل في أن سبب الحرمة في الخمر هو الإسكار، وإلا فلا يصح إسراء حكم من طبيعة إلى طبيعة أخرى بمجرد التشابه بينهما، أو الاشتراك في عرض من الأعراض.
▪ الدليل العقلي وحجية المصلحة
قد تعرفت على أن العقل أحد مصادر التشريع أو بالأحرى أحد المصادر لكشف الحكم الشرعي.
ومجال الحكم العقلي غالبا أحد الأمور التالية:
1- التحسين والتقبيح العقليان.
2- أبواب الملازمات: من قبيل الملازمة بين وجوب الشيء ومقدمته وحرمة ضده، والملازمة بين النهي عن العبادة أو المعاملة وفسادها إلى غير ذلك مما يرجع إلى باب الملازمة.
3- أبواب التزاحم: أي تزاحم المصالح التي لا بد من أخذها، كإنقاذ أحد الغريقين مع العجز عن إنقاذ كليهما، أو تزاحم المصالح والمفاسد كتترس العدو بالمسلمين، فإن للعقل دورا فيها، وله ضوابط لتقديم إحدى المصلحتين على الأخرى، أو تقديم المصلحة على المفسدة أو بالعكس (وهي مذكورة في مظانها).
ولا غبار على حجية العقل في هذه الموارد، إنما الكلام في حجية المصلحة وعدها من مصادر التشريع فيما لا نص فيه، فقد ذهب عدة من فقهاء السنة إلى حجية المصلحة، وسماها المالكية بالمصالح المرسلة، والغزالي بالاستصلاح، وحاصل دليلهم على حجية المصلحة وكونها من مصادر التشريع كالتالي:
إن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس.
وحاصل هذا الوجه ادعاء وجود النقص في التشريع الإسلامي لو اقتصر في مقام الاستنباط على الكتاب والسنة، لأن حاجات المجتمع إلى قوانين جديدة لا زالت تتزايد كل يوم، فإذا لم تكن هناك تشريعات تتلاءم مع هذه الحاجيات لم تتحقق مقاصد الشريعة.
ثم إن السبب لجعلهم المصالح مصادر للتشريع هو الأمور التالية:
1- إهمال العقل وعدم عده من مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح العقليين.
2- إقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع إقفالا سياسيا، فقد صار ذلك سببا لوقف الدراسات الفقهية منذ قرون، وفي ظل ذلك توهم المتأخرون وجود النقص في التشريع الإسلامي وعدم كفايته لتحقيق مقاصد الشريعة فلجأوا إلى عد المصالح المرسلة من مصادره، وبذلك وجهوا قول من يعتقد بحجية المصالح المرسلة من أئمة المذاهب.
3- عدم دراسة عناوين الأحكام الأولية والثانوية كأدلة الضرر والجرح والاضطرار والنسيان، فإن هذه العناوين وما يشابهها تحل أكثر المشاكل التي كان علماء السنة يواجهونها، من دون حاجة لعد الاستصلاح من مصادر التشريع.
4- عدم الاعتراف بصلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بوضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة ودفع المفسدة أحكاما مؤقتة ما دام الملاك موجودا.
والفرق بين الأحكام الواقعية والولائية هي أن الطائفة الأولى أحكام شرعية جاء بها النبي لتبقى خالدة إلى يوم القيامة، وأما الطائفة الثانية فإنما هي أحكام مؤقتة أو مقررات يضعها الحاكم الإسلامي (على ضوء سائر القوانين) لرفع المشاكل المتعلقة بحياة المجتمع الإسلامي.
هذه هي حقيقة المصالح المرسلة. ثم إنهم مثلوا للمقام بأمثلة، نذكر منها ما يلي:
1. جمع القران الكريم في مصحف بعد رحيل النبي.
2. قتال مانعي الزكاة.
3. وقف تنفيذ حكم السرقة في عام المجاعة.
4. إنشاء الدواوين.
5. سك النقود.
6. فرض الإمام العادل على الأغنياء من المال لا بد منه لتكثير الجند وإعداد السلاح وحماية البلاد وغير ذلك.
7. سجن المتهم كي لا يفر.
8. حجر المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس.
ثم إن بعض المغالين ربما يتجاوز، فيمثل بأمور لا تبررها أدلة التشريع الواقعي كتنفيذ الطلاق ثلاثا، مع أن الحكم الشرعي هو كونه طلاقا واحد في عصر النبي وبرهة بعد رحيله، وهذا من باب تقديم المصلحة على النص.
ثم إن للإمامية في العمل بالمصالح مذهبا وسطا أوضحناه في كتابنا، وليست الإمامية ممن ترفضه بتاتا كما تصوره الأستاذ أو تقبله في عامة الصور.
هذا إجمال الكلام في المصالح المرسلة -والتفصيل مع مالها وما فيها يطلب من محله- إذا عرفت ذلك فهلم معي نقرأ ما ذكره الدكتور الريسوني في هذا الموضوع، قال: «فتارة تدخل تحت اسم "الدليل العقلي" حيث يدرجون ضمنه -مثلا- اعتبار "الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار الحرمة"، وهذا عين اعتبار المصلحة. كما أن من القواعد المعتبرة عندهم ضمن دليل العقل قاعدة "وجوب مقدمة الواجب"، وهي المعبر عنها ب«ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، ذلك أن معظم المصالح المرسلة هي من قبيل "ما لا يتم الواجب إلا به"، فهي مقدمات أو وسائل لواجبات أخرى، ومثلها قاعدة "كل ما هو ضد الواجب فهو غير جائز"، فهذا ما يعبر عنه بدرء المفاسد. وتارة يدخلون العمل بالمصلحة من باب ما يسمى عندهم "السيرة العُقَلائية" أو "بناء العقلاء"، وهو في الوقت نفسه من المصالح المرسلة».
وحاصل كلامه: أنه تدخل تحت حجية المصلحة القواعد التالية:
1.وجوب مقدمة الواجب.
2. حرمة ضد الواجب.
3. حجية بناء العقلاء وسيرتهم.
4. الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار الحرمة.
فهي نفس العمل بالمصلحة مع أنهم يدخلونها تحت "الدليل العقلي".
يلاحظ عليه: أن اشتمال هذه القواعد على المصالح ودرء المفاسد غير كون المصلحة سببا لتشريعها ومبدأ لتقنينها، فإن الدليل على وجوب مقدمة الواجب أو حرمة ضد الواجب حكم العقل بالملازمة بين الإرادتين، فمن حاول الوقوف على السطح لا محيص له من إرادة نصب السلم، أو ركوب المصعد.
فاشتمال المقدمة على المصلحة أو اشتمال الضد على المفسدة أمر جانبي لا مدخلية له في الحكم بالوجوب والحرمة.
وأما حجية بناء العقلاء، فإن أساسها كونه بمرأى ومسمع من الشارع وهو إمضاؤه، لهذا لو كان غير مرضي عنده لما سكت عن النهي عنه، لقبح السكوت عما يجب إغراء الأمة، ولولا إمضاؤه لما صح الاعتماد عليه في الفقه، كما هو الحال في السير التي رفضها الشارع كبيع الخمر والكلب والخنزير والتملك بالمقارنة.
وبه يظهر حكم القاعدة الرابعة، فإن الحكم بجلب المنفعة أو درء المفسدة هو العقل الحصيف، لا قاعدة المصالح المرسلة، وإن كان في الجلب والدرء مصلحة، وبالجملة: الأمور الجانبية، ليست أساسا لحكم العقل في مورد هذه القواعد.
نحن نفترض أن لهذه المسائل طابعا عقليا كما أن لها طابعا استصلاحيا، فلو كان الوصول إليها من دليل العقل أمرا غير صحيح فليكن الوصول إليها عن طريق الاستصلاح مثله، فلماذا يوجه اللوم إلى الفريق الأول دون الثاني أو ليس هذا المورد من مصاديق المثل السائر: «رمتني بدائها وانسلت»؟
٭ ٭ ٭
هذه بعض الملاحظات على كلام الأستاذ حفظه الله ونفعنا بعلومه، وبقيت في كلامه أمور أخرى يظهر النظر فيها من بعض ما ذكرنا.
وفي الختام ندعو له ولعامة الإخوان في المملكة المغربية والأساتذة والطلاب في دار الحديث الحسنية بدوام التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم المقدسة، إيران. /غرة ربيع الأول 1426ه.
المصدر: مجلة الواضحة، العدد الثالث
والذي ألفت نظر الأستاذ إليه هو أن القياس ليس من باب المماثلة، بل من باب المشابهة، وكم هو الفرق بين التماثل والتشابه، فما ذكره من أن "ما ثبت لشيء ثبت لمثله" راجع إلى المتماثلين، والفرق بينهما واضح، وذلك لأن التماثل عبارة عن دخول شيئين تحت نوع واحد وطبيعة واحدة، فالتجربة في عدة من مصاديق طبيعية واحدة تفيد العلم بأن النتيجة لطبيعة الشيء لا لأفراد خاصة، ولذلك يقولون: إن التجربة تفيد العلم، وذلك بالبيان التالي:
إذا أجرينا مثلا تجربة على جزئيات من طبيعة واحدة كالحديد، تحت ظروف معينة من الضغط الجوي، والجاذبية، والارتفاع عن سطح البحر، وغيرها مع اتحادها جميعا في التركيب فوجدنا أنها تتمدد مقدارا معينا، ولنسمه (س)، عند درجة خاصة من الحرارة، ولنسمها (ح). ثم كررنا هذه التجربة على هذه الجزئيات في مراحل مختلفة في أمكنة متعددة، وتحت ظروف متغايرة ووجدنا النتيجة صادقة تماما: يتمدد الحديد بمقدار (س) عند درجة (ح)، فهنا نستكشف أن التمدد بهذا المقدار المعين معلول لتلك الدرجة الخاصة من الحرارة فقط، دون غيرها من العوامل، فعندئذ يقال: "ما ثبت لشيء ثبت لمثله"، أو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.
وأما التشابه فهو عبارة عن وقوع فردين مختلفي الطبيعة تحت صفة واحدة توجب التشابه بينهما، وهذا كالخمر والفقاع فإنهما نوعان وبينهما تشابه في الإسكار، فلو أثبتت التجربة أن للخمر أثرا خاصا لا يمكن القول بثبوته للفقاع والنبذي، بل لا بد من التماس الدليل على المشاركة وراء المشابهة.
وأوضح من ذلك مسألة الاستقراء، فإن ما نشاهده من الحيوانات البرية والبحرية، أنواع مختلفة، فلو رأينا هذا الحيوان البري وذلك الحيوان البحري كل يحرك فكه الأسفل عند المضغ ربما نحكم بلا جزم بذلك على سائر الحيوانات من دون أن تكون بينهما وحدة نوعية أو تماثل في الحقيقة، والدافع إلى ذلك التعدي في الحكم وهو التشابه والاشتراك الموجود بين أنواع الجنس الواحد، رغم اختلافها في الفصول والأشكال، ولكن لا يمكن الجزم بالحكم والنتيجة على وجهها الكلي، لإمكان اختلاف أفراد نوعين مختلفين في الحكم.
وبذلك يعلم أن القياس عبارة عن تعميم حكم مشابه إلى مشابه لا حكم مماثل إلى مماثل، ومن المعلوم أن تعميم الحكم من طبيعة إلى طبيعة أمر مشكل لا يصار إليه إلا إذا كان هنالك مساعدة من جانب العرف لإلغاء الخصوصية، وإلا يكون التعميم عملا بلا دليل.
مثلا، دل الكتاب العزيز على أن السارق والسارقة تقطع أيديهما، والحكم على عنوان السارق فهل يلحق به النباش الذي ينبش القبر لأخذ الأكفان؟ فإن التسوية بين العنوانين أمر مشكل، يقول السرخسي: «لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النباش بالسارق في حكم القطع، لأن القطع بالنص واجب على السارق».
والحاصل أن هناك فرقا واضحا بين فردين من طبيعة واحدة، فيصح تعميم حكم الفرد إلى الفرد الآخر لغاية اشتراكهما في النوعية، وأن حكم الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد، لكن بشرط أن يثبت أن الحكم من لوازم الطبيعة لا الخصوصيات الفردية.
وأما المتشابهان فهما فردان من طبيعيتين كالإنسان والفرس يجمعهما التشابه والتضاهي في شيء من الأشياء، فهل يصح تعميم حكم نوع إلى نوع آخر؟ كلا، إلا إذا دل الدليل على أن الوحدة الجنسية سبب الحكم ومناطه وملاكه التام، كما دل الدليل في أن سبب الحرمة في الخمر هو الإسكار، وإلا فلا يصح إسراء حكم من طبيعة إلى طبيعة أخرى بمجرد التشابه بينهما، أو الاشتراك في عرض من الأعراض.
▪ الدليل العقلي وحجية المصلحة
قد تعرفت على أن العقل أحد مصادر التشريع أو بالأحرى أحد المصادر لكشف الحكم الشرعي.
ومجال الحكم العقلي غالبا أحد الأمور التالية:
1- التحسين والتقبيح العقليان.
2- أبواب الملازمات: من قبيل الملازمة بين وجوب الشيء ومقدمته وحرمة ضده، والملازمة بين النهي عن العبادة أو المعاملة وفسادها إلى غير ذلك مما يرجع إلى باب الملازمة.
3- أبواب التزاحم: أي تزاحم المصالح التي لا بد من أخذها، كإنقاذ أحد الغريقين مع العجز عن إنقاذ كليهما، أو تزاحم المصالح والمفاسد كتترس العدو بالمسلمين، فإن للعقل دورا فيها، وله ضوابط لتقديم إحدى المصلحتين على الأخرى، أو تقديم المصلحة على المفسدة أو بالعكس (وهي مذكورة في مظانها).
ولا غبار على حجية العقل في هذه الموارد، إنما الكلام في حجية المصلحة وعدها من مصادر التشريع فيما لا نص فيه، فقد ذهب عدة من فقهاء السنة إلى حجية المصلحة، وسماها المالكية بالمصالح المرسلة، والغزالي بالاستصلاح، وحاصل دليلهم على حجية المصلحة وكونها من مصادر التشريع كالتالي:
إن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس.
وحاصل هذا الوجه ادعاء وجود النقص في التشريع الإسلامي لو اقتصر في مقام الاستنباط على الكتاب والسنة، لأن حاجات المجتمع إلى قوانين جديدة لا زالت تتزايد كل يوم، فإذا لم تكن هناك تشريعات تتلاءم مع هذه الحاجيات لم تتحقق مقاصد الشريعة.
ثم إن السبب لجعلهم المصالح مصادر للتشريع هو الأمور التالية:
1- إهمال العقل وعدم عده من مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح العقليين.
2- إقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع إقفالا سياسيا، فقد صار ذلك سببا لوقف الدراسات الفقهية منذ قرون، وفي ظل ذلك توهم المتأخرون وجود النقص في التشريع الإسلامي وعدم كفايته لتحقيق مقاصد الشريعة فلجأوا إلى عد المصالح المرسلة من مصادره، وبذلك وجهوا قول من يعتقد بحجية المصالح المرسلة من أئمة المذاهب.
3- عدم دراسة عناوين الأحكام الأولية والثانوية كأدلة الضرر والجرح والاضطرار والنسيان، فإن هذه العناوين وما يشابهها تحل أكثر المشاكل التي كان علماء السنة يواجهونها، من دون حاجة لعد الاستصلاح من مصادر التشريع.
4- عدم الاعتراف بصلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بوضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة ودفع المفسدة أحكاما مؤقتة ما دام الملاك موجودا.
والفرق بين الأحكام الواقعية والولائية هي أن الطائفة الأولى أحكام شرعية جاء بها النبي لتبقى خالدة إلى يوم القيامة، وأما الطائفة الثانية فإنما هي أحكام مؤقتة أو مقررات يضعها الحاكم الإسلامي (على ضوء سائر القوانين) لرفع المشاكل المتعلقة بحياة المجتمع الإسلامي.
هذه هي حقيقة المصالح المرسلة. ثم إنهم مثلوا للمقام بأمثلة، نذكر منها ما يلي:
1. جمع القران الكريم في مصحف بعد رحيل النبي.
2. قتال مانعي الزكاة.
3. وقف تنفيذ حكم السرقة في عام المجاعة.
4. إنشاء الدواوين.
5. سك النقود.
6. فرض الإمام العادل على الأغنياء من المال لا بد منه لتكثير الجند وإعداد السلاح وحماية البلاد وغير ذلك.
7. سجن المتهم كي لا يفر.
8. حجر المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس.
ثم إن بعض المغالين ربما يتجاوز، فيمثل بأمور لا تبررها أدلة التشريع الواقعي كتنفيذ الطلاق ثلاثا، مع أن الحكم الشرعي هو كونه طلاقا واحد في عصر النبي وبرهة بعد رحيله، وهذا من باب تقديم المصلحة على النص.
ثم إن للإمامية في العمل بالمصالح مذهبا وسطا أوضحناه في كتابنا، وليست الإمامية ممن ترفضه بتاتا كما تصوره الأستاذ أو تقبله في عامة الصور.
هذا إجمال الكلام في المصالح المرسلة -والتفصيل مع مالها وما فيها يطلب من محله- إذا عرفت ذلك فهلم معي نقرأ ما ذكره الدكتور الريسوني في هذا الموضوع، قال: «فتارة تدخل تحت اسم "الدليل العقلي" حيث يدرجون ضمنه -مثلا- اعتبار "الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار الحرمة"، وهذا عين اعتبار المصلحة. كما أن من القواعد المعتبرة عندهم ضمن دليل العقل قاعدة "وجوب مقدمة الواجب"، وهي المعبر عنها ب«ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، ذلك أن معظم المصالح المرسلة هي من قبيل "ما لا يتم الواجب إلا به"، فهي مقدمات أو وسائل لواجبات أخرى، ومثلها قاعدة "كل ما هو ضد الواجب فهو غير جائز"، فهذا ما يعبر عنه بدرء المفاسد. وتارة يدخلون العمل بالمصلحة من باب ما يسمى عندهم "السيرة العُقَلائية" أو "بناء العقلاء"، وهو في الوقت نفسه من المصالح المرسلة».
وحاصل كلامه: أنه تدخل تحت حجية المصلحة القواعد التالية:
1.وجوب مقدمة الواجب.
2. حرمة ضد الواجب.
3. حجية بناء العقلاء وسيرتهم.
4. الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار الحرمة.
فهي نفس العمل بالمصلحة مع أنهم يدخلونها تحت "الدليل العقلي".
يلاحظ عليه: أن اشتمال هذه القواعد على المصالح ودرء المفاسد غير كون المصلحة سببا لتشريعها ومبدأ لتقنينها، فإن الدليل على وجوب مقدمة الواجب أو حرمة ضد الواجب حكم العقل بالملازمة بين الإرادتين، فمن حاول الوقوف على السطح لا محيص له من إرادة نصب السلم، أو ركوب المصعد.
فاشتمال المقدمة على المصلحة أو اشتمال الضد على المفسدة أمر جانبي لا مدخلية له في الحكم بالوجوب والحرمة.
وأما حجية بناء العقلاء، فإن أساسها كونه بمرأى ومسمع من الشارع وهو إمضاؤه، لهذا لو كان غير مرضي عنده لما سكت عن النهي عنه، لقبح السكوت عما يجب إغراء الأمة، ولولا إمضاؤه لما صح الاعتماد عليه في الفقه، كما هو الحال في السير التي رفضها الشارع كبيع الخمر والكلب والخنزير والتملك بالمقارنة.
وبه يظهر حكم القاعدة الرابعة، فإن الحكم بجلب المنفعة أو درء المفسدة هو العقل الحصيف، لا قاعدة المصالح المرسلة، وإن كان في الجلب والدرء مصلحة، وبالجملة: الأمور الجانبية، ليست أساسا لحكم العقل في مورد هذه القواعد.
نحن نفترض أن لهذه المسائل طابعا عقليا كما أن لها طابعا استصلاحيا، فلو كان الوصول إليها من دليل العقل أمرا غير صحيح فليكن الوصول إليها عن طريق الاستصلاح مثله، فلماذا يوجه اللوم إلى الفريق الأول دون الثاني أو ليس هذا المورد من مصاديق المثل السائر: «رمتني بدائها وانسلت»؟
٭ ٭ ٭
هذه بعض الملاحظات على كلام الأستاذ حفظه الله ونفعنا بعلومه، وبقيت في كلامه أمور أخرى يظهر النظر فيها من بعض ما ذكرنا.
وفي الختام ندعو له ولعامة الإخوان في المملكة المغربية والأساتذة والطلاب في دار الحديث الحسنية بدوام التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم المقدسة، إيران. /غرة ربيع الأول 1426ه.
المصدر: مجلة الواضحة، العدد الثالث