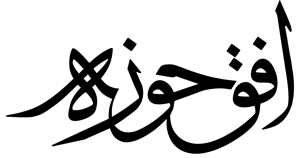

□ حوار/ الجزء الثالث
الثّابت والمتغيِّر في الشّريعة في حوار مع آيةالله الشيخ عيسى أحمد قاسم
▪ السّؤال الأوّل: إنّ قصور النّصّ عن تلبية احتياجات الواقع فتح الباب للتّطوير في أصول الفقه عند إخواننا السُّنة، ونشأت نظريّات مثل سدِّ الذرائع والمصالح المرسلة، فهل في الفقه الشيعيّ نظريّات مشابهة؟
عمليّة الاستنباط في المذهب الجعفريّ تعتمد العلم، وما يسمّى أيضاً بالعلميّ، فإمّا أن يكون الدليل المثبِت للحكم الشّرعي مفيداً للعلم به كما في آية كريمة هي نصّ في حكم شرعيّ معيّن، الآية الكريمة من الناحية الثّبوتيّة لا نقاش في سندها فالقرآن الكريم مقطوع به ومتيّقَن به، فمن هذه الناحية تكون القضيّة مفروغ عنها ولا بحث للفقيه فيها، بعكس الخبر فإنّه يحتاج إلى دراسة سنده، وهل صدر عن المعصومg أو لم يصدر منه.
إذا كانت الآية الكريمة وهي متيقّنة ممّا نزل به الوحي صريحة الدّلالة في مؤدّاها الذي يفيد حكماً شرعيّاً معيّناً فهذا الحكم يكون معلوماً للفقيه فلا توقّف في الأخذ به. ومن الأحكام الشَّرعيّة ما يملك هذه المرتبة من الثّبوت، وإنّما النّص الذي يدلّ عليه قد يكون ثبوته من ناحية السّند ظنّيّاً، ودلالة على مؤدّاه ظنّيّة، وقد يكون الحديث معلوم الصدور كالخبر المتواتر، لكن دلالة على مؤدّاه ظنّيّة، (والنتيجة تتبع أخس المقدّمات)، فهنا الفقيه يستفيد حكماً شرعيّاً، ولكن لا يجزم أنّه صادر عن المعصوم(ع)، فما العلاج؟
هذا النّوع من الخبر، وهذا النّوع من الدلالة، هل ينتهيان إلى دليل شرعيّ قطعيّ يعطيهما الحجيّة أم لا؟ خبر الثّقة -من ناحية السند- هذا الذي أوصل إلينا هذا الخبر فدرس الفقيه هذا الخبر فوجد أنّ كلّ رجال هذا السند ثقات، وكونهم ثقات هذا لا يعطي علماً بالصدور وإنّما يعطي ظنّاً بالصدور، وهذا الظنّ الذي يورثه خبر الثّقة فهل يوجد دليل قطعيّ يقول لي بأن آخذ خبر الثّقة؟ إذا وجد تمّت الحجّة فخبر الثّقة أعطى الاعتبار بواسطة دليل أقوى منه وهو الدليل القطعيّ، نعلم أنّه صدر من المعصوم(ع) إمّا قولٌ أو تقريرٌ بأنّ خبر الثّقة حجّة، أي تأخذون به. فهنا يأخذ به الفقيه.
الظنّ المستفاد من ظاهر الدليل، فالدليل مرة يكون صريحاً نصّاً في مدلوله، ومرّة يكون ليس نصاً صريحاً في مدلوله فيه معنى منه ظاهر، وتوجد احتمالات أن المقصود بالخبر ليس ما هو المستفاد بحسب الظهور. هل هناك دليل قطعيّ يقول لي إنّ هذا الظاهر يجب أن تُرتِّب عليه الأثر وهو حجّة؟ نعم يوجد دليلان قطعيّان، دليل يعطي خبر الثّقة الحجّيّة من ناحية السّند، ودليل قطعيّ يعطي خبر الظهور الحجّيّة من ناحية الدّلالة، فهنا يتم للفقيه استنباطه المسألة من هذا الخبر. وهذا ثبوت على المستوى العلميّ كما يسمّى، ظنٌّ معتبر بالدليل القطعيّ، وهذه هي طريقة الفقه الجعفريّ، إمّا أن ينتهي الاستدلال إلى العلم أو ينتهي إلى العلميّ.
أمّا البناء على ظنٍّ غير معتبر ولم يكن دليل قطعيّ على اعتباره والأخذ به من ناحية شرعيّة -فمع عدم وجود الدليل- فهذا الظنّ لا يؤخذ به ولا يصح الاعتماد عليه.
في مذهب الأخوة السّنّة فهم يأخذون بالقياس وبالاستحسان وبالمصالح المرسلة وبسدِّ الذرائع، ويأخذون بالكتاب والسُّنّة في استنباط الحكم الشّرعيّ.
القياس: الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبَطة من الحكم الأصل. يأتي الحكم الشّرعيّ وهذا الحكم الشّرعيّ يعمل الفقيه رأيه فيه، فيفكِّر فيه تفكيراً مليّاً دقيقاً فيبحث عن العلّة وراء هذا الحكم -لماذا شرَّع هذا الحكم؟- فالخمرُ لما شرِّعت حرمته؟ هل لغلائه أو لأمرٍ آخر؟ لإعطاء ارتياح للطّرف الشّارب؟ فيقول لإسكاره، فالفقيه يحدّد العلّة وهذه ليست منصوصة، فيعمِّم الحكم وهذا هو الأصل، والفرع هو حرمة الفقّاع مثلاً، فيقول: إنّ الفقّاع حرام، وكلّ مسكر حرام لأنّ الحكم يدور مدار علّته وجوداً وعدماً، فما وجد فيه الإسكار فقد وجدت فيه علّة التحريم.
الاستحسان: هو ما يستحسنه المجتهد في حكم معين بعقله البشريّ. ويعرف كذلك بأنّه دليل في نفس المجتهد ولا يقدر على التعبير عنه، حالة حدسيّة عنده
المصالح المرسلة: هي ما لا تستند إلى أصل كلّيّ أو جزئيّ في الشّرعيّة.
سدّ الذّرائع: هي ما كان وسيلة لمصلحة أو مفسدة، أي ما يكون لمصلحة واجبة التحصيل فيجب، وما يكون طريقاً إلى مفسدة محرّمة فيحرم. وليس أن يكون مقطوعاً بأن يكون مقدّمة، فكلّ ما يتصوّر أن يكون ذريعة ويمكن أن يوصل فيحرم إذا كان ذريعة للمحرّم، وإذا كان ذريعة من ذرائع الواجب فيجب، لمجرّد المصلحة.
هذه الطرق الأربعة تجتمع في نتيجة واحدة وهي أنَّ الفقيه يتوصَّل إلى ظنٍّ بمقدار سبعين إلى ثمانين بالمِائة إلى أنّ هذا حكم شرعيّ.
نسأل هذا الظنّ هل أُعتبُر شرعاً، المعروف أنّ الظنّ في نفسِه ليس حجّة شرعيّة [إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً] (سورة النجم: 28). فالظنّ في نفسِه ليس حجّة شرعيّة، لا بدّ من دليل شرعيٍّ يثبت حجّية هذا الظنّ، وهذا الدّليل الثّاني إذا كان ظنّاً جاءت نفس المناقشة فلا بدّ من أن يكون دليلاً قطعيّاً، ولذلك في المذهب الجعفريّ إمّا علمٌ وإمّا علميٌّ، بمعنى أن يقوم دليلٌ قطعيّ بحجّيّة السند وعلى حجّيّة المدلول والمضمون. ففي المذهب الجعفري لا تُعتمد أيّ وسيلة من وسائل الاستنباط إذا كانت تقف بالمجتهد عند حدّ الظنّ الذي لم يقم دليل قطعيٌّ على اعتباره وحجّيّته.
▪ السّؤال الثّاني: إنَّ قول المسيح لبني إسرائيل: [وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ]، وثبوت النَّسخ ضمن الشّريعة الواحدة، ونسخ الشّريعة لبعض ما في شريعة قبلها دليل على تأثير الزّمان والتّطور الحضاريّ في الحكم الشَّرعيّ، فلماذا توقّف هذا التأثير في زماننا؟
ليس هناك إنكار بأنّ للزّمان والمكان وحركة التّطوّر الحضاريّ أثراً على بعض الأحكام، ولكنّ هذه القضيّة هل تستلزم نسخ بعض الأحكام؟ والنسخ معناه محدوديّة أمد الحكم، بحيث إنّه عند النّقطة الزّمانية المعيّنة يرتفع الحكم نهائيّاً ويفقد كلّ وجوده، وحتى لو وجد الحكم في الخارج وتوفّرت شروطه فإذا كان حكماً منسوخاً فهذا لا يعطي الحكم فاعليّة، بمعنى أنّ الحكم انتهى ولا وجود له.
هل تطوُّر الزّمان يستوجب دائماً أن ترتفع الأحكام؟
لدينا في الشّريعة الإسلاميّة حسابٌ لحركة الزّمان واختلاف المكان، هناك أدلّة تعالج الجانب الثّابت من حركة الإنسان ووجوده وحياته، وهناك أدلّة لديها نظر بعيد يتماشى مع حركة المتطوّر من حركة الإنسان.
صحيح أنّ الدليل ثابت قبل ألف وأربعمِائة سنة، ولكنّ هذا الدليل قد نظر إلى المدى الزّمنيّ كلّه، وحمَل مرونةً بحسب هذا النظر بما يغطي حاجة الحركة والتطور على طول الزّمان، وهذا تعويض عن النَّسخ فلا حاجة للنَّسخ، وإذا قلنا حكم أوّليّ وحكم ثانويّ فليس لدينا حكم في الشّريعة يرتفع، وإنّما الحكم الذي يستجدّ موضوعه أو يصبح في حالة تزاحم مع حكم آخر يقدَّم عليه، فهذا الحكم لا ينتهي وهو باق وكل ما هنالك أنّ الحكم متغيّر. وفي حال رجع الموضوع إلى طبيعته الأوّليّة فالحكمُ الأوّليّ موجود.
فكون الشّارع المقدَّس يضعُ حُكماً على موضوع معيّن وكما تسمّى ب(القضيّة الحقيقيّة)، ويأخذ فيها الموضوع مقدَّر الوجود، بمعنى كلّما -مثلاً- وجد المكلّف المستطيع للحجّ والمتوفِّر على شروط الحجّ ومع ارتفاع الموانع؛ كلَّما وجب عليه الحجّ، فهذه عمليّة وضع، وجعل، واعتبار، وتقنين، وتشريع، فهذه مرحلة. ويولد شيء وهميّ يسمّى مجعولاً؛ وهي قضيّة كلّية وليس لها وجود في الخارج وإنّما موجود يتصوّره العقل، وهو قضية تقول: كلَّما وُجد مكلَّف واستطاع الحجّ وجب عليه الحجّ.
فالمرحلة الأولى: عمليّة جعل وتنسيب الحكم إلى موضوعه تنسيباً اعتباريّاً، جعليّاً قانونيّاً، تشرّعيّاً.
والمرحلة الثّانية: القضيّة الكلّيّة العامّة وهي: كلّما قدّر وجود مكلّف في الخارج متوفّر على الاستطاعة والموانع منتفيّة في حقّه، كلّما وجب عليه الحجّ.
مثال: وُجد الحاجّ سلمان في الخارج، ووُجدت عنده الاستطاعة، ولكن استجدّ أمر وهو قبل الاستطاعة، فقبل البلوغ كانت القضية تقديريّة بالنسبة إليه، فلقد كان الوجوب تقديريّاً. ولكنّه بلغ وصار عنده استطاعة، فيوجد شيء اسمه موضوع فعليّ شرعيّ، بمعنى أنّ الحكم تنجّز فعلاً في حقّه وصار مخاطباً بالحجّ، فقبل الاستطاعة كانت تنقصه خمسين دينار فلم يكن مخاطَباً بالحجّ. فهذه مرحلة التنجّز ومرحلة الفعليّة.
مثال ذلك: قضية أنّ شرب الخمر حرام، فهذا اضطّر إلى الخمر وانحصر دواءه فيه، فجاء عنوان أنّ الحكم كان موضوعاً على ذات الخمر، وعلى عنوان الخمر أنّه حرام، ولكن أمامي الآن ليس مكلَّف وخمر، وإنّما أمامي مكلَّف وخمر والمكلَّف مضطّر إلى الخمر. فيأخذ حكم إباحة تناول الخمر بقدر الضرورة. وحكم أنّ الخمر حرام هل انتهى؟ لا، لم ينتهي، ولكنّه ليس فعليّاً، فما دام مضطّراً فلا فعليّة في الحرمة وليس مخاطَباً بحرمة التّناول، وإنّما عنده حكم إباحة وهذا في مرحلة الفعليّة.
وأمّا مرحلة الجعل والمجعول فالحكم (أنّ الخمر حرام) باقٍ على حاله، فما إن يرتفع اضطراره فالحكم الأوّليّ فعليّ في حقّه. فهناك عدد من الطّرق عند الفقهاء تسمح لهم بإعطاء أجوبة شرعيّة بالنّسبة للمستجدّات المختلفة في مختلف ميادين الحياة. والإسلام بما توفَّر عليه من تشريعات لم تتوفّر عليها رسالة سماويّة قبله، يوجِد تشريعات وقواعد عامّة وأدلّة عامّة.
وضيق الإمامة المعصومة وإنّه لو امتدّ وجود الأئمةi الامتداد الطبيعيّ لحياتهمi سيقدّمون إجابات مغطّية لحركة الحياة بشكل كبير جدّاً وهي واقعيّة جداً. وهذا ليس من مسؤوليّة الإسلام أنّ الأمّة حرمت نفسها منه.
فالأئمة(ع) لو عاشوا حياتهم الطّبيعيّة ومارسوا دور الإمامة كما أوجب اللهُ تبارك وتعالى، فمستوى رشد الأمّة والعلم الواسع للأمّة سيبلغ درجةً كبيرةً جداً تساعد على فهم الإسلام بدرجةٍ عاليةٍ أكثر من الآن، بحيث تعطي قدرة عاليةً على فهم القضايا المستجدّة من الشّريعة الإسلاميّة.
▪ االسّؤال الثّالث: نعلم أنّ حقّ التّشريع بالأصالة لله وحده، فهل الدور الذي يقوم به الفقهاء عند تبديل حكمِ مسألةٍ في موضوع من الإباحة إلى الحرمة والعكس تشريعٌ منهم، بحيث ينافي حصر التّشريع في الله سبحانه وتعالى؟
حقّ التّشريع بالأصالة لله(عز) وحده لا يشاركه فيه أحد، هو المالك ولا مالك غيره، وبذلك لا حقّ لأحدٍ للطّاعة على أحدٍ إلّا بالأصل لله وحده، فالمالك هو من له حقّ الطّاعة. أنت أجنبيّ منّي وأنا أجنبيّ منك خلقاً، فلم تخلقني ولم أخلقك، فلا تملكني ولا أملكك، ولا حقّ لي أن أشرّع لك، ولا حقّ لك بالتّشريع لي. والنّبيّ(ص) بما هو بشر -وبغض النّظر عن النّبوّة- ليس له أن يقدّم أو أن يؤخِّر، وما لم يعطَ الرّسول(ص) حقّ التّشريع الجزئيّ من الله(عز) في مساحة محدودة وهي تحت علم الله(عز) فليس له حقّ التّشريع. فالفقيه ليس له حقّ التّشريع لا بالأصالة ولا بالتّبع، فإذا كان الرّسول(ص) له حقّ التّشريع الجزئيّ بالتبع، فالفقيه لا حقّ له في التّشريع بالأصالة ولم يؤذن من معصوم بأن يشرِّع -فالفقهاء لا يشرِّعون-، وإنّما عمله استنباط حكم شرعيّ من مصادر الشّريعة، وسواء كان حكماً أوّليّاً أو ثانويّاً لا فرق بينهما، وهو محكوم في استنباطه لاتباع الدّليل ولا حقّ له في زيادة ولا نقصان، ورأيه الشّخصي وعنديّاته لا دخل له في إثبات حكم شرعيّ، ولذلك فإنّ الفقهاء يحترسون في عمليّة الاستنباط بأن يفتِّش عن نفسه هل ميله لهذا الفهم يمكن أن يكون صادراً من حبّ، من بغض، من خوف، فيراقب نفسه من أجل أن يكون استنباطه الحكم الشّرعي لا مرجع له إلّا خوف الله ودلالة الدّليل، ولذلك قالوا: (إنّ الفقيهَ عبدُ الدّليل).
إنتهی ویلیه الجزء الرابع والأخیر في العدد المستقبل
المصدر: مجلة بقیة الله، العدد 70
عمليّة الاستنباط في المذهب الجعفريّ تعتمد العلم، وما يسمّى أيضاً بالعلميّ، فإمّا أن يكون الدليل المثبِت للحكم الشّرعي مفيداً للعلم به كما في آية كريمة هي نصّ في حكم شرعيّ معيّن، الآية الكريمة من الناحية الثّبوتيّة لا نقاش في سندها فالقرآن الكريم مقطوع به ومتيّقَن به، فمن هذه الناحية تكون القضيّة مفروغ عنها ولا بحث للفقيه فيها، بعكس الخبر فإنّه يحتاج إلى دراسة سنده، وهل صدر عن المعصومg أو لم يصدر منه.
إذا كانت الآية الكريمة وهي متيقّنة ممّا نزل به الوحي صريحة الدّلالة في مؤدّاها الذي يفيد حكماً شرعيّاً معيّناً فهذا الحكم يكون معلوماً للفقيه فلا توقّف في الأخذ به. ومن الأحكام الشَّرعيّة ما يملك هذه المرتبة من الثّبوت، وإنّما النّص الذي يدلّ عليه قد يكون ثبوته من ناحية السّند ظنّيّاً، ودلالة على مؤدّاه ظنّيّة، وقد يكون الحديث معلوم الصدور كالخبر المتواتر، لكن دلالة على مؤدّاه ظنّيّة، (والنتيجة تتبع أخس المقدّمات)، فهنا الفقيه يستفيد حكماً شرعيّاً، ولكن لا يجزم أنّه صادر عن المعصوم(ع)، فما العلاج؟
هذا النّوع من الخبر، وهذا النّوع من الدلالة، هل ينتهيان إلى دليل شرعيّ قطعيّ يعطيهما الحجيّة أم لا؟ خبر الثّقة -من ناحية السند- هذا الذي أوصل إلينا هذا الخبر فدرس الفقيه هذا الخبر فوجد أنّ كلّ رجال هذا السند ثقات، وكونهم ثقات هذا لا يعطي علماً بالصدور وإنّما يعطي ظنّاً بالصدور، وهذا الظنّ الذي يورثه خبر الثّقة فهل يوجد دليل قطعيّ يقول لي بأن آخذ خبر الثّقة؟ إذا وجد تمّت الحجّة فخبر الثّقة أعطى الاعتبار بواسطة دليل أقوى منه وهو الدليل القطعيّ، نعلم أنّه صدر من المعصوم(ع) إمّا قولٌ أو تقريرٌ بأنّ خبر الثّقة حجّة، أي تأخذون به. فهنا يأخذ به الفقيه.
الظنّ المستفاد من ظاهر الدليل، فالدليل مرة يكون صريحاً نصّاً في مدلوله، ومرّة يكون ليس نصاً صريحاً في مدلوله فيه معنى منه ظاهر، وتوجد احتمالات أن المقصود بالخبر ليس ما هو المستفاد بحسب الظهور. هل هناك دليل قطعيّ يقول لي إنّ هذا الظاهر يجب أن تُرتِّب عليه الأثر وهو حجّة؟ نعم يوجد دليلان قطعيّان، دليل يعطي خبر الثّقة الحجّيّة من ناحية السّند، ودليل قطعيّ يعطي خبر الظهور الحجّيّة من ناحية الدّلالة، فهنا يتم للفقيه استنباطه المسألة من هذا الخبر. وهذا ثبوت على المستوى العلميّ كما يسمّى، ظنٌّ معتبر بالدليل القطعيّ، وهذه هي طريقة الفقه الجعفريّ، إمّا أن ينتهي الاستدلال إلى العلم أو ينتهي إلى العلميّ.
أمّا البناء على ظنٍّ غير معتبر ولم يكن دليل قطعيّ على اعتباره والأخذ به من ناحية شرعيّة -فمع عدم وجود الدليل- فهذا الظنّ لا يؤخذ به ولا يصح الاعتماد عليه.
في مذهب الأخوة السّنّة فهم يأخذون بالقياس وبالاستحسان وبالمصالح المرسلة وبسدِّ الذرائع، ويأخذون بالكتاب والسُّنّة في استنباط الحكم الشّرعيّ.
القياس: الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبَطة من الحكم الأصل. يأتي الحكم الشّرعيّ وهذا الحكم الشّرعيّ يعمل الفقيه رأيه فيه، فيفكِّر فيه تفكيراً مليّاً دقيقاً فيبحث عن العلّة وراء هذا الحكم -لماذا شرَّع هذا الحكم؟- فالخمرُ لما شرِّعت حرمته؟ هل لغلائه أو لأمرٍ آخر؟ لإعطاء ارتياح للطّرف الشّارب؟ فيقول لإسكاره، فالفقيه يحدّد العلّة وهذه ليست منصوصة، فيعمِّم الحكم وهذا هو الأصل، والفرع هو حرمة الفقّاع مثلاً، فيقول: إنّ الفقّاع حرام، وكلّ مسكر حرام لأنّ الحكم يدور مدار علّته وجوداً وعدماً، فما وجد فيه الإسكار فقد وجدت فيه علّة التحريم.
الاستحسان: هو ما يستحسنه المجتهد في حكم معين بعقله البشريّ. ويعرف كذلك بأنّه دليل في نفس المجتهد ولا يقدر على التعبير عنه، حالة حدسيّة عنده
المصالح المرسلة: هي ما لا تستند إلى أصل كلّيّ أو جزئيّ في الشّرعيّة.
سدّ الذّرائع: هي ما كان وسيلة لمصلحة أو مفسدة، أي ما يكون لمصلحة واجبة التحصيل فيجب، وما يكون طريقاً إلى مفسدة محرّمة فيحرم. وليس أن يكون مقطوعاً بأن يكون مقدّمة، فكلّ ما يتصوّر أن يكون ذريعة ويمكن أن يوصل فيحرم إذا كان ذريعة للمحرّم، وإذا كان ذريعة من ذرائع الواجب فيجب، لمجرّد المصلحة.
هذه الطرق الأربعة تجتمع في نتيجة واحدة وهي أنَّ الفقيه يتوصَّل إلى ظنٍّ بمقدار سبعين إلى ثمانين بالمِائة إلى أنّ هذا حكم شرعيّ.
نسأل هذا الظنّ هل أُعتبُر شرعاً، المعروف أنّ الظنّ في نفسِه ليس حجّة شرعيّة [إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً] (سورة النجم: 28). فالظنّ في نفسِه ليس حجّة شرعيّة، لا بدّ من دليل شرعيٍّ يثبت حجّية هذا الظنّ، وهذا الدّليل الثّاني إذا كان ظنّاً جاءت نفس المناقشة فلا بدّ من أن يكون دليلاً قطعيّاً، ولذلك في المذهب الجعفريّ إمّا علمٌ وإمّا علميٌّ، بمعنى أن يقوم دليلٌ قطعيّ بحجّيّة السند وعلى حجّيّة المدلول والمضمون. ففي المذهب الجعفري لا تُعتمد أيّ وسيلة من وسائل الاستنباط إذا كانت تقف بالمجتهد عند حدّ الظنّ الذي لم يقم دليل قطعيٌّ على اعتباره وحجّيّته.
▪ السّؤال الثّاني: إنَّ قول المسيح لبني إسرائيل: [وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ]، وثبوت النَّسخ ضمن الشّريعة الواحدة، ونسخ الشّريعة لبعض ما في شريعة قبلها دليل على تأثير الزّمان والتّطور الحضاريّ في الحكم الشَّرعيّ، فلماذا توقّف هذا التأثير في زماننا؟
ليس هناك إنكار بأنّ للزّمان والمكان وحركة التّطوّر الحضاريّ أثراً على بعض الأحكام، ولكنّ هذه القضيّة هل تستلزم نسخ بعض الأحكام؟ والنسخ معناه محدوديّة أمد الحكم، بحيث إنّه عند النّقطة الزّمانية المعيّنة يرتفع الحكم نهائيّاً ويفقد كلّ وجوده، وحتى لو وجد الحكم في الخارج وتوفّرت شروطه فإذا كان حكماً منسوخاً فهذا لا يعطي الحكم فاعليّة، بمعنى أنّ الحكم انتهى ولا وجود له.
هل تطوُّر الزّمان يستوجب دائماً أن ترتفع الأحكام؟
لدينا في الشّريعة الإسلاميّة حسابٌ لحركة الزّمان واختلاف المكان، هناك أدلّة تعالج الجانب الثّابت من حركة الإنسان ووجوده وحياته، وهناك أدلّة لديها نظر بعيد يتماشى مع حركة المتطوّر من حركة الإنسان.
صحيح أنّ الدليل ثابت قبل ألف وأربعمِائة سنة، ولكنّ هذا الدليل قد نظر إلى المدى الزّمنيّ كلّه، وحمَل مرونةً بحسب هذا النظر بما يغطي حاجة الحركة والتطور على طول الزّمان، وهذا تعويض عن النَّسخ فلا حاجة للنَّسخ، وإذا قلنا حكم أوّليّ وحكم ثانويّ فليس لدينا حكم في الشّريعة يرتفع، وإنّما الحكم الذي يستجدّ موضوعه أو يصبح في حالة تزاحم مع حكم آخر يقدَّم عليه، فهذا الحكم لا ينتهي وهو باق وكل ما هنالك أنّ الحكم متغيّر. وفي حال رجع الموضوع إلى طبيعته الأوّليّة فالحكمُ الأوّليّ موجود.
فكون الشّارع المقدَّس يضعُ حُكماً على موضوع معيّن وكما تسمّى ب(القضيّة الحقيقيّة)، ويأخذ فيها الموضوع مقدَّر الوجود، بمعنى كلّما -مثلاً- وجد المكلّف المستطيع للحجّ والمتوفِّر على شروط الحجّ ومع ارتفاع الموانع؛ كلَّما وجب عليه الحجّ، فهذه عمليّة وضع، وجعل، واعتبار، وتقنين، وتشريع، فهذه مرحلة. ويولد شيء وهميّ يسمّى مجعولاً؛ وهي قضيّة كلّية وليس لها وجود في الخارج وإنّما موجود يتصوّره العقل، وهو قضية تقول: كلَّما وُجد مكلَّف واستطاع الحجّ وجب عليه الحجّ.
فالمرحلة الأولى: عمليّة جعل وتنسيب الحكم إلى موضوعه تنسيباً اعتباريّاً، جعليّاً قانونيّاً، تشرّعيّاً.
والمرحلة الثّانية: القضيّة الكلّيّة العامّة وهي: كلّما قدّر وجود مكلّف في الخارج متوفّر على الاستطاعة والموانع منتفيّة في حقّه، كلّما وجب عليه الحجّ.
مثال: وُجد الحاجّ سلمان في الخارج، ووُجدت عنده الاستطاعة، ولكن استجدّ أمر وهو قبل الاستطاعة، فقبل البلوغ كانت القضية تقديريّة بالنسبة إليه، فلقد كان الوجوب تقديريّاً. ولكنّه بلغ وصار عنده استطاعة، فيوجد شيء اسمه موضوع فعليّ شرعيّ، بمعنى أنّ الحكم تنجّز فعلاً في حقّه وصار مخاطباً بالحجّ، فقبل الاستطاعة كانت تنقصه خمسين دينار فلم يكن مخاطَباً بالحجّ. فهذه مرحلة التنجّز ومرحلة الفعليّة.
مثال ذلك: قضية أنّ شرب الخمر حرام، فهذا اضطّر إلى الخمر وانحصر دواءه فيه، فجاء عنوان أنّ الحكم كان موضوعاً على ذات الخمر، وعلى عنوان الخمر أنّه حرام، ولكن أمامي الآن ليس مكلَّف وخمر، وإنّما أمامي مكلَّف وخمر والمكلَّف مضطّر إلى الخمر. فيأخذ حكم إباحة تناول الخمر بقدر الضرورة. وحكم أنّ الخمر حرام هل انتهى؟ لا، لم ينتهي، ولكنّه ليس فعليّاً، فما دام مضطّراً فلا فعليّة في الحرمة وليس مخاطَباً بحرمة التّناول، وإنّما عنده حكم إباحة وهذا في مرحلة الفعليّة.
وأمّا مرحلة الجعل والمجعول فالحكم (أنّ الخمر حرام) باقٍ على حاله، فما إن يرتفع اضطراره فالحكم الأوّليّ فعليّ في حقّه. فهناك عدد من الطّرق عند الفقهاء تسمح لهم بإعطاء أجوبة شرعيّة بالنّسبة للمستجدّات المختلفة في مختلف ميادين الحياة. والإسلام بما توفَّر عليه من تشريعات لم تتوفّر عليها رسالة سماويّة قبله، يوجِد تشريعات وقواعد عامّة وأدلّة عامّة.
وضيق الإمامة المعصومة وإنّه لو امتدّ وجود الأئمةi الامتداد الطبيعيّ لحياتهمi سيقدّمون إجابات مغطّية لحركة الحياة بشكل كبير جدّاً وهي واقعيّة جداً. وهذا ليس من مسؤوليّة الإسلام أنّ الأمّة حرمت نفسها منه.
فالأئمة(ع) لو عاشوا حياتهم الطّبيعيّة ومارسوا دور الإمامة كما أوجب اللهُ تبارك وتعالى، فمستوى رشد الأمّة والعلم الواسع للأمّة سيبلغ درجةً كبيرةً جداً تساعد على فهم الإسلام بدرجةٍ عاليةٍ أكثر من الآن، بحيث تعطي قدرة عاليةً على فهم القضايا المستجدّة من الشّريعة الإسلاميّة.
▪ االسّؤال الثّالث: نعلم أنّ حقّ التّشريع بالأصالة لله وحده، فهل الدور الذي يقوم به الفقهاء عند تبديل حكمِ مسألةٍ في موضوع من الإباحة إلى الحرمة والعكس تشريعٌ منهم، بحيث ينافي حصر التّشريع في الله سبحانه وتعالى؟
حقّ التّشريع بالأصالة لله(عز) وحده لا يشاركه فيه أحد، هو المالك ولا مالك غيره، وبذلك لا حقّ لأحدٍ للطّاعة على أحدٍ إلّا بالأصل لله وحده، فالمالك هو من له حقّ الطّاعة. أنت أجنبيّ منّي وأنا أجنبيّ منك خلقاً، فلم تخلقني ولم أخلقك، فلا تملكني ولا أملكك، ولا حقّ لي أن أشرّع لك، ولا حقّ لك بالتّشريع لي. والنّبيّ(ص) بما هو بشر -وبغض النّظر عن النّبوّة- ليس له أن يقدّم أو أن يؤخِّر، وما لم يعطَ الرّسول(ص) حقّ التّشريع الجزئيّ من الله(عز) في مساحة محدودة وهي تحت علم الله(عز) فليس له حقّ التّشريع. فالفقيه ليس له حقّ التّشريع لا بالأصالة ولا بالتّبع، فإذا كان الرّسول(ص) له حقّ التّشريع الجزئيّ بالتبع، فالفقيه لا حقّ له في التّشريع بالأصالة ولم يؤذن من معصوم بأن يشرِّع -فالفقهاء لا يشرِّعون-، وإنّما عمله استنباط حكم شرعيّ من مصادر الشّريعة، وسواء كان حكماً أوّليّاً أو ثانويّاً لا فرق بينهما، وهو محكوم في استنباطه لاتباع الدّليل ولا حقّ له في زيادة ولا نقصان، ورأيه الشّخصي وعنديّاته لا دخل له في إثبات حكم شرعيّ، ولذلك فإنّ الفقهاء يحترسون في عمليّة الاستنباط بأن يفتِّش عن نفسه هل ميله لهذا الفهم يمكن أن يكون صادراً من حبّ، من بغض، من خوف، فيراقب نفسه من أجل أن يكون استنباطه الحكم الشّرعي لا مرجع له إلّا خوف الله ودلالة الدّليل، ولذلك قالوا: (إنّ الفقيهَ عبدُ الدّليل).
إنتهی ویلیه الجزء الرابع والأخیر في العدد المستقبل
المصدر: مجلة بقیة الله، العدد 70