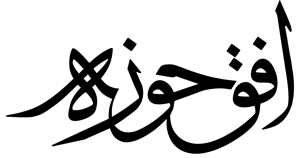

مصطلح الأسبوع
البداء
البداء في اللغة يعني الظهور بعد الخفاء، كقولهم: «بدا لي أمر»، أي تبيّن بعد أن لم يكن ظاهرًا. غير أنّ هذا المعنى اللغوي يستحيل نسبته إلى الله تعالى، لأنّه يقتضي الجهل أو تجدّد العلم، والله سبحانه منزّه عن ذلك، إذ علمه أزليّ محيط بكلّ شيء في السماوات والأرض، ولا يخفى عليه مثقال ذرّة. وهذا ما أجمعت عليه الإمامية صراحة، فهم ينفون عن الله أي ظهورٍ ناشئ عن خفاء أو جهل.
وعليه، فإنّ ما تنسبه بعض الاتهامات إلى الإمامية من القول ببداءٍ يستلزم الجهل الإلهي هو افتراء لا سند له من كتبهم ولا من رواياتهم. فالبداء عند الإمامية لا يعني الظهور بعد الخفاء، بل يعني الإظهار بعد الإخفاء؛ أي إظهار الله تعالى لعباده ما كان خافيًا عليهم، لا ما كان خافيًا عليه سبحانه. واستعمال لفظ «البداء» هنا اصطلاحي، نشأ على أساس المشاكلة البلاغية، وهي استعمال لفظٍ في غير معناه الحقيقي لمناسبته لما جاوره في الكلام، كما في نسبة «المكر» إلى الله في القرآن، مع تنزيهه عن الخديعة.
وبهذا المعنى، فالبداء هو تعبير عن تدبيرٍ إلهيّ تقوم بعض أجزائه على التعليق والتغيير والتقديم والتأخير، مع علم الله الأزلي بما سيقع فعلًا. فالله يشاء أن يربط بعض المقدّرات بشروط، كالإيمان أو التقوى أو النصرة، فإن تحقّقت تحقّق أثرها، وإن انتفت انتفى، دون أن يستلزم ذلك تغيّرًا في علمه.
وقد دلّت آيات كثيرة على هذا النحو من المشيئة، كربط البركات بالإيمان، والنصر بنصرة الله، وتغيير الأحوال بتغيير النفوس. وهذا هو المعبَّر عنه بالقضاء غير المحتوم أو الموقوف، وهو مجال المحو والإثبات، بخلاف «أمّ الكتاب» الذي يمثّل العلم الإلهي الثابت.
كما أكّدت الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت(ع) أنّ الله يمحو ويثبت ويقدّم ويؤخّر، مع التأكيد القطعي على أنّ ذلك كلّه واقع ضمن علمه الأزلي، وأنّ «البداء» لا ينشأ عن جهل، بل عن حكمة في تدبير الخلق. وبذلك يتّضح أنّ الخلاف حول البداء هو في الفهم لا في المضمون، وأنّ الطعن فيه ناشئ من سوء التصوّر لحقيقته.
وعليه، فإنّ ما تنسبه بعض الاتهامات إلى الإمامية من القول ببداءٍ يستلزم الجهل الإلهي هو افتراء لا سند له من كتبهم ولا من رواياتهم. فالبداء عند الإمامية لا يعني الظهور بعد الخفاء، بل يعني الإظهار بعد الإخفاء؛ أي إظهار الله تعالى لعباده ما كان خافيًا عليهم، لا ما كان خافيًا عليه سبحانه. واستعمال لفظ «البداء» هنا اصطلاحي، نشأ على أساس المشاكلة البلاغية، وهي استعمال لفظٍ في غير معناه الحقيقي لمناسبته لما جاوره في الكلام، كما في نسبة «المكر» إلى الله في القرآن، مع تنزيهه عن الخديعة.
وبهذا المعنى، فالبداء هو تعبير عن تدبيرٍ إلهيّ تقوم بعض أجزائه على التعليق والتغيير والتقديم والتأخير، مع علم الله الأزلي بما سيقع فعلًا. فالله يشاء أن يربط بعض المقدّرات بشروط، كالإيمان أو التقوى أو النصرة، فإن تحقّقت تحقّق أثرها، وإن انتفت انتفى، دون أن يستلزم ذلك تغيّرًا في علمه.
وقد دلّت آيات كثيرة على هذا النحو من المشيئة، كربط البركات بالإيمان، والنصر بنصرة الله، وتغيير الأحوال بتغيير النفوس. وهذا هو المعبَّر عنه بالقضاء غير المحتوم أو الموقوف، وهو مجال المحو والإثبات، بخلاف «أمّ الكتاب» الذي يمثّل العلم الإلهي الثابت.
كما أكّدت الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت(ع) أنّ الله يمحو ويثبت ويقدّم ويؤخّر، مع التأكيد القطعي على أنّ ذلك كلّه واقع ضمن علمه الأزلي، وأنّ «البداء» لا ينشأ عن جهل، بل عن حكمة في تدبير الخلق. وبذلك يتّضح أنّ الخلاف حول البداء هو في الفهم لا في المضمون، وأنّ الطعن فيه ناشئ من سوء التصوّر لحقيقته.