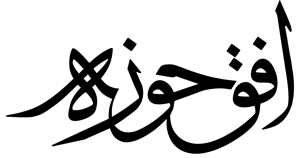

التعددية والمعارضة السياسية عند أمير المؤمنين(ع)
ينطلق فهمنا للسياسة في الإسلام من جملة منطلقات، تفرضها البداهة الاجتماعية ويقرها الوضع الإنساني لأي تجمع بشري كحالة صحية لازمة لإنجاح البناء المجتمعي في كل زمان ومكان، ومن هذه المنطلقات، هو التعددية السياسية، كلازمة مجتمعية لا يمكن تذويبها ولا يقبل الإسلام دمجها تحت عنوان الوحدة بما يمحو التنوع فيها.
والتعددية سنة ربانية فيما خلق الله وأبدع، بدء من تعدد أنواع الجنس الواحد من المخلوقات وانتهاء بألوان وألسن البشر فضلا عن طبائعهم وعاداتهم وأنماط تفكيرهم، وهو ما يحتم علينا أن لا نبالغ في خطر التنوع السياسي ـ ولا نقصد هنا السياسة بمفهومها الحزبي القائم إنما بتعدد وجهات النظر حيال القرارات المجتمعية المهمة ـ كون هذا التنوع جزء من التنوع الخَلقي تبارك وتعالى مبدعه.
وانطلاقا من قوله جل وعلا(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(الحجرات ـ13)، نجد أن الإسلام يدعو بما لا شك فيه إلى الاهتمام بالوحدة الإنسانية من خلال الحفاظ على تنوعها وليس تذويب أنواعها في بوتقة واحدة، وعلى هذا يؤسس لمبادئ عامة في احترام التنوع مهما كان ـ اثنيا او دينيا او فكريا او عقائديا او قبائليا ـ باعتباره الحل الحقيقي في صناعة المجتمع المثال وبالتالي الفرد المثال، بعد أن يؤسس ـ الإسلام ـ للازمة وضابطة تدفع لمثالية الفرد ـ ومن خلاله المجتمع ـ بغض النظر عن انتماءه، إلا وهي ضابطة التقوى المشار إليها في ختام الآية الشريفة أعلاه، خصوصا وإنها في مورد خطاب الناس وليس المسلمين أو المؤمنين أو غير ذلك من التوصيفات.
بل واعتبر الإسلام من خلال القرآن الكريم هذا التنوع، آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى، ونعمة منه وفضل، وهو ما يحتاج لتأمل وتدبر وشكران على ما أنعم(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ)(الروم ـ22).
والأصل في ضرورة التنوع الإنساني هو اللا قهر واللا جبر السيسيولوجي، بما في ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى من عدمه، احتكاما لقاعدة التخيير التي سنها القرآن الكريم في انتهاج المنهج والوجهة التي يريدها المرء(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة ـ156).
ومن باب اللا إكراه في الانتماء ـ بما في ذلك العقدي منه ـ فقط سمح الإسلام للتنوع السياسي(الجماعاتي) إيمانا منه بأن كل تجمع حتما سيكون له منهجا وخطا ورؤية حياتية وتنظيمية وبالتالي مسلكا وهدفا تسعى لأثباته وتحقيقه.
ومن باب تبيان تطبيقات الإسلام بخصوص التعددية، فإن ما انتهجه خليفة رسول الله(ص)، الإمام علي(ع) في زمن حكومته، من إيمان بالتعددية السياسية، وقبوله للمعارضة السياسية كحق للتعبير عن الراي، خير مثال، حيث عقم التأريخ من أن يذكر لنا بأنه(ع) قهر أحدا على القبول به حاكما من خلال فرض البيعة مثلا، بل على العكس تماما، قبل(ع) فريقا من المسلمين على الرغم من عدم مبايعتهم له، ولم يعترض عليهم أو يذكرهم أو يضيق عليهم بموقف ما، بل ومنحهم كل حقوقهم دون نقصان، كموقفه(ع) مع جماعة الخوارج ـ على الرغم من علمه بنواياهم ـ إقرارا منه لمبدأ التنوع السياسي والتعددية السياسية والحق في إبداء الراي، في وقت كانوا يكيلون له شتى أنواع التهم والسباب، بل ويعملون ضده بروح الفريق السياسي الحزبي الهادف للإسقاط فحسب، في حين نجده عليه افضل الصلاة وأتم التسليم يمنحهم "حقوقهم" بتمامها وكمالها إن لم نقل أكثر منها ـ في وقت لم يذكر لنا التأريخ أن منح خصم لخصمه هكذا حقوق غير الإمام علي(ع) لخصومه الخوارج ـ وهي حق المعارضة السياسية، وحق النفقة من بيت المال، وحق التجمع؛ وهو ما بينه عليه افضل السلام في قوله لهم: "إن لكم علينا أن لا نبدأكم بقتال، وأن لا نقطع عنكم الفيء، وأن لا نمنعكم مساجد الله".
ونفس الأمر حصل بينه(ع) وبين الخط السياسي المناوئ له بُعيد تسنمه إدارة شؤون المسلمين وقبيل حرب الجمل، والمتمثل بطلحة والزبير، حيث قصدا العمرة تقنّعا، متوجهين صوب البصرة لتأسيس قوى معارضة مسلحة ضده(ع)، وعلى الرغم من علمه بذلك مسبقا، ومعرفته بقصودهما الغدرة وليس العمرة ـ حيث قال(ع): "إنّنی أذنت لهما مع علمی بما قد انطويا علیه من الغدر واستظهرت بالله علیهما، وإنّ الله تعالى سیردّ کیدهما ویظفرنی بهما"، ولكنه لم يمنعهما من ذلك ولم يُلجئهما للحبس أو الإقامة الجبرية!! إيمانا منه بأهمية ـ بل وبضرورة ـ التنوع والتعدد في وجهات النظر.
أما في زمن معارضة الإمام علي(ع) كمرحلة سابقة لتسلمه زمام الأمور، وعلى الرغم من كونه الخليفة الشرعي للنبي محمد(ص) وخير من يمثل منهجه الحق، ورغم إيمانه بحق المعارضة وبالتالي حق التعددية السياسية، إلا أنه لم يمارس دور المعارض كما هو متعارف عليه اليوم سياسيا، حقنا منه للدماء وحفاظا على بيضة الإسلام، لذلك نراه يؤكد على سلمية موقفه من الفرقة التي بخسته حقه الشرعي كتتمة للخط النبوي، فتراه يقول :"لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّي أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِي ـ يقصد حق إدارته لشؤون المسلمين من خلال حقه الإلهي في الإمامة كحلقة تُتمم المنهج النبوي ـ وَوَاللهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَكُنْ فِيها جَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّةً، الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذلِكَ وَفَضْلِهِ، وَزُهْداً فِيَما تَنافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَزِبْرِجِهِ"، ما يجعل المتتبع منا يكتشف بأن لمعارضته(ع)، منطلقات قرآنية ونبوية، قوامها ردم الفجوة بين النظرية الإسلامية وتطبيقاتها كما حدث ذلك خلال فترة حكم الخليفة السياسي الثالث عثمان بن عفان وانحيازه بعيدا عن النظرية الإسلامية القويمة في إدارة شؤون الأمة.
وعلى هذا، فإن المعارضة العلوية قد اتسمت بجملة سمات، أهمها:
- الهدفية الإيجابية، حيث أنها لا تهدف إلى تسنم السلطة، إنما لهدف إصلاحي بحت، لو تحقق لما كان للمعارضة من داعي للبقاء.
- السلمية، فلم يتوسل(ع) بغير لسانه وتذكيره بالسنة النبوية الشريفة في الحكم.
- العلنية، لأن الأصل في ذلك هو نصح السلطان وتصويب سلوكياته.
- التأني والصبر، حيث أنه لم يقبل بالانقلاب السريع، لئلا يكون له تأثير سلبي، فراح ينتهج الصبر على التغيير والتثوير، فتراه يقول: "وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجاً"، فكان بذلك صبورا لأن معايش المسلمين تحتم عليه ذلك، خصوصا وإن الإسلام ما زال خديجا طريا، والأعداء ما زالوا يتربصون به الدوائر.
لذا فإن معارضته(ع) هدفت إلى الإصلاح كهدف أسمى من التسلط، مع وضوحها وبعدها عن أساليب المخاتلة والتخفي مما يمارسه المعارضون عادة، كما اتسمت المعارضة العلوية بالمنهجية المبدئية كالتزام منه(ع) للخط القرآني المحمدي في نظم شؤون الأمة، فضلا عما اتسمت به هذه المعارضة الحكيمة من سلمية حفظا للدماء، ناهيك عن أخلاقية الفارس النبيل التي اتسمت بها هو سلام الله عليه بغية وصوله لهدفه النبيل بشكل راسخ وليس عشوائي، وبذلك استطاع(ع) أن يتحصل على رضا ربه ومن ثم من يقع تحت ولايته، بل وآسر حتى قلوب مخالفيه بما انتهجه من منهج، سواء أيام ما كان معارضا او عندما صار حاكما.
والخلاصة في ذلك، أن الأصل في قبول التعارض السياسي لأي حكومة ـ حسب الرؤية العلوية ـ هو بأن السلطة ليس امتيازا يسمح لأفرادها بظلم وبخس الناس حقوقهم، ولا أن المعارضة قوة ضغط يبطش بها المعارض بوسائل ضغطه غير المشروعة على الحكومة لتنزل عند رغباته التي قد تكون فئوية وليس كلية، إنما التعارض السياسي نوعا من أنواع التعددية في الراي، تحتاج لفهم كلي تُدارى من خلاله حقوق الناس ومن قبلهم رب الناس جل شأنه، وهذا ما لم يجعل من سلطته(ع) سلطة انقلابية إنما إصلاحية بحت، ونفس الأمر ينسحب على معارضته التي كانت هي الأخرى إصلاحية بل وسلمية أيضا ـ كما سبق وأن قرأنا نصه في ذلك ـ كونه في كلا الدورين كان مصلحا وهاديا، ليس إلا، أي إن سلطته(ع) كانت تصحيحية إصلاحية لا تحقيقا لمِلكية أو أمور دنيوية، كما يقول(ع): "اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنردّ المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك"، في وقت كانت معارضته(ع) مثل ذلك حسما يقول(ع): "وَوَاللهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ"، وهو ما يجعل من حياته(ع) محتذى لأي عامل في السياسة، نظرا لما احتوته من موارد فكرية خصبة يعجز معها حتى النظم السياسي المعاصر مهما تقدم وتحدث، خصوصا وأنه عاصر المتغيرات الفكرية والمجتمعية الكبرى، ما يجعل من منهجه السياسي مرحلة تأسيسية لما بعده، خصوصا للحركات الإسلامية بل والتغييرية أنى كانت في العالم، كونه(ع) مارس المعارضة بصف النبي الأكرم محمد(ص) ضد آلة الحكم القرشي المشرك- كما مارس دور السلطة الرشيدة أبان تسلمه الخلافة كحق إلهي ولو متأخرا ـ دون أن يظلم أو يبخس أحدا حقا، ما يجعل منه رائدا سياسيا منقطع النظير.
والتعددية سنة ربانية فيما خلق الله وأبدع، بدء من تعدد أنواع الجنس الواحد من المخلوقات وانتهاء بألوان وألسن البشر فضلا عن طبائعهم وعاداتهم وأنماط تفكيرهم، وهو ما يحتم علينا أن لا نبالغ في خطر التنوع السياسي ـ ولا نقصد هنا السياسة بمفهومها الحزبي القائم إنما بتعدد وجهات النظر حيال القرارات المجتمعية المهمة ـ كون هذا التنوع جزء من التنوع الخَلقي تبارك وتعالى مبدعه.
وانطلاقا من قوله جل وعلا(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(الحجرات ـ13)، نجد أن الإسلام يدعو بما لا شك فيه إلى الاهتمام بالوحدة الإنسانية من خلال الحفاظ على تنوعها وليس تذويب أنواعها في بوتقة واحدة، وعلى هذا يؤسس لمبادئ عامة في احترام التنوع مهما كان ـ اثنيا او دينيا او فكريا او عقائديا او قبائليا ـ باعتباره الحل الحقيقي في صناعة المجتمع المثال وبالتالي الفرد المثال، بعد أن يؤسس ـ الإسلام ـ للازمة وضابطة تدفع لمثالية الفرد ـ ومن خلاله المجتمع ـ بغض النظر عن انتماءه، إلا وهي ضابطة التقوى المشار إليها في ختام الآية الشريفة أعلاه، خصوصا وإنها في مورد خطاب الناس وليس المسلمين أو المؤمنين أو غير ذلك من التوصيفات.
بل واعتبر الإسلام من خلال القرآن الكريم هذا التنوع، آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى، ونعمة منه وفضل، وهو ما يحتاج لتأمل وتدبر وشكران على ما أنعم(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ)(الروم ـ22).
والأصل في ضرورة التنوع الإنساني هو اللا قهر واللا جبر السيسيولوجي، بما في ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى من عدمه، احتكاما لقاعدة التخيير التي سنها القرآن الكريم في انتهاج المنهج والوجهة التي يريدها المرء(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة ـ156).
ومن باب اللا إكراه في الانتماء ـ بما في ذلك العقدي منه ـ فقط سمح الإسلام للتنوع السياسي(الجماعاتي) إيمانا منه بأن كل تجمع حتما سيكون له منهجا وخطا ورؤية حياتية وتنظيمية وبالتالي مسلكا وهدفا تسعى لأثباته وتحقيقه.
ومن باب تبيان تطبيقات الإسلام بخصوص التعددية، فإن ما انتهجه خليفة رسول الله(ص)، الإمام علي(ع) في زمن حكومته، من إيمان بالتعددية السياسية، وقبوله للمعارضة السياسية كحق للتعبير عن الراي، خير مثال، حيث عقم التأريخ من أن يذكر لنا بأنه(ع) قهر أحدا على القبول به حاكما من خلال فرض البيعة مثلا، بل على العكس تماما، قبل(ع) فريقا من المسلمين على الرغم من عدم مبايعتهم له، ولم يعترض عليهم أو يذكرهم أو يضيق عليهم بموقف ما، بل ومنحهم كل حقوقهم دون نقصان، كموقفه(ع) مع جماعة الخوارج ـ على الرغم من علمه بنواياهم ـ إقرارا منه لمبدأ التنوع السياسي والتعددية السياسية والحق في إبداء الراي، في وقت كانوا يكيلون له شتى أنواع التهم والسباب، بل ويعملون ضده بروح الفريق السياسي الحزبي الهادف للإسقاط فحسب، في حين نجده عليه افضل الصلاة وأتم التسليم يمنحهم "حقوقهم" بتمامها وكمالها إن لم نقل أكثر منها ـ في وقت لم يذكر لنا التأريخ أن منح خصم لخصمه هكذا حقوق غير الإمام علي(ع) لخصومه الخوارج ـ وهي حق المعارضة السياسية، وحق النفقة من بيت المال، وحق التجمع؛ وهو ما بينه عليه افضل السلام في قوله لهم: "إن لكم علينا أن لا نبدأكم بقتال، وأن لا نقطع عنكم الفيء، وأن لا نمنعكم مساجد الله".
ونفس الأمر حصل بينه(ع) وبين الخط السياسي المناوئ له بُعيد تسنمه إدارة شؤون المسلمين وقبيل حرب الجمل، والمتمثل بطلحة والزبير، حيث قصدا العمرة تقنّعا، متوجهين صوب البصرة لتأسيس قوى معارضة مسلحة ضده(ع)، وعلى الرغم من علمه بذلك مسبقا، ومعرفته بقصودهما الغدرة وليس العمرة ـ حيث قال(ع): "إنّنی أذنت لهما مع علمی بما قد انطويا علیه من الغدر واستظهرت بالله علیهما، وإنّ الله تعالى سیردّ کیدهما ویظفرنی بهما"، ولكنه لم يمنعهما من ذلك ولم يُلجئهما للحبس أو الإقامة الجبرية!! إيمانا منه بأهمية ـ بل وبضرورة ـ التنوع والتعدد في وجهات النظر.
أما في زمن معارضة الإمام علي(ع) كمرحلة سابقة لتسلمه زمام الأمور، وعلى الرغم من كونه الخليفة الشرعي للنبي محمد(ص) وخير من يمثل منهجه الحق، ورغم إيمانه بحق المعارضة وبالتالي حق التعددية السياسية، إلا أنه لم يمارس دور المعارض كما هو متعارف عليه اليوم سياسيا، حقنا منه للدماء وحفاظا على بيضة الإسلام، لذلك نراه يؤكد على سلمية موقفه من الفرقة التي بخسته حقه الشرعي كتتمة للخط النبوي، فتراه يقول :"لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّي أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِي ـ يقصد حق إدارته لشؤون المسلمين من خلال حقه الإلهي في الإمامة كحلقة تُتمم المنهج النبوي ـ وَوَاللهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَكُنْ فِيها جَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّةً، الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذلِكَ وَفَضْلِهِ، وَزُهْداً فِيَما تَنافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَزِبْرِجِهِ"، ما يجعل المتتبع منا يكتشف بأن لمعارضته(ع)، منطلقات قرآنية ونبوية، قوامها ردم الفجوة بين النظرية الإسلامية وتطبيقاتها كما حدث ذلك خلال فترة حكم الخليفة السياسي الثالث عثمان بن عفان وانحيازه بعيدا عن النظرية الإسلامية القويمة في إدارة شؤون الأمة.
وعلى هذا، فإن المعارضة العلوية قد اتسمت بجملة سمات، أهمها:
- الهدفية الإيجابية، حيث أنها لا تهدف إلى تسنم السلطة، إنما لهدف إصلاحي بحت، لو تحقق لما كان للمعارضة من داعي للبقاء.
- السلمية، فلم يتوسل(ع) بغير لسانه وتذكيره بالسنة النبوية الشريفة في الحكم.
- العلنية، لأن الأصل في ذلك هو نصح السلطان وتصويب سلوكياته.
- التأني والصبر، حيث أنه لم يقبل بالانقلاب السريع، لئلا يكون له تأثير سلبي، فراح ينتهج الصبر على التغيير والتثوير، فتراه يقول: "وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجاً"، فكان بذلك صبورا لأن معايش المسلمين تحتم عليه ذلك، خصوصا وإن الإسلام ما زال خديجا طريا، والأعداء ما زالوا يتربصون به الدوائر.
لذا فإن معارضته(ع) هدفت إلى الإصلاح كهدف أسمى من التسلط، مع وضوحها وبعدها عن أساليب المخاتلة والتخفي مما يمارسه المعارضون عادة، كما اتسمت المعارضة العلوية بالمنهجية المبدئية كالتزام منه(ع) للخط القرآني المحمدي في نظم شؤون الأمة، فضلا عما اتسمت به هذه المعارضة الحكيمة من سلمية حفظا للدماء، ناهيك عن أخلاقية الفارس النبيل التي اتسمت بها هو سلام الله عليه بغية وصوله لهدفه النبيل بشكل راسخ وليس عشوائي، وبذلك استطاع(ع) أن يتحصل على رضا ربه ومن ثم من يقع تحت ولايته، بل وآسر حتى قلوب مخالفيه بما انتهجه من منهج، سواء أيام ما كان معارضا او عندما صار حاكما.
والخلاصة في ذلك، أن الأصل في قبول التعارض السياسي لأي حكومة ـ حسب الرؤية العلوية ـ هو بأن السلطة ليس امتيازا يسمح لأفرادها بظلم وبخس الناس حقوقهم، ولا أن المعارضة قوة ضغط يبطش بها المعارض بوسائل ضغطه غير المشروعة على الحكومة لتنزل عند رغباته التي قد تكون فئوية وليس كلية، إنما التعارض السياسي نوعا من أنواع التعددية في الراي، تحتاج لفهم كلي تُدارى من خلاله حقوق الناس ومن قبلهم رب الناس جل شأنه، وهذا ما لم يجعل من سلطته(ع) سلطة انقلابية إنما إصلاحية بحت، ونفس الأمر ينسحب على معارضته التي كانت هي الأخرى إصلاحية بل وسلمية أيضا ـ كما سبق وأن قرأنا نصه في ذلك ـ كونه في كلا الدورين كان مصلحا وهاديا، ليس إلا، أي إن سلطته(ع) كانت تصحيحية إصلاحية لا تحقيقا لمِلكية أو أمور دنيوية، كما يقول(ع): "اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنردّ المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك"، في وقت كانت معارضته(ع) مثل ذلك حسما يقول(ع): "وَوَاللهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ"، وهو ما يجعل من حياته(ع) محتذى لأي عامل في السياسة، نظرا لما احتوته من موارد فكرية خصبة يعجز معها حتى النظم السياسي المعاصر مهما تقدم وتحدث، خصوصا وأنه عاصر المتغيرات الفكرية والمجتمعية الكبرى، ما يجعل من منهجه السياسي مرحلة تأسيسية لما بعده، خصوصا للحركات الإسلامية بل والتغييرية أنى كانت في العالم، كونه(ع) مارس المعارضة بصف النبي الأكرم محمد(ص) ضد آلة الحكم القرشي المشرك- كما مارس دور السلطة الرشيدة أبان تسلمه الخلافة كحق إلهي ولو متأخرا ـ دون أن يظلم أو يبخس أحدا حقا، ما يجعل منه رائدا سياسيا منقطع النظير.
المصدر: الإسلام لماذا؟